الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع مفهوم الصياغة وأهميتها
صفحة 1 من اصل 1
 الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع مفهوم الصياغة وأهميتها
الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع مفهوم الصياغة وأهميتها
مدخل:
إن الدعوة إلى صياغة علم الاجتماع صياغة إسلامية، تعني أن هناك خللاً يجب أن يسد، ومشكلة تبحث عن حل، وللوهلة الأولى يظن أن لهذه المشكلة علاقة بالأزمة التي يمر بها علم الاجتماع، والتي ظهرت في علم الاجتماع الغربي، والأمريكي بالذات، وتردد صداها في العام الإسلامي والثالث على وجه العموم. وهي عجز علم الاجتماع عن تفسير الظواهر الاجتماعية، وكذلك انغماسه في خدمة الأيديولوجيات المختلفة، سواء كانت رأسمالية أم اشتراكية.
ومع أن هذا يعد طرفاً من الحقيقة، حيث فتحت هذه الأزمة أنظار بعض علماء الاجتماع على علم الاجتماع الإسلامي، فوجدوا فيه بديلاً للاتجاهات الغربية (35) إلا أن الطرف الأكبر من الحقيقة، لم يكن كذلك، وإنما كان مرتبطاً بعملية البحث عن الذات، التي كادت تضيع في خضم عمليات التغريب والاستلاب الثقافي، وهذه العملية لا تختص بعلم الاجتماع فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة الميادين، وعلى رأسها العلوم الاجتماعية، ومنها علم الاجتماع، وتهدف إلى إبراز لهوية الإسلامية، وتحكيم الشرع في كافة مجالات الحياة. وقد كانت عملية البحث عن الذات نابعة من المجتمعات الإسلامية، ووجدت حين شعر أبناء المسلمين المخلصون بقيمة ما يحملون من قيم ومبادئ، وعندما أدركوا خطورة الاتجاه الذي تسير فيه مجتمعاتهم حيث ضربت التبعية أطنابها على كل شيء.
ولنا أن نتساءل بعد ذلك، ما هي المشكلة التي أرقت علماء الاجتماع المسلمين؟
إن المشكلة التي يعاني منها علم الاجتماع، لم تصبه وحده فقط، ولكنها تتعداه لتصيب جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتصيب بمقدار قليل العلوم الطبيعية، وهي مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالنشأة الحديثة لهذه العلوم، وبالتكوين العلمي والفكري لرواد هذه العلوم فجميع العلوم سواء الاجتماعية أو الإنسانية، عبارة عن مجموعة من المعلومات المنظمة والمنسقة وفقاً للأفكار والمعتقدات والمظهر والظروف الاجتماعية، والخبرات الفردية والجماعية لمواضيعها وخبراتها (36). فقد نظم الغربيون ونسقوا علومهم تحت ضغط احتياجاتهم الفكرية والعلمية والأيديولوجية، لذلك جاءت هذه العلوم محملة بتصورات الغربيين ومبادئهم.
ولعل المشكلة الكبرى التي يحس بها عالم الاجتماع المسلم، لا تختص بتشبع هذه العلوم بالتصورات الغربية، دون غيرها من تصورات بني البشر، ولكنها تتعدى ذلك إلى فساد هذه التصورات، فالمشكلة هي التصورات الغربية الفاسدة التي تشكل أطراً عامة لهذه العلوم.
ولنا أن نتساءل بعد ذلك: ما هي هذه التصورات الغربية الفاسدة؟ يقول الشيخ محمد قطب: "لقد أصبح الطابع المميز للفكر الأوربي منذ النهضة هو التمرد على الدين، والتمرد على الله، وكان ذلك نابعاً من تأثيرين في أن واحد، التأثير الأول: هو روح رد الفعل الذي قام ضد الدين والكنيسة، والثاني: هو تأثير الجاهلية الإغريقية في هذا الشأن بالذات " (37)، ويقصد بالتأثير الثاني: الأثر الذي خلفته الأساطير الوثنية الإغريقية التي تصور العلاقة بين الآلهة علاقة صراع وخصام لا يفتر، كأسطورة برومثيوس الشهيرة.
كانت النتيجة لهذين التأثيرين، هي قيام الفلسفة الغربية التي تحكم نظرة الإنسان الغربي للكون والحياة والناس. على أسس دنيوية أ "لا دينية" أو بالتسمية الخاطئة: علمانية. بل إن "ديورانت " يقول: "إن المفكر الغربي لم يكن في يوم من الأيام مفكراً دينياً، أي مفكراً متديناً". إن الفكر الغربي كان في كل مراحله فكراً ملحداً، ولم تكن الحياة الدينية بالنسبة إليه شيئاً، أو من مقومات شخصيته الأساسية " (38).
وتمتد الدنيوية في نسبها إلى أصول إفريقية قديمة، فقد أعلن الفلاسفة الإغريق أن البشر باستطاعتهم أن يبلغوا الكمال، دون أي مساعدة من قوى ما وراء الطبيعة. وذلك باستخدام ملكاتهم العقلية المجردة. وقد نمت الدنيوية، وكبرت أمام عين الكنيسة، بل إنها أطاحت بها عندما بلغ فسادها الذروة. ونتيجة للمعاناة من جبروت وقسوة الكنيسة، فقد تطرفت الدنيوية إلى الطرف المقابل، وآمنت بمبدأ جديد، يخالف ما تقول به الأديان جميعاً، "يستند إلى حواس الإنسان: السمع، والبصر، والشم، واللمس، أي الإدراك عن طريق عضو حسي. وفيما وراء هذه الحقيقة الحسية، إما أنه لا يوجد شيء، أو إذا كان هناك شيء لا نستطيع أن نحسه فإنه يعادل شيئاً غير حقيقي، وغير موجود، ومن ثم يمكن تجاهله، وإغفاله إغفالاً تاما ً" (39).
إن الدنيوية أو العلمانية هي القاعدة التي ترتكز عليها الفلسفات والعقائد الغربية، ومنها ومعها وُجدت قواعد أخرى لها أهمية كبرى، مثل الديمقراطية، وهي المبدأ الذي أقصى الرب والإله والخالق، عن ساحة السلطان والفنون، وسلمها إلى أيدي الشعوب باعتبار أن الجماهير هي المصدر الحقيقي للسلطة السياسية.
ومن القواعد أيضاً: القومية، والمادية، اللتان كانتا وراء الاستعلاء على الأمم الأخرى، والنهب الاستعماري لها.
لقد كانت الحصيلة للقواعد السابقة، أن استقر في الذهنية الأوربية تصور للوجود يقوم على البعد عن الله، وعلى كراهية الأديان جميعاً باعتبارها من صنع الكنيسة، على الإيمان بالمحسوس، وإنكار أفكار الغيب.
ويمكن تلخيص هذا التصور، الذي يشكل خلفيات عقائدية، تحدث أثرها في سير الحضارة والمعرفة، فيما يلي: "الوجود كله منحصر في الإنسان والطبيعة، وهو جزء منها، ونوع من أنواعها. والطبيعة وجدت هكذا بنفسها، وكذلك سننها أو قوانينها، فهي مقدرة بنفسها من غير مقدر لها. والعقل وحده طريق معرفة الحقائق، وليس ثمة طريق آخر، وليست المثل الأخلاقية، والقيم والمفاهيم الحقوقية، إلا وقائع أو حوادث، كالحوادث الطبيعية، نشأت وتطورت، فهي ليست ثابتة. والإنسان نفسه إنما هو حيوان اجتماعي مفكر فحسب. وليست النفس الإنسانية إلا مجموعة من الغرائز "(40).
وعلى هذا، فليس في هذا التصور مكان للإله، وصلته بالكون، والوحي والنبوات، ولا للجزاء والحياة والآخرة، ولا المثل العليا الأخلاقية، ولا لسائر الغيبيات.
لقد كانت هذه التصورات هي الإطار الفلسفي، الذي وجه العلوم الحديثة في أوربا، وهو كما نرى إطار لا ديني، يفسر الظواهر الكونية والإنسانية، بأسباب من داخل الكون، لا أثر للإرادة الإلهية فيها، وعلى هذا فقدرة الله وصلته بالكون مستبعدة من البداية. فتفسير دور كاليم مثلاً للظاهرة الدينية، بإرجاعها إلى فكرة التضامن الاجتماعي، لا يخرج عن هذا الإطار، فهو قائم على حجة فحوارها أن "الأشياء التي يذكرها المنتمون إلى دين ما، يجب أن لا تؤخذ على أنها إخبار عن الله، لأنه -من حيث المبدأ- لا يمكن أن يكون هناك إخبار كهذا " (41).
ويتجاوز هذا الإطار، اللادينية بالمعنى السلبي، إلى عداء الدين حيث، يتعرض لانتقاده والهجوم باسم العلم، وكما هو الحال في الفلسفة الماركسية والوضعية، حيث يعتبر الدين مرحلة ولّت وانتهت، وحل محلها العلم.
وعلى كل حال، فإن العلوم الاجتماعية بنشأتها الغربية الحديثة، تدور في فلك هذا الإطار، بل إنه يتجلى فيها بوضوح أكثر من غيرها.
لقد كانت هذه هي المشكلة الكبرى، التي يفزع منها علماء الاجتماع المسلمون حينما يرونها مبثوثة في مبادئ علم الاجتماع ونظرياته. وهي مشكلة نشأت - كما سبق - نتيجة لنشأة علم الاجتماع الحديث الأوربية. فالأوربيون هم واضعوا علم الاجتماع الحديث. وهم الذين طوروه، ووضعوا مناهجه ونظرياته، لمعالجة أوضاعهم الاجتماعية، وقد كان الأمر في غاية البساطة لو بقي هذا العلم حيث نشأ، ولكن الأمر انتقل إلى مرحلة خطرة، حينما أخذ هذا العلم صفة العالمية، ونُقل بحذافيره إلى بلاد العالم الإسلامي، في فترة الانبهار بالغرب، وما ينتجه.
ولعل الاعتراض الثاني على علم الاجتماع من قبل عالم الاجتماع المسلم، هي هذه الصفة العالمية، التي منحت لنظريات علم الاجتماع الحديث، تحت دعوى الموضوعية والمهج العلمي المحايد، الذي تصدق نظرياته في أي زمان، وفي أي مكان، لاعتماده على الوقائع المشاهدة التي لا تنكر.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالان حول هذه القضية، وهما:
1- هل نظريات علم الاجتماع تعبر عن الحقيقة كاملة حتى تأخذ صفة العالمية؟
2- ما نوع القضايا والمشكلات التي أثارها علم الاجتماع، وهل هي قضايا عالمية؟
وبالنسبة للإجابة عن السؤال الأول: فإن الإيجاز السابق للإطار الفلسفي الذي يحيط بالعلوم الاجتماعية عموماً، يجيب عن هذا السؤال، ويدلنا على أن مادة البحث في هذه العلوم ناقصة، فقد اقتصرت على عالم الشهادة، دون اعتبار لعالم الغيب، واقتصرت على المحسوسات دون المعنويات. ولا شك أن تأثير علام الغيب في الحياة الواقعية كبير جداً، إضافة إلى أنه حق لا ريب فيه، لا يجوز عقلاً إنكاره، أو تجاهله بهذه الطريقة.
وبالنسبة للإجابة على السؤال الثاني، فإن استعراضاً سريعاً لمسيرة هذه العلوم سوف يوضح أنها كانت تهدف إلى الإجابة عن أسئلة أوروبية بحتة، لم تكن تثار في أنحاء العالم الآخر.
فلقد "تمثلت حصيلة التطورات المادية والفكرية والسياسية في أوربا، في القرن التاسع عشر، في انهيار تام لأركان المجتمع التقليدي، بكل نظمه وأفكاره ومقدساته، ونمو متزايد للفردية، وانهيار للانتماءات الاجتماعية، وإيمان بأسبقية الفرد على المجتمع، والقيم والقوانين، واهتزاز لنظم كانت شبه مقدسة كالأسرة، والطبقة، والطائفة، والملكية، والدين، وغير ذلك. إضافة إلى الاضطرابات الأخرى، التي شملت المجتمع الجديد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من طبيعته، ومن أهمها الصراعات الطبقية، التي ولدتها ظروف العمل الصناعي، ونظام المصنع والأشكال المختلفة للاستقلال "(42).
وكان السؤال الذي يطرح نفسه على الجميع: ما هو مستقبل مثل هذا النظام؟
وتولدت عن هذا السؤال أسئلة فرعية كثيرة، ولقد كانت أفكار عصر التنوير مرشدة في تحديد الأسئلة، والإجابات.
وقد اتخذت الإجابة عن هذا السؤال شكل نظريات كبرى، بدءاً من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وقد اتجهت إلى اتجاهين:
1- اتجاه التغيير الثوري الراديكالي، الذي يقوم على الصراع بين العمل ورأس المال. فالنظام البورجوازي يجب أن ينسف، ولا مجالا لإصلاحه. ويجب أن يوجد نظام جديد يقضي على التمايزات الطبقية. والفكرة الماركسية هي النموذج الأمثل لهذا الاتجاه.
2- اتجاه دعم التوازن، وحفظ النظام، وإصلاح المجتمع الذي هزته الفلسفات النقدية، والحركات الثورية، من أجل استكمال المؤسسات اللازمة لاستقرار العلاقات بين العمل ورأس المال، وليس من أهداف هذا الاتجاه إنهاء التمايز الطبقي، بل من أهدافه: التخفيف من حدة الصراع، بالتعليم والتوجيه والإرشاد. وقد مثلت الوضعية وعلى رأسها كونت، هذا الاتجاه. وتشكل الوظيفية طبعة جديدة من طبعات هذا الاتجاه.
ولا يزال الاهتمام بالنظام الأمثل، هو محور النظريات الجديدة، فمحاولات التأليف بين الماركسية والوظيفية، والاهتمام بالتوازن والصراع في آن واحد، لا يخرج عن هذا النطاق(43). وكل هذه النظريات تتفرع عن الاتجاه الأكبر الذي هو الدنيوية، فأكثر ما تبشر به هذه النظريات هو مزيد من ضبط الأداء، ومزيد من نمو القوى الإنتاجية، ومزيد من التعديل في علاقات الإنتاج "النظام الاقتصادي "، ومزيد من الرخاء، وسلع الاستهلاك، لكافة أبناء هذه المجتمعات (44).
وعلى هذا فإن العلوم الاجتماعية، ومنها علم الاجتماع، وجدت في الغرب لتعالج مثل هذه المشاكل، وهذه المشاكل لم تمر على المجتمعات الأخرى، بل إن الواقع الاجتماعي للعالم الإسلامي، يطرح أسئلة ومشكلات مختلفة تماماً، تتطلب إجابات غير تلك الإجابات، كما أن الاختلاف بين العالم الغربي، والعالم الإسلامي، يبدأ من المحور والمركز، حيث تركز العلوم الغربية على الدنيوية، بينما يعتبر الإسلام هو محور العلوم في العالم الإسلامي.
أو على الأقل ينبغي أن يكون كذلك.
وهكذا نجد أن دعوى العالمية المبنية على الموضوعية، والمنهج العلمي المحايد، دعوى زائفة، ولا غرابة بعد ذلك في أن نجد عالم الاجتماع الغربي يتحدث عن الأديان، بينما يقصد المسيحية فقط، أو يتحدث عن القوانين الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإنسانية كافة، بينما هو يقصد ممارسات عامة في المجتمعات الغربية وحدها (45) ويمكن اختصار الدواعي الأساسية لصياغة العلوم الاجتماعية عموماً ومنها علم الاجتماع، صياغة إسلامية، فيما يلي:
1- التصورات الغربية الفاسدة الموجهة لهذه العلوم.
2- إن هذه العلوم صبت اهتمامها على الجزء المنظور منالواقع، ولم تعترف بالجزء الغيبي منه، لذلك فه لا تعبر عن الحقيقة كاملة.
3- إن النظريات والقضايا والحلول التي وجهت هذه العلوم، هي قضايا تخص جزء من العالم يسمى الغرب، ومن الخطأ تعميمها على بقية أنحاء العالم.
وسيتكشف لنا خلال هذا البحث، مزيداً من دواعي الصياغة الإسلامية، التي هي ألصق بعلم الاجتماع منها بغيره من العلوم.
ولمواجهة هذا الخلل الكبير في هذه العلوم، نادى المخلصون من أبناء العالم الإسلامي بصياغة العلوم الاجتماعية خاصة، صياغة إسلامية تتناسب مع التصورات الإسلامية، التي تعبر عن الحقيقة كاملة، وتعالج قضايا العالم بأجمعه، وليست قضايا العالم الإسلامي فحسب.
ونظراً لأن هذه القضية لا تزال حصيلة جهود فردية، فقد تعددت المسميات لهذه الدعوة، علماً بأنها تهدف إلى شيء واحد، هو إقامة هذه العلوم على أساس التصور الإسلامي السليم، للحياة والكون والإنسان، فقد وردت المسميات التالية: أسلمة العلوم، أو أسلمة المعرفة (46) والتوجيه الإسلامي للعلوم (47)، وصياغة العلوم صياغة إسلامية(48)، والتأصيل الإسلامي للعلوم(49)، وكلها تهدف إلى شيء واحد يلخصه د. إسماعيل فاروقي فيما يلي: "إن إعادة صياغة العلوم في ضوء الإسلام، هو ما نعنيه بكلمة أسلمة العلوم، ونعني بها إعادة صياغة المعلومات وتنسيقها، وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منها، وتقويم الاستنتاجات التي انتهت إليها، وإعادة تحديد الأهداف على أن يكون كل ذلك بطريقة تجعل فروع المعرفة المختلفة تثري التصور الإسلامي، وتخدم أهداف الإسلام "(50).
ويواصل حديثه فيقول: "وللوصول إلى ذلك الهدف، لا بد لقضايا الإسلام الأساسية، وأعني بها وحدة الحقيقة، ووحدة المعرفة، ووحدة البشرية، ووحدة الحياة والإيمان، بوجود هدف من وراء خلق الكون والإنسان، وتسخير الكون للإنسان، وعبودية الإنسان لله، لا بد لهذه القضايا كلها أن تحل محل التصورات الغربية "(51).
والحقيقة أن هذا الذي يذكره الفاروقي هو واجب كل مسلم مخلص في الإسلام.
والصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع، تعني على ضوء هذا المفهوم استقلال علم الاجتماع الإسلامي، استقلالاً يجعله في مواجهة علم الاجتماع الماركسي. وعلم الاجتماع الغربي الليبرالي. وذلك بسبب استقلالية التصور الإسلامي وشموليته. وتفرده عن التصورين السابقين.
ويترتب على هذا، الحكم بخطأ المحاولات، التي تجعل علم الاجتماع الإسلامي، فرعاً من فروع علم الاجتماع العام، أو فرعاً من فروع علم الاجتماع الديني.
وكذلك المحاولات الأخرى التي تجعله علماً للمجتمعات الإسلامية فقط، ولا شك أن هذا يتصادم مع السبب الذي يدعو إلى الصياغة الإسلامية، وهو إبراز التصور الإسلامي، الذي تعد العالمية إحدى خصائصه.
ويتبع ما سبق، أن يكون ميدان علم الاجتماع "هو واقع المجتمعات البشرية، في حدود كونها عالماً مشهوداً، يمكن ملاحظته واستخراج خصائصه، وقوانين حركته وتبدله "(52).
ويعني هذا الاكتفاء برأي الإسلام، في أمور يبحثها علم الاجتماع العام، ويتخبط فيها، نظراً لاعتماده على مفاهيم عقائدية أخرى، وذلك مثل: "أصل الأديان ونشأتها، وتعاقب النبوات، وتتابع تشريعاتها، وأحكامها "(53).
ويتبع هذا دراسة القضايا الاجتماعية، التي فصل أحكامها الإسلام كالأسرة، وقضايا المرأة، دون إغفال لأوامر الشرع الإسلامي في ذلك.
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إن الدعوة إلى صياغة علم الاجتماع صياغة إسلامية، تعني أن هناك خللاً يجب أن يسد، ومشكلة تبحث عن حل، وللوهلة الأولى يظن أن لهذه المشكلة علاقة بالأزمة التي يمر بها علم الاجتماع، والتي ظهرت في علم الاجتماع الغربي، والأمريكي بالذات، وتردد صداها في العام الإسلامي والثالث على وجه العموم. وهي عجز علم الاجتماع عن تفسير الظواهر الاجتماعية، وكذلك انغماسه في خدمة الأيديولوجيات المختلفة، سواء كانت رأسمالية أم اشتراكية.
ومع أن هذا يعد طرفاً من الحقيقة، حيث فتحت هذه الأزمة أنظار بعض علماء الاجتماع على علم الاجتماع الإسلامي، فوجدوا فيه بديلاً للاتجاهات الغربية (35) إلا أن الطرف الأكبر من الحقيقة، لم يكن كذلك، وإنما كان مرتبطاً بعملية البحث عن الذات، التي كادت تضيع في خضم عمليات التغريب والاستلاب الثقافي، وهذه العملية لا تختص بعلم الاجتماع فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة الميادين، وعلى رأسها العلوم الاجتماعية، ومنها علم الاجتماع، وتهدف إلى إبراز لهوية الإسلامية، وتحكيم الشرع في كافة مجالات الحياة. وقد كانت عملية البحث عن الذات نابعة من المجتمعات الإسلامية، ووجدت حين شعر أبناء المسلمين المخلصون بقيمة ما يحملون من قيم ومبادئ، وعندما أدركوا خطورة الاتجاه الذي تسير فيه مجتمعاتهم حيث ضربت التبعية أطنابها على كل شيء.
ولنا أن نتساءل بعد ذلك، ما هي المشكلة التي أرقت علماء الاجتماع المسلمين؟
إن المشكلة التي يعاني منها علم الاجتماع، لم تصبه وحده فقط، ولكنها تتعداه لتصيب جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتصيب بمقدار قليل العلوم الطبيعية، وهي مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالنشأة الحديثة لهذه العلوم، وبالتكوين العلمي والفكري لرواد هذه العلوم فجميع العلوم سواء الاجتماعية أو الإنسانية، عبارة عن مجموعة من المعلومات المنظمة والمنسقة وفقاً للأفكار والمعتقدات والمظهر والظروف الاجتماعية، والخبرات الفردية والجماعية لمواضيعها وخبراتها (36). فقد نظم الغربيون ونسقوا علومهم تحت ضغط احتياجاتهم الفكرية والعلمية والأيديولوجية، لذلك جاءت هذه العلوم محملة بتصورات الغربيين ومبادئهم.
ولعل المشكلة الكبرى التي يحس بها عالم الاجتماع المسلم، لا تختص بتشبع هذه العلوم بالتصورات الغربية، دون غيرها من تصورات بني البشر، ولكنها تتعدى ذلك إلى فساد هذه التصورات، فالمشكلة هي التصورات الغربية الفاسدة التي تشكل أطراً عامة لهذه العلوم.
ولنا أن نتساءل بعد ذلك: ما هي هذه التصورات الغربية الفاسدة؟ يقول الشيخ محمد قطب: "لقد أصبح الطابع المميز للفكر الأوربي منذ النهضة هو التمرد على الدين، والتمرد على الله، وكان ذلك نابعاً من تأثيرين في أن واحد، التأثير الأول: هو روح رد الفعل الذي قام ضد الدين والكنيسة، والثاني: هو تأثير الجاهلية الإغريقية في هذا الشأن بالذات " (37)، ويقصد بالتأثير الثاني: الأثر الذي خلفته الأساطير الوثنية الإغريقية التي تصور العلاقة بين الآلهة علاقة صراع وخصام لا يفتر، كأسطورة برومثيوس الشهيرة.
كانت النتيجة لهذين التأثيرين، هي قيام الفلسفة الغربية التي تحكم نظرة الإنسان الغربي للكون والحياة والناس. على أسس دنيوية أ "لا دينية" أو بالتسمية الخاطئة: علمانية. بل إن "ديورانت " يقول: "إن المفكر الغربي لم يكن في يوم من الأيام مفكراً دينياً، أي مفكراً متديناً". إن الفكر الغربي كان في كل مراحله فكراً ملحداً، ولم تكن الحياة الدينية بالنسبة إليه شيئاً، أو من مقومات شخصيته الأساسية " (38).
وتمتد الدنيوية في نسبها إلى أصول إفريقية قديمة، فقد أعلن الفلاسفة الإغريق أن البشر باستطاعتهم أن يبلغوا الكمال، دون أي مساعدة من قوى ما وراء الطبيعة. وذلك باستخدام ملكاتهم العقلية المجردة. وقد نمت الدنيوية، وكبرت أمام عين الكنيسة، بل إنها أطاحت بها عندما بلغ فسادها الذروة. ونتيجة للمعاناة من جبروت وقسوة الكنيسة، فقد تطرفت الدنيوية إلى الطرف المقابل، وآمنت بمبدأ جديد، يخالف ما تقول به الأديان جميعاً، "يستند إلى حواس الإنسان: السمع، والبصر، والشم، واللمس، أي الإدراك عن طريق عضو حسي. وفيما وراء هذه الحقيقة الحسية، إما أنه لا يوجد شيء، أو إذا كان هناك شيء لا نستطيع أن نحسه فإنه يعادل شيئاً غير حقيقي، وغير موجود، ومن ثم يمكن تجاهله، وإغفاله إغفالاً تاما ً" (39).
إن الدنيوية أو العلمانية هي القاعدة التي ترتكز عليها الفلسفات والعقائد الغربية، ومنها ومعها وُجدت قواعد أخرى لها أهمية كبرى، مثل الديمقراطية، وهي المبدأ الذي أقصى الرب والإله والخالق، عن ساحة السلطان والفنون، وسلمها إلى أيدي الشعوب باعتبار أن الجماهير هي المصدر الحقيقي للسلطة السياسية.
ومن القواعد أيضاً: القومية، والمادية، اللتان كانتا وراء الاستعلاء على الأمم الأخرى، والنهب الاستعماري لها.
لقد كانت الحصيلة للقواعد السابقة، أن استقر في الذهنية الأوربية تصور للوجود يقوم على البعد عن الله، وعلى كراهية الأديان جميعاً باعتبارها من صنع الكنيسة، على الإيمان بالمحسوس، وإنكار أفكار الغيب.
ويمكن تلخيص هذا التصور، الذي يشكل خلفيات عقائدية، تحدث أثرها في سير الحضارة والمعرفة، فيما يلي: "الوجود كله منحصر في الإنسان والطبيعة، وهو جزء منها، ونوع من أنواعها. والطبيعة وجدت هكذا بنفسها، وكذلك سننها أو قوانينها، فهي مقدرة بنفسها من غير مقدر لها. والعقل وحده طريق معرفة الحقائق، وليس ثمة طريق آخر، وليست المثل الأخلاقية، والقيم والمفاهيم الحقوقية، إلا وقائع أو حوادث، كالحوادث الطبيعية، نشأت وتطورت، فهي ليست ثابتة. والإنسان نفسه إنما هو حيوان اجتماعي مفكر فحسب. وليست النفس الإنسانية إلا مجموعة من الغرائز "(40).
وعلى هذا، فليس في هذا التصور مكان للإله، وصلته بالكون، والوحي والنبوات، ولا للجزاء والحياة والآخرة، ولا المثل العليا الأخلاقية، ولا لسائر الغيبيات.
لقد كانت هذه التصورات هي الإطار الفلسفي، الذي وجه العلوم الحديثة في أوربا، وهو كما نرى إطار لا ديني، يفسر الظواهر الكونية والإنسانية، بأسباب من داخل الكون، لا أثر للإرادة الإلهية فيها، وعلى هذا فقدرة الله وصلته بالكون مستبعدة من البداية. فتفسير دور كاليم مثلاً للظاهرة الدينية، بإرجاعها إلى فكرة التضامن الاجتماعي، لا يخرج عن هذا الإطار، فهو قائم على حجة فحوارها أن "الأشياء التي يذكرها المنتمون إلى دين ما، يجب أن لا تؤخذ على أنها إخبار عن الله، لأنه -من حيث المبدأ- لا يمكن أن يكون هناك إخبار كهذا " (41).
ويتجاوز هذا الإطار، اللادينية بالمعنى السلبي، إلى عداء الدين حيث، يتعرض لانتقاده والهجوم باسم العلم، وكما هو الحال في الفلسفة الماركسية والوضعية، حيث يعتبر الدين مرحلة ولّت وانتهت، وحل محلها العلم.
وعلى كل حال، فإن العلوم الاجتماعية بنشأتها الغربية الحديثة، تدور في فلك هذا الإطار، بل إنه يتجلى فيها بوضوح أكثر من غيرها.
لقد كانت هذه هي المشكلة الكبرى، التي يفزع منها علماء الاجتماع المسلمون حينما يرونها مبثوثة في مبادئ علم الاجتماع ونظرياته. وهي مشكلة نشأت - كما سبق - نتيجة لنشأة علم الاجتماع الحديث الأوربية. فالأوربيون هم واضعوا علم الاجتماع الحديث. وهم الذين طوروه، ووضعوا مناهجه ونظرياته، لمعالجة أوضاعهم الاجتماعية، وقد كان الأمر في غاية البساطة لو بقي هذا العلم حيث نشأ، ولكن الأمر انتقل إلى مرحلة خطرة، حينما أخذ هذا العلم صفة العالمية، ونُقل بحذافيره إلى بلاد العالم الإسلامي، في فترة الانبهار بالغرب، وما ينتجه.
ولعل الاعتراض الثاني على علم الاجتماع من قبل عالم الاجتماع المسلم، هي هذه الصفة العالمية، التي منحت لنظريات علم الاجتماع الحديث، تحت دعوى الموضوعية والمهج العلمي المحايد، الذي تصدق نظرياته في أي زمان، وفي أي مكان، لاعتماده على الوقائع المشاهدة التي لا تنكر.
وهنا يتبادر إلى الذهن سؤالان حول هذه القضية، وهما:
1- هل نظريات علم الاجتماع تعبر عن الحقيقة كاملة حتى تأخذ صفة العالمية؟
2- ما نوع القضايا والمشكلات التي أثارها علم الاجتماع، وهل هي قضايا عالمية؟
وبالنسبة للإجابة عن السؤال الأول: فإن الإيجاز السابق للإطار الفلسفي الذي يحيط بالعلوم الاجتماعية عموماً، يجيب عن هذا السؤال، ويدلنا على أن مادة البحث في هذه العلوم ناقصة، فقد اقتصرت على عالم الشهادة، دون اعتبار لعالم الغيب، واقتصرت على المحسوسات دون المعنويات. ولا شك أن تأثير علام الغيب في الحياة الواقعية كبير جداً، إضافة إلى أنه حق لا ريب فيه، لا يجوز عقلاً إنكاره، أو تجاهله بهذه الطريقة.
وبالنسبة للإجابة على السؤال الثاني، فإن استعراضاً سريعاً لمسيرة هذه العلوم سوف يوضح أنها كانت تهدف إلى الإجابة عن أسئلة أوروبية بحتة، لم تكن تثار في أنحاء العالم الآخر.
فلقد "تمثلت حصيلة التطورات المادية والفكرية والسياسية في أوربا، في القرن التاسع عشر، في انهيار تام لأركان المجتمع التقليدي، بكل نظمه وأفكاره ومقدساته، ونمو متزايد للفردية، وانهيار للانتماءات الاجتماعية، وإيمان بأسبقية الفرد على المجتمع، والقيم والقوانين، واهتزاز لنظم كانت شبه مقدسة كالأسرة، والطبقة، والطائفة، والملكية، والدين، وغير ذلك. إضافة إلى الاضطرابات الأخرى، التي شملت المجتمع الجديد بوصفها جزءاً لا يتجزأ من طبيعته، ومن أهمها الصراعات الطبقية، التي ولدتها ظروف العمل الصناعي، ونظام المصنع والأشكال المختلفة للاستقلال "(42).
وكان السؤال الذي يطرح نفسه على الجميع: ما هو مستقبل مثل هذا النظام؟
وتولدت عن هذا السؤال أسئلة فرعية كثيرة، ولقد كانت أفكار عصر التنوير مرشدة في تحديد الأسئلة، والإجابات.
وقد اتخذت الإجابة عن هذا السؤال شكل نظريات كبرى، بدءاً من النصف الثاني للقرن التاسع عشر، وقد اتجهت إلى اتجاهين:
1- اتجاه التغيير الثوري الراديكالي، الذي يقوم على الصراع بين العمل ورأس المال. فالنظام البورجوازي يجب أن ينسف، ولا مجالا لإصلاحه. ويجب أن يوجد نظام جديد يقضي على التمايزات الطبقية. والفكرة الماركسية هي النموذج الأمثل لهذا الاتجاه.
2- اتجاه دعم التوازن، وحفظ النظام، وإصلاح المجتمع الذي هزته الفلسفات النقدية، والحركات الثورية، من أجل استكمال المؤسسات اللازمة لاستقرار العلاقات بين العمل ورأس المال، وليس من أهداف هذا الاتجاه إنهاء التمايز الطبقي، بل من أهدافه: التخفيف من حدة الصراع، بالتعليم والتوجيه والإرشاد. وقد مثلت الوضعية وعلى رأسها كونت، هذا الاتجاه. وتشكل الوظيفية طبعة جديدة من طبعات هذا الاتجاه.
ولا يزال الاهتمام بالنظام الأمثل، هو محور النظريات الجديدة، فمحاولات التأليف بين الماركسية والوظيفية، والاهتمام بالتوازن والصراع في آن واحد، لا يخرج عن هذا النطاق(43). وكل هذه النظريات تتفرع عن الاتجاه الأكبر الذي هو الدنيوية، فأكثر ما تبشر به هذه النظريات هو مزيد من ضبط الأداء، ومزيد من نمو القوى الإنتاجية، ومزيد من التعديل في علاقات الإنتاج "النظام الاقتصادي "، ومزيد من الرخاء، وسلع الاستهلاك، لكافة أبناء هذه المجتمعات (44).
وعلى هذا فإن العلوم الاجتماعية، ومنها علم الاجتماع، وجدت في الغرب لتعالج مثل هذه المشاكل، وهذه المشاكل لم تمر على المجتمعات الأخرى، بل إن الواقع الاجتماعي للعالم الإسلامي، يطرح أسئلة ومشكلات مختلفة تماماً، تتطلب إجابات غير تلك الإجابات، كما أن الاختلاف بين العالم الغربي، والعالم الإسلامي، يبدأ من المحور والمركز، حيث تركز العلوم الغربية على الدنيوية، بينما يعتبر الإسلام هو محور العلوم في العالم الإسلامي.
أو على الأقل ينبغي أن يكون كذلك.
وهكذا نجد أن دعوى العالمية المبنية على الموضوعية، والمنهج العلمي المحايد، دعوى زائفة، ولا غرابة بعد ذلك في أن نجد عالم الاجتماع الغربي يتحدث عن الأديان، بينما يقصد المسيحية فقط، أو يتحدث عن القوانين الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الإنسانية كافة، بينما هو يقصد ممارسات عامة في المجتمعات الغربية وحدها (45) ويمكن اختصار الدواعي الأساسية لصياغة العلوم الاجتماعية عموماً ومنها علم الاجتماع، صياغة إسلامية، فيما يلي:
1- التصورات الغربية الفاسدة الموجهة لهذه العلوم.
2- إن هذه العلوم صبت اهتمامها على الجزء المنظور منالواقع، ولم تعترف بالجزء الغيبي منه، لذلك فه لا تعبر عن الحقيقة كاملة.
3- إن النظريات والقضايا والحلول التي وجهت هذه العلوم، هي قضايا تخص جزء من العالم يسمى الغرب، ومن الخطأ تعميمها على بقية أنحاء العالم.
وسيتكشف لنا خلال هذا البحث، مزيداً من دواعي الصياغة الإسلامية، التي هي ألصق بعلم الاجتماع منها بغيره من العلوم.
ولمواجهة هذا الخلل الكبير في هذه العلوم، نادى المخلصون من أبناء العالم الإسلامي بصياغة العلوم الاجتماعية خاصة، صياغة إسلامية تتناسب مع التصورات الإسلامية، التي تعبر عن الحقيقة كاملة، وتعالج قضايا العالم بأجمعه، وليست قضايا العالم الإسلامي فحسب.
ونظراً لأن هذه القضية لا تزال حصيلة جهود فردية، فقد تعددت المسميات لهذه الدعوة، علماً بأنها تهدف إلى شيء واحد، هو إقامة هذه العلوم على أساس التصور الإسلامي السليم، للحياة والكون والإنسان، فقد وردت المسميات التالية: أسلمة العلوم، أو أسلمة المعرفة (46) والتوجيه الإسلامي للعلوم (47)، وصياغة العلوم صياغة إسلامية(48)، والتأصيل الإسلامي للعلوم(49)، وكلها تهدف إلى شيء واحد يلخصه د. إسماعيل فاروقي فيما يلي: "إن إعادة صياغة العلوم في ضوء الإسلام، هو ما نعنيه بكلمة أسلمة العلوم، ونعني بها إعادة صياغة المعلومات وتنسيقها، وإعادة التفكير في المقدمات والنتائج المتحصلة منها، وتقويم الاستنتاجات التي انتهت إليها، وإعادة تحديد الأهداف على أن يكون كل ذلك بطريقة تجعل فروع المعرفة المختلفة تثري التصور الإسلامي، وتخدم أهداف الإسلام "(50).
ويواصل حديثه فيقول: "وللوصول إلى ذلك الهدف، لا بد لقضايا الإسلام الأساسية، وأعني بها وحدة الحقيقة، ووحدة المعرفة، ووحدة البشرية، ووحدة الحياة والإيمان، بوجود هدف من وراء خلق الكون والإنسان، وتسخير الكون للإنسان، وعبودية الإنسان لله، لا بد لهذه القضايا كلها أن تحل محل التصورات الغربية "(51).
والحقيقة أن هذا الذي يذكره الفاروقي هو واجب كل مسلم مخلص في الإسلام.
والصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع، تعني على ضوء هذا المفهوم استقلال علم الاجتماع الإسلامي، استقلالاً يجعله في مواجهة علم الاجتماع الماركسي. وعلم الاجتماع الغربي الليبرالي. وذلك بسبب استقلالية التصور الإسلامي وشموليته. وتفرده عن التصورين السابقين.
ويترتب على هذا، الحكم بخطأ المحاولات، التي تجعل علم الاجتماع الإسلامي، فرعاً من فروع علم الاجتماع العام، أو فرعاً من فروع علم الاجتماع الديني.
وكذلك المحاولات الأخرى التي تجعله علماً للمجتمعات الإسلامية فقط، ولا شك أن هذا يتصادم مع السبب الذي يدعو إلى الصياغة الإسلامية، وهو إبراز التصور الإسلامي، الذي تعد العالمية إحدى خصائصه.
ويتبع ما سبق، أن يكون ميدان علم الاجتماع "هو واقع المجتمعات البشرية، في حدود كونها عالماً مشهوداً، يمكن ملاحظته واستخراج خصائصه، وقوانين حركته وتبدله "(52).
ويعني هذا الاكتفاء برأي الإسلام، في أمور يبحثها علم الاجتماع العام، ويتخبط فيها، نظراً لاعتماده على مفاهيم عقائدية أخرى، وذلك مثل: "أصل الأديان ونشأتها، وتعاقب النبوات، وتتابع تشريعاتها، وأحكامها "(53).
ويتبع هذا دراسة القضايا الاجتماعية، التي فصل أحكامها الإسلام كالأسرة، وقضايا المرأة، دون إغفال لأوامر الشرع الإسلامي في ذلك.
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نور الدين- عضو نشيط
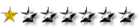
-

تاريخ التسجيل : 14/01/2010
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» إمكان الصياغة الإسلاميةلعلم الاجتماع أولاً: أهداف الصياغة الإسلامية
» مصادر الصياغة الإسلامية
» المبحث الثاني : اتجاهات الباحثين في علم الاجتماع في العالم الإسلامي
» عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
» كتب في علم الاجتماع
» مصادر الصياغة الإسلامية
» المبحث الثاني : اتجاهات الباحثين في علم الاجتماع في العالم الإسلامي
» عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
» كتب في علم الاجتماع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى


