إمكان الصياغة الإسلاميةلعلم الاجتماع أولاً: أهداف الصياغة الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
 إمكان الصياغة الإسلاميةلعلم الاجتماع أولاً: أهداف الصياغة الإسلامية
إمكان الصياغة الإسلاميةلعلم الاجتماع أولاً: أهداف الصياغة الإسلامية
إن القيم الإسلامية تثبت بالدليل العقلي -المقبول عند الجميع- أنها الحقيقة، الوحيدة التي يجب على الجميع اتباعها: ((إنّ الدّين عند الله الإسلام )) [آل عمران:19]. ومن هنا فإن المسلمين بالذات يتحملون العبء الكامل في إيصال هذه الحقيقة إلى كافة البشر ((ولتكُن منكم أُمّةٌ يدعون إلى الخيرِ ويأمرون بالمعروف وينهون عنِ المنكر )) [آل عمران:104]. والحق، أنه من خيانة الأمانة أن وجه العلوم وجهة مضادة أو مناوئة، أو حتى محايدة لهذه الحقيقة. وإذا عرفنا أن المنطلقات التي ينطلق منها علم الاجتماع هي منطلقات معادية للدين، عرفنا إلى أي درجة يبتعد المسلمون عن امتثال الأمر السابق.
إن المسلم إذا أراد صياغة علم الاجتماع صياغة إسلامية، فإن عليه أن يبدأ من المنطلقات الأساسية، والمحور الأساس في الإسلام، وأعني به العقيدة، أو نظرة الإسلام للكون والحياة والإنسان، لأن عدم البدء من هذا المنطلق، يعني وجود نوع من التلفيق، وذلك "بأن نستخدم المفاهيم الغربية نفسها، مع تغيير المصطلحات الدالة عليها، أو مع محاولة متعنتة لإثبات أن كل مفهوم من هذه المفاهيم له أصل في الإسلام، يبرر الأخذ به. إن هذا المنهج يؤدي - بطبيعة الحال - إلى العودة لاستخدام الأنساق الغربية الكلية، وإن تغيرت المصطلحات والأسماء، أو حيثيات القبول. والخطر من التلفيقية، يعني أن نضيف إلى ترسانة المفاهيم والأنساق الغربية، مفاهيم تتعلق بالإيمان بالله مثلاً، أو بالأسرة، أو بعض القيم، ونتصور أننا قد حللنا بهذا الإشكالية الصعبة، ناسين أن المفاهيم الدنيوية تتولد عنها في الأنساق الفكرية الغربية، مفاهيم فرعية في كل مناحي المعرفة الاجتماعية، تتعارض تماماً مع المفاهيم الفرعية المتولدة عن الإيمان بالله تعالى(155).
الهدف الأول:
الهدف الأساس في الصياغة الإسلامية، هو أن يكيِّف علم الاجتماع نفسه في ظل مبدأ الإيمان بالله تعالى، وهذا يعني عدة أمور تكوِّن في مجملها التصور الإسلامي العام:
(أ) إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون بكل ما فيه من أشياء، وظواهر، وأحياء، بما فيها الإنسان. فالكون كله يبتدئ خلقه ووجوده من الله، وينتهي مصيره إليه. وهو المدبر والمهيمن عليه. ويعني هذا: "أن الطبيعة لم تخلق نفسها، ولم توجد بنفسها. بل أوجدها الله. وهي تسير على سنن مطرده، وفق نظام مترابط الأجزاء، والله الذي خلقها هو المقدر لسننها ونظامها"(156).
(ب) الإيمان بالغيب، حيث ينقسم العالم إلى قسمين، يمكن التمييز بينهما، ولكن لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. هما: عالم الغيب، وعالم الشهادة، ويتصل عالم الغيب بذات الله جل وعلا، وصفاته والحياة الآخرة، والملائكة، والجن، والروح.
بينما يعني عالم الشهادة "كل ما على الأرض، وكل ما في الكون من أشياء وأحياء، وأحداث، وظواهر، وعلاقات، تشكل نظام الكون المادي، في أرضه وسمائه، وفي مادته وفضائه، وفي اجتماع المخلوقات وفي انفرادها(157). ولا سبيل إلى معرفة علام الغيب إلا عن طريق الوحي، وعلى هذا فليس العقل الإنساني أداة وحيدة للوصول إلى الحقيقة، وإنما هناك طريق آخر هو الوحي، له ميدانه الخاص، لا يستطيع العقل بلوغه لوحده. "فالعقل أداة الوصول إلى حقائق الطبيعة. وهو معرض مع ذلك للخطأ. والوحي أداة معرفة عالم الغيب - ما وراء الطبيعة "(158).
(ت) الإيمان بأن الله هو المشرِّع للإنسان. فهو الذي قدر للطبيعة سننها، وهو أيضاً الذي وضع للإنسان عن طريق الوحي مقاييس الخير والشر، وحدد المعالم الثابتة للأخلاق والحقوق.
(ث ) الإيمان بأن الله اصطفى بعض خلقه من البشر، ليبلِّغ شرعه، وهؤلاء هم الأنبياء، ومنذ بداية خلق الإنسان، بعث الله أنبياء كثيرين ليبلغوا الناس شرع الله. وقد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهو خاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسالات.
(ج ) الإيمان بأن الإسلام هو خاتمة الرسالات. وهو رسالة عالمية موجهة إلى كافة البشر، كما أنه رسالة تامة ومكتملة، وصالحة لكل زمان ومكان.
وفي إطار هذا التصور الإسلامي يمكن أن نجمل بعض المبادئ الأساسية التي تشكل إطاراً نظرياً لعلم الاجتماع الإسلامي. وتتعلق هذه المبادئ بطبيعة الإنسان، وطبيعة النظام الاجتماعي، وطبيعة التاريخ البشري.
أولاً- طبيعة الإنسان:
1- قال الله سبحانه وتعالى: ((الذي أحسنَ كلّ شيءٍ خلقه، وبدأ خلقَ الإنسان من طينٍ. ثم جعل نسْله من سُلالةٍ من ماءٍ مهين. ثم سوّاه ونفخ فيه من رّوحِه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون )) [السجدة:7-9].
فالإنسان في أصله مخلوق من طين، ونفخ الله فيه من روحه، وقد بينت هذه الآية ازدواج الطبيعة الإنسانية، فهو من طين الأرض، ومن نفخة الله فيه من روحه، ويعني هذا وجود نوازع الخير، ونوازع الشر في نفسه. ويقول سيد قطب: "إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة، مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتجاه، ونعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد، أنه بطبيعة تكوينه - من طين الأرض، ومن نفخة الله فيه من روحه - مزود باستعدادات متساوية للخير والشر، والهدي والضلال، فهو قادر على التمييز بين ما هو خير، وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء، وأن هذه القدرة كامنة في كيانه. يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة: ((ونفْسٍ وما سوَّاها. فألهمها فُجورها وتقواها )) [الشمس:8]. ويعبر عنها بالهداية تارة: ((وهَديناه النَّجدين )) [البلد:10]، فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد.. والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية، إنما توقظ هذه الاستعدادات، وتشحذها هنا أو هناك، ولكنها لا تخلقها خلقاً، لأنها مخلوقة فطرة، وكائنة طبعاً، وكامنة إلهاماً(159).
وينفي ما سبق، أن تلحق بالإنسان خطيئة موروثة، أو أنه آثم بالضرورة.
2- إن وجود نزعات الخير، والشر في الإنسان، تعني وجود شيء آخر، وهو وجود الإرادة الحرة فيه، والقدرة على اتخاذ القرار، "وهذا يعني أن النزعات في الإنسان ليست جبرية، بل إن الإرادة الإنسانية ذاتها هي التي تحد العمل الإنساني، في أي من الاتجاهين. وينبذ هذا "المبدأ" أيضاً، كل أنواع الآراء الجبرية الأخرى، مثل الجبرية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو البيولوجية "(160).
وهذه الإرادة الحرة، هي ما تميز الإنسان به عن بقية المخلوقات،وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ((ألم تر أنّ الله يسجُد له مَنْ في السماوات ومن في الأرضِ والشمسُ والقمرُ والنُّجوم والجبال والشجرُ والدّوابُّ وكثير مِن الناس، وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب )) [الحج:18]، فكل ما في الوجود يسجد لله ويطيعه. وأما الناس فكثير منهم يسجد ويطيع، وكثير يعصون ولا يسجدون. وهذا نتيجة للإرادة الحرة، التي شاء الله أن يمنحها للإنسان.
وفي مقابل هذه الإرادة الحرة، التي منحها الله للإنسان، جعله مكلفاً مسؤولاً. فقد كلفه وأمره بأوامر ليبتليه ويمتحنه. وجعله مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أعماله: ((وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائره في عنُقه )) [الإسراء:13]، وقال: ((ولا تزِرُ وازرةٌ وزر أخرى )) [الأنعام:164].
3 - منح الله الإنسان القدرة على التعلم وطلب المعرفة، حيث ميزه بحواس تعينه على تكوين خاصة العقل والتفكير، التي تمكنه من العلم وإدراك الحقائق الخارجية: ((والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون )) [النحل:78]، فمعنى الآية أن عدم العلم في حال الولادة، يتحول إلى علم بواسطة السمع والأبصار والأفئدة. ويتميز الإنسان أيضاً بقدرته على التعبير، والبيان، عن علمه وأفكاره: ((خَلق الإنسان، علّمهُ البيان )) [الرحمن: 3-4]، كما أن علم الإنسان قابل للزيادة دائماً، وبإمكانه ابتكار أمور لم يعهدها من قبل(161).
4- لقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق، فقد كرمه بأن خلقه على أحسن تقويم، وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته، وبها استأهل الخلافة في الأرض، وكرمه بتسخير القوى الكونية، له، بأن أسجد له ملائكته، وبحلول اللعنة على إبليس، الذي أبى واستكبر عن السجود لآدم، كما أن الله سبحانه وتعالى أعلن هذا التكريم في كتابه: ((ولقد كرّمنا بني آدم، وحملناهم في البرِّ والبحرِ ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثيرٍ مِّمَّنْ خلقنا تفضيلاً )): [الإسراء:70].
هذه نظرة إجمالية إلى رأي الإسلام حول حقيقة الإنسان. وهي نظرة توحي بالأسس، التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الاجتماعي، حيث الاعتبار الأكبر للخلق، والخير، والفضيلة.
ثانياً- طبيعة النظام الاجتماعي:
لقد أوجد الله المجتمع البشري، لنفس الحكمة التي أوجد لها الإنسان كفرد، وأوجد لها العالم، فغاية وجود المجتمع البشري، تتفق وتتمشى مع الغاية من الوجود الإنساني - بخاصة - من ناحية، ومع غاية وجود العالم -عامة - من ناحية أخرى، فالله سبحانه وتعالى القدير على كل شيء، لو شاء لجعل الإنسان مخلوقاً فردياً، لا يعيش في مجتمع بالضرورة. ولكنه شاءه اجتماعياً، تحقيقاً للحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، وهي الابتلاء، حيث يمتحن الله الناس بالناس في المجتمع، عن طريق التفاعل بينهم، المتمثل في العلاقات والمعاملات الاجتماعية بشتى صنوفها(162).
ويتكون المجتمع، أي مجتمع، من أفراد من البشر، إضافة إلى القوانين، والأفكار، والمشاعر، والعقيدة، ويضاف أيضاً إلى ذلك القيادة المجتمعية، والغاية من كل فعالية يقوم بها المجتمع(163).
ويذهب أحد الباحثين إلى أن المجتمع يتكون من أساسين.
الأول: هو ما يتمثل في العوامل البيئية والجنسية، وما يتبعها من تأثير متبادل بين الإنسان والبيئة.
والثاني: ويعتبر جوهرياً في تكوين شخصية المجتمع: هو الإرادة الجمعية الحرة للمجتمع، التي يختار بها المجتمع منهج الحياة، وشكل البناء الاجتماعي، والعقيدة التي ينبثق منها ذلك البناء(164).
ويذهب آخر إلى أن المجتمع "هو مجموعة من الأفراد، يربط بينها رابط مشترك، يجعلها تعيش عيشة مشتركة. وتنظم حياتها علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم. قد يكون هذا الرابط الأرض، وما يقوم عليها من مصالح مشتركة، كالمجتمع السويسري. وقد يكون الجنس والأصل، وما يتصل به من لغة، وثقافة، وتاريخ، ومبادئ، وهو المجتمع القومي. وقد يكون المبادئ السائدة والمعتقدات المشتركة، وما يتولد عنها من أفكار وعواطف وسلوك، وهو المجتمع العقائدي كالمجتمع الإسلامي "(165).
ونخلص من هذه التعريفات، إلى أن الأجزاء الرئيسة التي تكون المجتمع هي: جمع من الأفراد والقوانين، ويدخل فيها العقائد، والمشاعر، والأفكار.
وإذا أردنا أن نعرف بداية المجتمع، فإن الله سبحانه ذكر أن المجتمع الإنساني بدأ برجل وامرأة، هما آدم وحواء: ((يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )) [الحجرات:13]. وتوضّح هذه الآية، أن ذرية آدم وحواء تكاثرت منهما وتطورت إلى شعوب وقبائل، وهو ما توضحه الآية الأخرى: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً )) [النساء:1]، ولم يقتصر الأمر على الشعوب والقبائل، بل حتى هذه تطورت في نهاية الأمر، إلى ما يسمى بالأمم، حيث تعتبر العقائد والأديان هي المميز بينها. "وبالرغم مما طرأ على المجتمع والجماعات والقبائل، والأمم من تطور فكري، فقد بقيت الأسرة التي تبدأ برجل وامرأة وذريتيهما الهيكل البنائي لكل مظاهر هذا الوجود، وهذه حقيقة عامة، ليس للإنسان حاجة إلى زيادة تطويرها... وقد بقيت الأسرة نفسها حجر الزاوية في النظام الاجتماعي. رغم ما طرأ عليها من أشكال مختلفة، فأصبحت متشعبة، أو منشطرة، أو متعددة الأنساب والزيجات "(166).
وقد اقتضى وجود الفرد في محيط اجتماعي، سواء كان داخل أسرته أو خارجها، وجود صلات وعلاقات وارتباطات. فلم يكن المجتمع ركاماً من البشر، ولا حشداً متراصاً من الأعداد، ولكنه يتجاوز ذلك إلى علاقات العمل النامية، والصلات الناشئة بين أفراده، سواء كانت صلات ودية، أو صلاة عدائية. وإذا عدنا إلى قصة الإنسانية الأولى، وجدنا: أن آدم خلق لتكون معه زوجه، وليكون معها، واقتضى وجودهما مشاركة وجدانية، تمثلت فيما نشأ بينهما من سكينة، وطمأنينة، ومبادلة عاطفية في السراء والضراء. وقد أشار القرآن إلى مشاركة آدم وحواء في المسرة في قوله تعالى على لسانهما: ((دعوا الله ربّهُما لئِنْ آتيتنا صالِحاً لنكوننَّ من الشاكرين )) [الأعراف:89]، وإذا مشاركتهما فيما عرض لهما من انتكاس ((قالا: ربّنا ظلمنا أنفُسنا وإن لم تغفرْ لنا وترحمْنا لنكوننَّ مِن الخاسرين )) [الأعراف:23] (167).
من أوائل الصلات العدائية، قصة ابني آدم، حيث قتل أحدهما الآخر حسداً وظلماً، لأن الله لم يتقبل منه قربانه، وتقبل من الآخر. ولأن النفس الإنسانية بطبيعتها لها نزعات ورغبات، وإرادة حرة مختارة، فلا بد من حدوث الاختلاف والاجتماع، والتناقض والتصالح.
وإن من الأمور البدهية حاجة المجتمع إلى قانون ينظم العلاقة بين الأفراد، ويقضي على النزاعات والخصومات، ويحكم بالعدل. وقد اتبع آدم عليه السلام وزوجه القانون الإلهي، وهو الدين الحنيف. إلا إن ذريته من بعده، لم يستمروا على نفس المنوال، بل كثيراً ما انقادوا خلف رغباتهم وشهواتهم. وقد أوغل كثير منهم في الانحراف إلى درجة بعيدة، وقد تداركهم الله برحمته، فأرسل لهم رسلاً منهم، مبشرين ومنذرين. وهكذا كانت علاقة البشر مع دين الله في شد وجذب، حيث يبتعدون تارة، ويقتربون منه تارة أخرى.
والحقيقة الباقية من حقائق المجتمع، أنه بحاجة ماسة إلى قيادة وسلطة تعمل على نشر الدين، أو القانون الذي يحكم العلاقات بين الناس، وطبيعي أن يكون القادة من البشر أنفسهم، سواء كانوا أنبياء ورسلاً، أو أشخاصاً عاديين "وفي الوقت الذي تنبذ فيه القوانين التي أوحى الله إلى البشرية بواسطة أنبيائه كلّ أنواع الممارسات البغيضة، وعدم عدالة التوزيع الاقتصادي، فقد سن الإنسان قانوناً يعكس ي العالم رغبات الدوائر الأقوى في المجتمع، وتنحو إلى إعلاء كلمة الظلم، بل وتميل إلى تركيز السلطة في يد قلة من الأيدي المتغطرسة"(168).
ثالثاً- طبيعة التاريخ البشري:
"إن حركة التاريخ هي حركة البشر القاطنين على سطح هذا الكوكب، بكل ما يعتمل في نفوسهم من دوافع ورغبات وصراعات، وكل ما يقع منهم وعليهم من تجاذب وتدافع وتصادم، من خلال حيز الزمان والمكان، والتيار الذي يدفع الجميع. ومن ثم فكل مكونات النفس البشرية داخلة في حركة التاريخ، وكل الصدامات والصراعات داخلة في حركة التاريخ: بحث الإنسان عن الله، وبحثه عن الطعام، وبحثه عن الحق والعدل، وبحثه عن الجمال، وسعيه إلى الغلبة والسيطرة، وسعيه لتسخير كنوز السماوات والأرض، وسعيه إلى الاستحواذ والملك. هذه هي حركة الإنسان في الأرض. . وهي تسير في خطين اثنين: خط الهدى، وخط الضلال "(169).
وقد شهد التاريخ - على طول حركته - تدافعاً وصراعاً بين الحق والباطل، وكانت الأنظمة العادلة، في تعاقب مستمر، مع الأنظمة الظالمة في لمجتمع البشري، فآدم وحواء كانا على حق، أي مسلمين، وكذلك أولادهما من بعدهما، ولكن مع طول العهد انحدر كثير من ذريتهم نحو الضلال، فأصبح الناس أمتين: أهل الشرك والضلال، وأهل الحق والإيمان، ولكن الله سبحانه أرسل رسلاً لإعادتهم نحو الحق والهدى. وغالباً ما يتعرض الرسل للتكذيب ولاستهزاء والسخرية من قبل لفئات المترفة والحاكمة، ويناصبونهم العداء، وقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل، مما يوضح شدة المعركة التي يخوضونها.
وكثير من الرسل هيأ الله لهم نشر دعوتهم، وإقامة دعائم الدين، ولكن مع طول العهد ينسى خلفهم، وينحرفون عن الشريعة التي جاءوا بها. ثم يبعث الله رسولاً آخر، يجدد المعالم، التي انمحت، ويقيم شرع الله. وظل الناس على هذا الحال، حتى بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالشريعة النهائية والرسالة الخاتمة، ولا يعني هذا أن صراع الحق والباطل قد انتهى، ولكنه يعني أن الله سبحانه ارتضى هذا الدين لناس، حيث أكمله وأتمه، وعليهم أن يتبعوه، ولا يتبعوا السبل الباطلة، فتحيد بهم عن سبيله. ويعني هذا أيضاً أن مهمة نشر هذا الدين، تقع على عاتق أتباعه المسلمين.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "الجهاد ماض منذ أن بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال.. "(170). ويوضح هذا الحديث أن نشر الإسلام يحتاج إلى مشقة وعناء، نظراً لما يواجهه من قوى باطلة وضالة.
ففي نفس المسلم هناك مواجهة بين الفجور والتقوى، وبين الشيطان والإنسان.. وفي المجتمع المسلم مواجهة بين المعروف والمنكر، وبين أهل العدل وأهل البغي.. وخارج المجتمع المسلم، مواجهة أخرى، بين الكفر والإيمان، بين حزب الله، وحزب الشيطان.
"فإقرار منهج الله في الأرض لا يتحقق بخارقة، وإنما يتحقق بالجهاد، وبقدر ما يبذل من جهد روحي ومادي، جهد التوكل واليقين، وجهد السلاح والدفاع "(171). وعلى كل حال. فإن حركة التاريخ كما يصورها لقرآن "هي حركة اجتماع، وتشتت، أساسها الأمة المسلمة، التي تشعبت عنها الوثنيات والمعتقدات الباطلة، بأشكالها المختلفة، وحركة هداية وضلال تتمثل في الاستعمال الصحيح أو السيئ للإمكانيات المتاحة للإنسان في نفسه، والأشياء من حوله، وهي حركة يرشدها الله بالنبوات وبالوحي، كلما انحرفت عن مسيرتها الصحيحة، بالبعد عن مصادر العلم والهداية الصحيحة والوقوع في أسر الضرورات "(172).
إن ما أوردناه فيما سبق حول الإيمان بالله تعالى، وحول طبيعة الإنسان والنظام الاجتماعي، والتاريخ البشري، يعتبر المنطلقات الأساسية لعلم الاجتماع النظري، أو البحث الذي يعنى بتلمس مبادئ الطبيعة البشرية، والسلوك البشري. ومع أن التوقف عند حد المعرفة النظرية ليس هدفاً لعلم الاجتماع الإسلامي، بل يجب تطبيق مثل هذه المعرفة لتعزيز الإسلام في نفوس الأفراد والمجتمعات، إلا أننا لا نتصور عالماً للاجتماع، يشارك في عملية نشر الإسلام، وليس لديه أي معرفة بطبيعة الكون والنفس الإنسانية والنظام الاجتماعي، وحركة التاريخ(173).
ولعلنا هنا نتذكر على الفور الحكمة من القصص الذي قصه الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، حيث لم يقصه الله سبحانه وتعالى لمجرد إثبات حادثة وقعت، ولكن الهدف الأساس، والذي توحي به مجموع القصص، هو تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقلوب أمته من بعده على الحق، وكذلك أخذ لعظة والعبرة من أحوال الأمم السابقة، ومحاولة تلافي الأخطاء التي وقعت فيها تلك الأمم، وقد قال سبحانه وتعالى مبيناً ذلك: ((وكُلاًّ نقُصُّ عليك مِن أنباء الرسلِ ما نُثبّتُ به فُؤادك، وجاء في هذه الحق وموعِظةٌ وذكرى للمؤمنين )) [هود:120]. وقال تعالى: ((لقدْ كان في قصصهم عِبرةٌ لأولى الألباب )) [يوسف:111]، وكذلك كل معرف نظرية لا تكون ذات قيمة، إلا إذا طبقت على أرض الواقع، وخدمت أهداف الإسلام.
ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه المنطلقات الأساسية، توجه نظرية علم الاجتماع الإسلامي، التي تفسر السلوك البشري، بعيداً عن الوجهة الحالية للنظريات الغربية، فلأنها تحسب لجميع العوامل حسابها، فإنها تسلك مسلكاً وسطاً، ليس فيه تطرف أي جهة، بحيث تستطيع تفسير عمليات الاجتماع والتعاون، والصراع والتنافس، كما أنها تشير إلى وجود الإنسان المادي والروحي، وتركز أيضاً على الإرادة الحرة المختارة، التي تعتبر البداية المباشرة لعمليات الاستنتاج، واتخاذ القرار، كما أن لديها القدرة على تفسير التغير في السلوك الفردي، وفي النظام الاجتماعي(174)، وهذا على خلال النظريات الغربية، التي التزمت بمواقف متطرفة، مما أفقدها القدرة على تفسير المتناقضات الأساسية في العلاقات الإنسانية، "فعلى سبيل المثال عجزت الآراء، التي تدور حول نظرية مصغرة، عن تفسير الأنماط المكبرة، كما تعجز تلك الآراء التي تهتم بالصراع عن تفسير أنماط الوفاق، ولا تزال الآراء التي تفسر الجريمة غير قادرة على تفسير التلاؤم، لأن جميع هذه الآراء تركز على الإنسان، باعتباره كائناً مادياً، وتهمل وجوده الروحي "(175).
إن الهدف الأول من أهداف الصياغة الإسلامية هو أن يسير علم الاجتماع في ضوء المعتقدات الإسلامية الأساسية، التي تكون نظرة الإنسان العامة للوجود، ولا يعني هذا أن هذه المعتقدات هي موضوع علم الاجتماع، ولكنه يعني أنها تكون حاضرة في ذهن عالم الاجتماع، عند بحثه لأي قضية داخلة في حدود موضوع علم الاجتماع، وهو "واقع المجتمعات البشرية في حدود كونها عالماً مشهوداً يمكن ملاحظته واستخراج خصائصه، وقوانين حركته، وتبدله "(176).
الهدف الثاني:
يهدف علم الاجتماع الإسلامي إلى قياس مدى اقتراب المجتمعات الإسلامية، أو بعدها عن الإسلام، وهذا هدف مرتبط ارتباطا أساسيا بالهدف السابق، حيث إنه لا يمكن فصل العقيدة عن الشريعة، أو النظام في الإسلام، فبينهما علاقة وطيدة، تشبه تماما علاقة جذور الشجرة بالشجرة نفسها، فمن المستحيل قيام النظام الإسلامي بدون العقيدة الإسلامية، كما أنه من الخطأ وصف أي مجتمع بأن عقيدته إسلامية، كما أنه من الخطأ وصف أي مجتمع بأن عقيدته إسلامية، وهو لا يطبق الشريعة الإسلامية في حياته.
ويعني ما سبق أن نظام الإسلام نظام شامل، يتناول جميع شعب الحياة، وينظم علاقات الإنسان مع نفسه ومع غيره. ويبتر الإسلام حين، يفهم على أنه مجرد طقوس وعبادات وشعائر يؤديها الفرد بصيغ معينة، ولكن الإسلام طاعة شاملة لحكم الله في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والأسرية والقانونية والتربوية، في الحرب والسلم، وفي كل علاقة بين شخصين. فكل نواحي الحياة لها حكم في الإسلام، إما ينص من كتاب أو سنه، أو باستنباط من نص، أو بقاعدة عامة.
بل إن لفظة الإسلام نفسها، تدل على هذا المعنى، فهي تعني "الانقياد والامتثال لأمر الآمر، ونهيه، بلا اعتراض ". وقد سمي ديننا بالإسلام، لأنه طاعة الله، وانقياد لأمره ونهيه، بلا اعتراض (177).
ولفظ العبادة مثل لفظ الإسلام، لا يمكن قصرها على الشعائر فقط، ولكنها تعني طاعة الله سبحانه وتعالى، وتنفيذ أمره، وهي بالتحديد كما عرفها ابن تيمية: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال ، والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة، والزكاة، والصيام،والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين ،وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، ولإحسان للجار، واليتيم، والمسكين، وابن السبيل، والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك، من العبادة "(178).
إن المسلم لا يجد أي مشكلة في معرفة شمولية الإسلام، ولكن المشكلة في النظرة العامة السائدة عند بعض المثقفين، الذين درجوا على رؤية العالم محصور بين رؤيتين أيديولوجيتين هما : الاشتراكية والرأسمالية، ولو أنهم بذلوا أقل الجهد في فهم الإسلام، لأدركوا أن له رؤية متكاملة وشاملة، ليست بالاشتراكية ولا بالرأسمالية، بل تختلف عنهما، حيث تسلك مسلكا وسطا بالنسبة للمسائل الاجتماعية، كما أنها رؤية سابقة، برزت إلى الوجود قبل إن توجد الرأسمالية والاشتراكية، وهي ليست فكرا بشريا، ولكنها وحي إلهي.
"ومسألة تنظيم الإسلام للحياة الاجتماعية في جوانبها المختلفة... كانت نتيجة للوحي القرآني، ولوقائع السيرة النبوية، أكثر مما كانت ثمرة للاجتهاد النظري الفقهي الذي اتسعت آفاقه على تعاقب الأيام. بل إن نظريات الفقهاء والأئمة في الأحوال الشخصية، والنظم العائلية، والحقوق الدولية، والتنظيمات السياسية العسكرية، والتفرعات المالية والاقتصادية، ليست إلا امتدادا لعض الوقائع الجزئية، التي حدثت على عهد الرسول عليه السلام. وكان له فيها قول أو تنبيه أو إرشال أو تقري "(179) والحقيقة أنه ليس من الغلو التأكيد على أن أي واقعة جديدة في الحياة الإنسانية المعاصرة كلها، لها بشكل أو بآخر، أصل في الكتاب أو السنة، أو وقائع السلف الصالح، أو كليات الإسلام وقواعده العامة.
ويشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام على تشريع للأسرة، يوضح علاقات أفرادها ببعضهم، كما يشتمل على نظام اقتصادي مالي، يحدد طرق الكسب والإنفاق، وينظم العلاقات المالية بين الناس، ويحدد مفهوم الملكية وبين قيودها. كما يتعرض لأسس التكافل بين أفراد المجتمع.
كما يشتمل على نظام سياسي أو نظام الدولة، يتضمن مبادئ عامة للحكم والسياسة، وبيان لعلاقة الراعي الرعية، وحقوق الرعية مسلمة كانت أو غير مسلمة، وقواعد السلم والحرب. كما يشتمل على نظام للعقوبات يكفل للمجتمع السير في الطريق السليم، الذي شرعه الله لهم(180).
وجميع التشريعات الإسلامية السابقة، تقف موقفا وسطا بين الانغلاق والانفتاح، بين التضييق والحجر، وبين الحرية غير المحدودة. فمنهج الإسلام يقوم على الضبط والتهذيب، لا على الكبت، ولا على الانفلات.
ولا شك أن الموقف الوسط هو الأمر الطبيعي، الذي نوفق بين الأطراف المتنافرة، "وبما أن الإسلام هو القانون الطبيعي للتعامل، فإذا لم يطبقه مجتمع إسلامي ما، فإنه يتجه آليا إلى الظلم والانحدار. وحتى لو طبّق هذا القانون مجتمع غير مسلم فإنه ينتعش(181) ".
وسنعرض فيما ياي عرضا موجزا لتشريعات الإسلام العامة في الأمور الاجتماعية السابقة، حيث تعتبر هي المقياس، الذي نقيس على ضوئه مدى بعد المجتمعات الإسلامية أو قربها منه، فهي تشكّل الصورة المثالية للمجتمع الإسلامي، فكل انحراف عن هذه الصورة يعني ابتعادا عن الإسلام. وهذا ما اقترحه أحد علماء الاجتماع المسلمين حيث قال : "كما نريد أن تمثل هذه الصورة ما يسميه علماء الاجتماع: النمط المثالي، الذي يمكن استخدامه لقايس مدى انحراف المسلمين في تصرفاتهم عن الإسلام "(182).
والحقيقة أن هذه الصورة مجردة هكذا، ناقصة، ولا تكون مكتملة إلا حينما تكون مصحوبة بالقيم الأخلاقية، التي أمر بها الإسلام، والتي يكون لها أكبر الأثر في تطبيق شريعة الإسلام في كل أمر.
ولعل من أهم هذه القيم: التقوى، الاستقامة، والصدق، ولإصلاح، الإيثار، التعاون، والصبر. ونلاحظ أثر هذه القيم خلال الحياة العامة، فمثلا السبب المباشر في اللجوء إلى القوانين الوضعية، بدل الشريعة، هو فقدان التقوى، التي هي أهم قيمة أخلاقية في الإسلام، وتعني: اتقاء عذاب الله بطاعته، وتنفيذ أوامره. وإلاّ كيف يفسر لجوء جماعة مسلمة إلى الحكم بغير الإسلام، ومخالفته في أمور أساسية؟.
والذي رشك فيه أيضا، أن صورة المجتمع الإسلامي المثالي، لا يمكن فصلها عن التقوى وسائر الأخلاق الإسلامية. بل إن لهذه العبادات كالصوم، والصلاة، والزكاة، والحج، ولا يمكن فصلها عن التقوى وسائر الأخلاق الإسلامية. بل إن لهذه العبادات التي يظن أنها فردية للوهلة الأولى، آثارا اجتماعية.
وقد وصف الله تعالى الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر: ((إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) (العنكبوت: 45)، وذلك نتيجة لما تزرعه في نفس المسلم من حب الطاعات، ومن كراهية المعاصي. ونظرا لأن المسلمين يؤدون الصلاة في جماعة خمس مرات في اليوم، ويجتمعون لأداء الجمعة في كل أسبوع، فإنها تنشئ بين المسلمين المحبة والإخاء، وتقوي الروابط بينهم. كما أنها تعلمهم على النظام والانضباط، والمحافظة على الأوقات.
وأما الصيام، فغن آثاره الاجتماعية واضحة، فالمسلمون يصومون جميعا في شهر واحد. ومع بداية هذا الشهر يظلل المجتمع كله جو من الطهارة والنظافة والإيمان، ودماثة الأخلاق ، وحسن الأعمال، وتنشأ عطفة كبيرة بين فضلاء المسلمين ، نحو الفقراء والمساكين. ولعل من حكم الصوم الظاهرة هي الإحساس بما يحس به الفقير، الذي يطوي على الجوع بطنه أياما عديدة. وهذا ما يدفع المسلم أكثر فأكثر، نحو مد يد العون لكل محتاج. بالإضافة إلى أن الصوم يعوّد إلى الصبر، والتجلد، وقوة التحمل. كما أنه كالصلاة تماما، يزيد من التقوى، التي تعتبر ركيزة في تصرفات المسلم.
وكذلك الحج والزكاة، لا تقل عنهما أبدا في آثارهما الاجتماعية (183).
وبناء على ماسبق فإن المجتمع الإسلامي المثالي ترتبط فيه الشريعة بالعبادة، والقيم الأخلاقية .
وسوف تتجاوز التفصيل في الهيكل الاجتماعي العام للمجتمع الإسلامي، المكون من أنظمته الثلاثة : النظام الأسري، والنظام السياسي، والنظام الإقتصادي، لأن ذلك معروف ومدروس بشكل يسهل الرجوع إلأيه، والاطلاع عليه في كثير من المصادر (184).
الهدف الثالث:
يهدف علم الاجتماع الإسلامي إلي وضع الخطط المستقبلية، وإيجاد الوسائل والسبل، التي تكفل سير المجتمعات الإسلامية المعاصرة في حدود مبادئ الإسلام، وتقلل من ابتعادها عنه.
ويعني هذا الهدف مواجهة التغييرات التي تطرأ على المجتمعات الإسلامية، وذلك باعتماد التغيير الاجتماعي المخطط، الذي يسير وفق خطط مدروسة، وموضوعة بعناية.
إن أي مجتمع لا بد أن يتغير، حيث إن التغير سنة من سنن الحياة، وإذا سلمنا بوقوع التغير، فلا بد أن نتأكد من أنه لا يتعدى حدود الإسلام، ولا بد من إيجاد الوسائل والسبل، التي تقلل من ابتعاد المجتمع عن النموذج الإسلامي.
وهذا يتطلب من عالم الاجتماع المسلم، مواجهة كم كبير من المشاكل الأساسية في المجتمعات الإسلامية، ويأتي في مقدمتها قضايا التنمية. فكل الحكومات الإسلامية، تحاول جاهدة الخروج من حالة التخلف، التي تعيش فيها، وقد اتبعت كل منها أحد الطريقين الرئيسين في هذا العصر، وهما الطريق الرأسمالي، أو الطريق الاشتراكي. ومع أن التنمية تسير في هذه الدول بخطى حثيثة منذ قرابة ربع قرن، إلا أن مشكلة التخلف لم تختف حتى الآن، بل إنها تزداد يوما بع يوم، "فالدول التي تتبع نظام التنمية الرأسمالية في العالم الإسلامي، هي دول غارقة في الديون بصورة مخيفة، ذلك أنها تشري أساليب التصنيع الغربي بأسعار مرتفعة جدا، وتكاليف باهظة. أما الدول الإسلامية التي تتبع النظام الاشتراكي، فإنها تعاني من العجز البيروقراطي والتسلط، الذي تمخض عنه تبديد الموارد الوطنية، وغرس الإحساس بالغربة بين العمال. ونتيجة لهذا، فإن الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه هذه الدول بشق الأنفس، بعد سيطرة أجنبية طويلة، يضيع ويفقد بسبب التبعية الاقتصادية، التي لم تؤت ثمارها بعد "(185).
ولعل أفضل ما يصف نتائج التنمية التي اتبعت في الدول الإسلامية، هو التقرير الرسمي الذي قدمه أمين الجامعة العربية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وتجربة الدول العربية لا تختلف عن تجربة الدول الإسلامية غير العربية. وهذه مقتطفات من هذا التقرير(186):
"لقد كان للطموح العربي إلى التقدم السريع، أثره في زيادة الاعتماد على السوق الدولية، وتنامي ظاهرة العلاقة غير المكافئة على حساب التكامل القومي المتوازن. وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض الدلالات الاقتصادية التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، ولكنها بليغة في مغزاها: إن 70% من المواطنين العرب لا يزالون يعانون من الأمية، وما زال أكثر من نصف المجتمع العربي، يشكو من عناية الصحية وما زال الوطن عن العرب يعتمد على الخارج للحصول على أقصى من نصف حاجته من الغذاء، ولا يستخدم إلا عشر قواه البشرية في وقت يتزايد فيه اعتماده على اليد العاملة الأجنبية. وفي الوقت ذاته يشكو من نزيف حاد في طاقاته العلمية والتقنية ".
وبعد أن ذكر التقرير أرقاما عن انخفاض الإنتاج الزراعي، قال: ولم تأت الصحوة في المنطقة العربية إلا في بداية الثمانينيات، لتبرز هذه الحقيقة الفاجعة، وهي: أنها اليوم، وبالقياس إلى الدول النامية، أبعد مناطق العالم تخلفا من حيث الإنتاجية، وأبلغها عجزا غذائيا، وأكثرها انغماسا في التبعية، وبالتالي أسرعنا تأثرا بالأزمة العالمية الغذائية، ولم يعد خافيا على أحد، أن سلاح الغذاء هو اليوم من أخطر الأسلحة، وأشدها تعقيدا لحرية القرار الاقتصادي والسياسي، بحكم طبيعة إنتاج الأغذية وأسواقها، التي تهيمن عليها قلة احتكارية، لم تتردد في التلويح بإمكان استخدام هذا السلاح لتنفيذ سياستها الخارجية.
وعلى الرغم من أن هذا التقرير يثبت فشل اتجاهات التنمية الخالية، التي تعتمد على التغريب بشقيه الماركسي والرأسمالي، إلا أن أغلب علماء الاجتماع لا يعدمون تبريرا المثل هذا الفشل ويشاركون بذلك في عملية التنمية المزيفة. فمثلا كثيرا ما نسمع عن أن النمو السكاني المتزايد يساهم بشكل كبير في إفشال مجهودات التنمية. والحقيقة أن هذه دعوى زائفة "فالدول الإسلامية ككل، تجمع بين معدلات النمو السكاني المنخفضة مثل "تركيا"، ومعدلات النمو السكاني المرتفع "مثل مصر وبنجلاديش"، وإذا كانت مصر وبنجلاديش حالة سيئة في مجال النمو، فإن الوضع في تركيا التي تنهج نهجا غربيا لا تبشر بأي تقدم في هذا المجال أيضاً، بل أن الواقع هو أن الديون الأجنبية قد أثقلت الاقتصاد التركي، وجعلته اقتصادا مريضا شأنه في ذلك شأن اقتصاد بنجلاديش "(187).
ويتغاضى كثير من علماء الاجتماع، عن الهدف الأساس الذي يوجه عمليات التنمية في الدول الإسلامية، حيث كان التركيز فقط على النواحي المادية من التنمية، وأهملت النواحي الروحية إهمالا كاملا، وهذا أمر طبيعي ما دامت الدول الإسلامية تسير في الطريق الرأسمالي، أو الماركسي. والحقيقة أنه مهما بلغ التقدم المادي، فإنه يظل ناقصا، ولا يمكن أن يشبع حاجة الإنسان، ما لم يواكبه إشباع لمطلب الإنسان الروحية. "فأي جهد يخلو من إرضاء الجانب الروحي في الإنسان " لا يخلِّف وراءه إلا إحساس بعدم الرضا، رغم كل مظاهر التقدم المادي، التي يمكن تحقيقها(188). وغياب البعد الروحي، أحد أهم الأسباب ، التي أدت إلى تعثر عمليات التنمية في العالم الإسلامي، فلا يمكن قيام تنمية متقدمة باستمرار، ما لم يمكن مجتمع التنمية نفسه "متمتعا بالحساسية الأخلاقية النابعة من أداء الواجب، لأنه واجب، ومراعاة الضمير، والبعد عن السلبيات العديدة، التي تنخر في عملية التنمية نخر السوس في العظام المتهالكة، كالانتهازية، والأنانية، والوصولية، والرشوة، وعدم تقدير المسؤولية، والبحث عن الثراء الحرام، فهي سلبيات لا يمكن أن تتحقق معها تنمية مجتمع ما مهما توافرت له سائر العناصر الاقتصادية والاجتماعية " (189).
ونظرا لأن عمليات التنمية في الدول الإسلامية لم تعط الجوانب الروحية في الإنسان أي اهتمم، فإن السلبيات السابقة، تجمعت في الشعوب الإسلامية، لتكون أهم العوائق في وجه التنمية. ولفرط وجود عنصر الفساد في كثير من الدول الإسلامية، وغيرها، فقد أطلق عليها تعبير الدول "الهشة "، فهناك عدد لا بأس به من الدول الإسلامية في يومنا هذا تتفشى فيها الرشوة، والاختلاس، والغش في الأموال الحكومية في صورة مرتبات وهمية، ونفقات سفر لكبار الموظفين، بين الأمور غير الواضحة للعيان، تصبح الرشوة أمرا علنيا، بعيدا عن السرية، ونتيجة لهذا الوضع فإن الحصول على خدمات غير قانونية.. يعتبر أمرا سهلا بعد تقديم الرشاوى. أما الأعمال الهامة والمشروعة، فإنها تعرقل وتؤجل إلى ما لا نهاية، إذا لم يتقاض الموظفون المعينون الرشاوى (190).
إن التنمية التي ينشدها الإسلام هي التي توازن بين مطالب الإنسان المادية والروحية، وتكون منطلقة من الإسلام نفسه، وبذلك تتجنب الانغماس في المادية، كما أنها لا تتطرف تطرفا روحيا كما تطرقت الهندوسية، والبوذية. ورهبان المسيحية، وبعض الصوفية من المسلمين. وتستهدف مثل هذه التنمية: "إقامة مجتمع يعتمد في بنائه على وجود بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية، تغذي مطالب الإنسان المادية والروحية على حد سواء(191). والحقيقة أن قضية التنمية تقود إلى قضايا أخرى، مثل قضية التجزئة، وهي العملية التي فرضها الأعداء على الأمة الإسلامية، وقسمت على ضوئها إلى دويلات كثيرة، بحيث يسهل السيطرة عليها. وهي السياسة المعروفة بسياسة فرق تسد. والدول الإسلامية الآن تفقد أي نوع من أنواع التكامل بينها، بل إن العلاقات فيما بينها كثيرا ما يشوبها التوتر، بل والنزاع بسبب الخلاف على الحدود، أو نتيجة سياسة معينة. وهذا أمر يزيد من ضعف الأمة الإسلامية، وخرمها استخدام إمكانيتها كاملة، وقد حدث هذا بعد أن كانت الدولة الإسلامية واحدة، تعيش في ظل الخلافة، وتحكم الشرع(192).
ويتطلب الوضع الحالي من عالم الاجتماع المسلم، دراسة عميقة يبتعها وضع الخطط المستقبلية، التي تكفل التكامل بين الدول الإسلامية، في جميع المجالات، بحيث يؤدي ذلك إلى وحدة القرار، ووحدة السياسة، والتكافل والتكامل الاقتصادي، وغيره.
ولكي يضمن عالم الاجتماع المسلم أن يكون التغير الاجتماعي لا يخرج عن الإسلام، فإنه لا بد له من تخطيط شامل على كل المستويات يستهدف أمرين، هما:
(أ) التخطيط الداخلي: وهو عبارة عن الجهود المبذولة لتطوير المؤسسات الاجتماعية، والحفاظ عليها في داخل الأمة الإسلامية ذاتها.
(ب) التخطيط الخارجي: ويستهدف نشر الإسلام عن طريق الدعوة بين المجتمعات والأفراد التي لا تدين بالإسلام(193).
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إن المسلم إذا أراد صياغة علم الاجتماع صياغة إسلامية، فإن عليه أن يبدأ من المنطلقات الأساسية، والمحور الأساس في الإسلام، وأعني به العقيدة، أو نظرة الإسلام للكون والحياة والإنسان، لأن عدم البدء من هذا المنطلق، يعني وجود نوع من التلفيق، وذلك "بأن نستخدم المفاهيم الغربية نفسها، مع تغيير المصطلحات الدالة عليها، أو مع محاولة متعنتة لإثبات أن كل مفهوم من هذه المفاهيم له أصل في الإسلام، يبرر الأخذ به. إن هذا المنهج يؤدي - بطبيعة الحال - إلى العودة لاستخدام الأنساق الغربية الكلية، وإن تغيرت المصطلحات والأسماء، أو حيثيات القبول. والخطر من التلفيقية، يعني أن نضيف إلى ترسانة المفاهيم والأنساق الغربية، مفاهيم تتعلق بالإيمان بالله مثلاً، أو بالأسرة، أو بعض القيم، ونتصور أننا قد حللنا بهذا الإشكالية الصعبة، ناسين أن المفاهيم الدنيوية تتولد عنها في الأنساق الفكرية الغربية، مفاهيم فرعية في كل مناحي المعرفة الاجتماعية، تتعارض تماماً مع المفاهيم الفرعية المتولدة عن الإيمان بالله تعالى(155).
الهدف الأول:
الهدف الأساس في الصياغة الإسلامية، هو أن يكيِّف علم الاجتماع نفسه في ظل مبدأ الإيمان بالله تعالى، وهذا يعني عدة أمور تكوِّن في مجملها التصور الإسلامي العام:
(أ) إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا الكون بكل ما فيه من أشياء، وظواهر، وأحياء، بما فيها الإنسان. فالكون كله يبتدئ خلقه ووجوده من الله، وينتهي مصيره إليه. وهو المدبر والمهيمن عليه. ويعني هذا: "أن الطبيعة لم تخلق نفسها، ولم توجد بنفسها. بل أوجدها الله. وهي تسير على سنن مطرده، وفق نظام مترابط الأجزاء، والله الذي خلقها هو المقدر لسننها ونظامها"(156).
(ب) الإيمان بالغيب، حيث ينقسم العالم إلى قسمين، يمكن التمييز بينهما، ولكن لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. هما: عالم الغيب، وعالم الشهادة، ويتصل عالم الغيب بذات الله جل وعلا، وصفاته والحياة الآخرة، والملائكة، والجن، والروح.
بينما يعني عالم الشهادة "كل ما على الأرض، وكل ما في الكون من أشياء وأحياء، وأحداث، وظواهر، وعلاقات، تشكل نظام الكون المادي، في أرضه وسمائه، وفي مادته وفضائه، وفي اجتماع المخلوقات وفي انفرادها(157). ولا سبيل إلى معرفة علام الغيب إلا عن طريق الوحي، وعلى هذا فليس العقل الإنساني أداة وحيدة للوصول إلى الحقيقة، وإنما هناك طريق آخر هو الوحي، له ميدانه الخاص، لا يستطيع العقل بلوغه لوحده. "فالعقل أداة الوصول إلى حقائق الطبيعة. وهو معرض مع ذلك للخطأ. والوحي أداة معرفة عالم الغيب - ما وراء الطبيعة "(158).
(ت) الإيمان بأن الله هو المشرِّع للإنسان. فهو الذي قدر للطبيعة سننها، وهو أيضاً الذي وضع للإنسان عن طريق الوحي مقاييس الخير والشر، وحدد المعالم الثابتة للأخلاق والحقوق.
(ث ) الإيمان بأن الله اصطفى بعض خلقه من البشر، ليبلِّغ شرعه، وهؤلاء هم الأنبياء، ومنذ بداية خلق الإنسان، بعث الله أنبياء كثيرين ليبلغوا الناس شرع الله. وقد ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، فهو خاتم الأنبياء، ورسالته خاتمة الرسالات.
(ج ) الإيمان بأن الإسلام هو خاتمة الرسالات. وهو رسالة عالمية موجهة إلى كافة البشر، كما أنه رسالة تامة ومكتملة، وصالحة لكل زمان ومكان.
وفي إطار هذا التصور الإسلامي يمكن أن نجمل بعض المبادئ الأساسية التي تشكل إطاراً نظرياً لعلم الاجتماع الإسلامي. وتتعلق هذه المبادئ بطبيعة الإنسان، وطبيعة النظام الاجتماعي، وطبيعة التاريخ البشري.
أولاً- طبيعة الإنسان:
1- قال الله سبحانه وتعالى: ((الذي أحسنَ كلّ شيءٍ خلقه، وبدأ خلقَ الإنسان من طينٍ. ثم جعل نسْله من سُلالةٍ من ماءٍ مهين. ثم سوّاه ونفخ فيه من رّوحِه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون )) [السجدة:7-9].
فالإنسان في أصله مخلوق من طين، ونفخ الله فيه من روحه، وقد بينت هذه الآية ازدواج الطبيعة الإنسانية، فهو من طين الأرض، ومن نفخة الله فيه من روحه، ويعني هذا وجود نوازع الخير، ونوازع الشر في نفسه. ويقول سيد قطب: "إن هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة، مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتجاه، ونعني بكلمة مزدوج على وجه التحديد، أنه بطبيعة تكوينه - من طين الأرض، ومن نفخة الله فيه من روحه - مزود باستعدادات متساوية للخير والشر، والهدي والضلال، فهو قادر على التمييز بين ما هو خير، وما هو شر، كما أنه قادر على توجيه نفسه إلى الخير وإلى الشر سواء، وأن هذه القدرة كامنة في كيانه. يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة: ((ونفْسٍ وما سوَّاها. فألهمها فُجورها وتقواها )) [الشمس:8]. ويعبر عنها بالهداية تارة: ((وهَديناه النَّجدين )) [البلد:10]، فهي كامنة في صميمه في صورة استعداد.. والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية، إنما توقظ هذه الاستعدادات، وتشحذها هنا أو هناك، ولكنها لا تخلقها خلقاً، لأنها مخلوقة فطرة، وكائنة طبعاً، وكامنة إلهاماً(159).
وينفي ما سبق، أن تلحق بالإنسان خطيئة موروثة، أو أنه آثم بالضرورة.
2- إن وجود نزعات الخير، والشر في الإنسان، تعني وجود شيء آخر، وهو وجود الإرادة الحرة فيه، والقدرة على اتخاذ القرار، "وهذا يعني أن النزعات في الإنسان ليست جبرية، بل إن الإرادة الإنسانية ذاتها هي التي تحد العمل الإنساني، في أي من الاتجاهين. وينبذ هذا "المبدأ" أيضاً، كل أنواع الآراء الجبرية الأخرى، مثل الجبرية الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو البيولوجية "(160).
وهذه الإرادة الحرة، هي ما تميز الإنسان به عن بقية المخلوقات،وقد أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ((ألم تر أنّ الله يسجُد له مَنْ في السماوات ومن في الأرضِ والشمسُ والقمرُ والنُّجوم والجبال والشجرُ والدّوابُّ وكثير مِن الناس، وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب )) [الحج:18]، فكل ما في الوجود يسجد لله ويطيعه. وأما الناس فكثير منهم يسجد ويطيع، وكثير يعصون ولا يسجدون. وهذا نتيجة للإرادة الحرة، التي شاء الله أن يمنحها للإنسان.
وفي مقابل هذه الإرادة الحرة، التي منحها الله للإنسان، جعله مكلفاً مسؤولاً. فقد كلفه وأمره بأوامر ليبتليه ويمتحنه. وجعله مسؤولاً مسؤولية شخصية عن أعماله: ((وكلَّ إنسانٍ ألزمناه طائره في عنُقه )) [الإسراء:13]، وقال: ((ولا تزِرُ وازرةٌ وزر أخرى )) [الأنعام:164].
3 - منح الله الإنسان القدرة على التعلم وطلب المعرفة، حيث ميزه بحواس تعينه على تكوين خاصة العقل والتفكير، التي تمكنه من العلم وإدراك الحقائق الخارجية: ((والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون )) [النحل:78]، فمعنى الآية أن عدم العلم في حال الولادة، يتحول إلى علم بواسطة السمع والأبصار والأفئدة. ويتميز الإنسان أيضاً بقدرته على التعبير، والبيان، عن علمه وأفكاره: ((خَلق الإنسان، علّمهُ البيان )) [الرحمن: 3-4]، كما أن علم الإنسان قابل للزيادة دائماً، وبإمكانه ابتكار أمور لم يعهدها من قبل(161).
4- لقد كرم الله الإنسان وفضله على كثير ممن خلق، فقد كرمه بأن خلقه على أحسن تقويم، وكرمه بالاستعدادات التي أودعها فطرته، وبها استأهل الخلافة في الأرض، وكرمه بتسخير القوى الكونية، له، بأن أسجد له ملائكته، وبحلول اللعنة على إبليس، الذي أبى واستكبر عن السجود لآدم، كما أن الله سبحانه وتعالى أعلن هذا التكريم في كتابه: ((ولقد كرّمنا بني آدم، وحملناهم في البرِّ والبحرِ ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثيرٍ مِّمَّنْ خلقنا تفضيلاً )): [الإسراء:70].
هذه نظرة إجمالية إلى رأي الإسلام حول حقيقة الإنسان. وهي نظرة توحي بالأسس، التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الاجتماعي، حيث الاعتبار الأكبر للخلق، والخير، والفضيلة.
ثانياً- طبيعة النظام الاجتماعي:
لقد أوجد الله المجتمع البشري، لنفس الحكمة التي أوجد لها الإنسان كفرد، وأوجد لها العالم، فغاية وجود المجتمع البشري، تتفق وتتمشى مع الغاية من الوجود الإنساني - بخاصة - من ناحية، ومع غاية وجود العالم -عامة - من ناحية أخرى، فالله سبحانه وتعالى القدير على كل شيء، لو شاء لجعل الإنسان مخلوقاً فردياً، لا يعيش في مجتمع بالضرورة. ولكنه شاءه اجتماعياً، تحقيقاً للحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، وهي الابتلاء، حيث يمتحن الله الناس بالناس في المجتمع، عن طريق التفاعل بينهم، المتمثل في العلاقات والمعاملات الاجتماعية بشتى صنوفها(162).
ويتكون المجتمع، أي مجتمع، من أفراد من البشر، إضافة إلى القوانين، والأفكار، والمشاعر، والعقيدة، ويضاف أيضاً إلى ذلك القيادة المجتمعية، والغاية من كل فعالية يقوم بها المجتمع(163).
ويذهب أحد الباحثين إلى أن المجتمع يتكون من أساسين.
الأول: هو ما يتمثل في العوامل البيئية والجنسية، وما يتبعها من تأثير متبادل بين الإنسان والبيئة.
والثاني: ويعتبر جوهرياً في تكوين شخصية المجتمع: هو الإرادة الجمعية الحرة للمجتمع، التي يختار بها المجتمع منهج الحياة، وشكل البناء الاجتماعي، والعقيدة التي ينبثق منها ذلك البناء(164).
ويذهب آخر إلى أن المجتمع "هو مجموعة من الأفراد، يربط بينها رابط مشترك، يجعلها تعيش عيشة مشتركة. وتنظم حياتها علاقات منتظمة معترف بها فيما بينهم. قد يكون هذا الرابط الأرض، وما يقوم عليها من مصالح مشتركة، كالمجتمع السويسري. وقد يكون الجنس والأصل، وما يتصل به من لغة، وثقافة، وتاريخ، ومبادئ، وهو المجتمع القومي. وقد يكون المبادئ السائدة والمعتقدات المشتركة، وما يتولد عنها من أفكار وعواطف وسلوك، وهو المجتمع العقائدي كالمجتمع الإسلامي "(165).
ونخلص من هذه التعريفات، إلى أن الأجزاء الرئيسة التي تكون المجتمع هي: جمع من الأفراد والقوانين، ويدخل فيها العقائد، والمشاعر، والأفكار.
وإذا أردنا أن نعرف بداية المجتمع، فإن الله سبحانه ذكر أن المجتمع الإنساني بدأ برجل وامرأة، هما آدم وحواء: ((يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا )) [الحجرات:13]. وتوضّح هذه الآية، أن ذرية آدم وحواء تكاثرت منهما وتطورت إلى شعوب وقبائل، وهو ما توضحه الآية الأخرى: ((يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة، وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيراً ونساءً )) [النساء:1]، ولم يقتصر الأمر على الشعوب والقبائل، بل حتى هذه تطورت في نهاية الأمر، إلى ما يسمى بالأمم، حيث تعتبر العقائد والأديان هي المميز بينها. "وبالرغم مما طرأ على المجتمع والجماعات والقبائل، والأمم من تطور فكري، فقد بقيت الأسرة التي تبدأ برجل وامرأة وذريتيهما الهيكل البنائي لكل مظاهر هذا الوجود، وهذه حقيقة عامة، ليس للإنسان حاجة إلى زيادة تطويرها... وقد بقيت الأسرة نفسها حجر الزاوية في النظام الاجتماعي. رغم ما طرأ عليها من أشكال مختلفة، فأصبحت متشعبة، أو منشطرة، أو متعددة الأنساب والزيجات "(166).
وقد اقتضى وجود الفرد في محيط اجتماعي، سواء كان داخل أسرته أو خارجها، وجود صلات وعلاقات وارتباطات. فلم يكن المجتمع ركاماً من البشر، ولا حشداً متراصاً من الأعداد، ولكنه يتجاوز ذلك إلى علاقات العمل النامية، والصلات الناشئة بين أفراده، سواء كانت صلات ودية، أو صلاة عدائية. وإذا عدنا إلى قصة الإنسانية الأولى، وجدنا: أن آدم خلق لتكون معه زوجه، وليكون معها، واقتضى وجودهما مشاركة وجدانية، تمثلت فيما نشأ بينهما من سكينة، وطمأنينة، ومبادلة عاطفية في السراء والضراء. وقد أشار القرآن إلى مشاركة آدم وحواء في المسرة في قوله تعالى على لسانهما: ((دعوا الله ربّهُما لئِنْ آتيتنا صالِحاً لنكوننَّ من الشاكرين )) [الأعراف:89]، وإذا مشاركتهما فيما عرض لهما من انتكاس ((قالا: ربّنا ظلمنا أنفُسنا وإن لم تغفرْ لنا وترحمْنا لنكوننَّ مِن الخاسرين )) [الأعراف:23] (167).
من أوائل الصلات العدائية، قصة ابني آدم، حيث قتل أحدهما الآخر حسداً وظلماً، لأن الله لم يتقبل منه قربانه، وتقبل من الآخر. ولأن النفس الإنسانية بطبيعتها لها نزعات ورغبات، وإرادة حرة مختارة، فلا بد من حدوث الاختلاف والاجتماع، والتناقض والتصالح.
وإن من الأمور البدهية حاجة المجتمع إلى قانون ينظم العلاقة بين الأفراد، ويقضي على النزاعات والخصومات، ويحكم بالعدل. وقد اتبع آدم عليه السلام وزوجه القانون الإلهي، وهو الدين الحنيف. إلا إن ذريته من بعده، لم يستمروا على نفس المنوال، بل كثيراً ما انقادوا خلف رغباتهم وشهواتهم. وقد أوغل كثير منهم في الانحراف إلى درجة بعيدة، وقد تداركهم الله برحمته، فأرسل لهم رسلاً منهم، مبشرين ومنذرين. وهكذا كانت علاقة البشر مع دين الله في شد وجذب، حيث يبتعدون تارة، ويقتربون منه تارة أخرى.
والحقيقة الباقية من حقائق المجتمع، أنه بحاجة ماسة إلى قيادة وسلطة تعمل على نشر الدين، أو القانون الذي يحكم العلاقات بين الناس، وطبيعي أن يكون القادة من البشر أنفسهم، سواء كانوا أنبياء ورسلاً، أو أشخاصاً عاديين "وفي الوقت الذي تنبذ فيه القوانين التي أوحى الله إلى البشرية بواسطة أنبيائه كلّ أنواع الممارسات البغيضة، وعدم عدالة التوزيع الاقتصادي، فقد سن الإنسان قانوناً يعكس ي العالم رغبات الدوائر الأقوى في المجتمع، وتنحو إلى إعلاء كلمة الظلم، بل وتميل إلى تركيز السلطة في يد قلة من الأيدي المتغطرسة"(168).
ثالثاً- طبيعة التاريخ البشري:
"إن حركة التاريخ هي حركة البشر القاطنين على سطح هذا الكوكب، بكل ما يعتمل في نفوسهم من دوافع ورغبات وصراعات، وكل ما يقع منهم وعليهم من تجاذب وتدافع وتصادم، من خلال حيز الزمان والمكان، والتيار الذي يدفع الجميع. ومن ثم فكل مكونات النفس البشرية داخلة في حركة التاريخ، وكل الصدامات والصراعات داخلة في حركة التاريخ: بحث الإنسان عن الله، وبحثه عن الطعام، وبحثه عن الحق والعدل، وبحثه عن الجمال، وسعيه إلى الغلبة والسيطرة، وسعيه لتسخير كنوز السماوات والأرض، وسعيه إلى الاستحواذ والملك. هذه هي حركة الإنسان في الأرض. . وهي تسير في خطين اثنين: خط الهدى، وخط الضلال "(169).
وقد شهد التاريخ - على طول حركته - تدافعاً وصراعاً بين الحق والباطل، وكانت الأنظمة العادلة، في تعاقب مستمر، مع الأنظمة الظالمة في لمجتمع البشري، فآدم وحواء كانا على حق، أي مسلمين، وكذلك أولادهما من بعدهما، ولكن مع طول العهد انحدر كثير من ذريتهم نحو الضلال، فأصبح الناس أمتين: أهل الشرك والضلال، وأهل الحق والإيمان، ولكن الله سبحانه أرسل رسلاً لإعادتهم نحو الحق والهدى. وغالباً ما يتعرض الرسل للتكذيب ولاستهزاء والسخرية من قبل لفئات المترفة والحاكمة، ويناصبونهم العداء، وقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، ومع ذلك لم يؤمن معه إلا قليل، مما يوضح شدة المعركة التي يخوضونها.
وكثير من الرسل هيأ الله لهم نشر دعوتهم، وإقامة دعائم الدين، ولكن مع طول العهد ينسى خلفهم، وينحرفون عن الشريعة التي جاءوا بها. ثم يبعث الله رسولاً آخر، يجدد المعالم، التي انمحت، ويقيم شرع الله. وظل الناس على هذا الحال، حتى بعث الله رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم بالشريعة النهائية والرسالة الخاتمة، ولا يعني هذا أن صراع الحق والباطل قد انتهى، ولكنه يعني أن الله سبحانه ارتضى هذا الدين لناس، حيث أكمله وأتمه، وعليهم أن يتبعوه، ولا يتبعوا السبل الباطلة، فتحيد بهم عن سبيله. ويعني هذا أيضاً أن مهمة نشر هذا الدين، تقع على عاتق أتباعه المسلمين.
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : "الجهاد ماض منذ أن بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال.. "(170). ويوضح هذا الحديث أن نشر الإسلام يحتاج إلى مشقة وعناء، نظراً لما يواجهه من قوى باطلة وضالة.
ففي نفس المسلم هناك مواجهة بين الفجور والتقوى، وبين الشيطان والإنسان.. وفي المجتمع المسلم مواجهة بين المعروف والمنكر، وبين أهل العدل وأهل البغي.. وخارج المجتمع المسلم، مواجهة أخرى، بين الكفر والإيمان، بين حزب الله، وحزب الشيطان.
"فإقرار منهج الله في الأرض لا يتحقق بخارقة، وإنما يتحقق بالجهاد، وبقدر ما يبذل من جهد روحي ومادي، جهد التوكل واليقين، وجهد السلاح والدفاع "(171). وعلى كل حال. فإن حركة التاريخ كما يصورها لقرآن "هي حركة اجتماع، وتشتت، أساسها الأمة المسلمة، التي تشعبت عنها الوثنيات والمعتقدات الباطلة، بأشكالها المختلفة، وحركة هداية وضلال تتمثل في الاستعمال الصحيح أو السيئ للإمكانيات المتاحة للإنسان في نفسه، والأشياء من حوله، وهي حركة يرشدها الله بالنبوات وبالوحي، كلما انحرفت عن مسيرتها الصحيحة، بالبعد عن مصادر العلم والهداية الصحيحة والوقوع في أسر الضرورات "(172).
إن ما أوردناه فيما سبق حول الإيمان بالله تعالى، وحول طبيعة الإنسان والنظام الاجتماعي، والتاريخ البشري، يعتبر المنطلقات الأساسية لعلم الاجتماع النظري، أو البحث الذي يعنى بتلمس مبادئ الطبيعة البشرية، والسلوك البشري. ومع أن التوقف عند حد المعرفة النظرية ليس هدفاً لعلم الاجتماع الإسلامي، بل يجب تطبيق مثل هذه المعرفة لتعزيز الإسلام في نفوس الأفراد والمجتمعات، إلا أننا لا نتصور عالماً للاجتماع، يشارك في عملية نشر الإسلام، وليس لديه أي معرفة بطبيعة الكون والنفس الإنسانية والنظام الاجتماعي، وحركة التاريخ(173).
ولعلنا هنا نتذكر على الفور الحكمة من القصص الذي قصه الله في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم ، حيث لم يقصه الله سبحانه وتعالى لمجرد إثبات حادثة وقعت، ولكن الهدف الأساس، والذي توحي به مجموع القصص، هو تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقلوب أمته من بعده على الحق، وكذلك أخذ لعظة والعبرة من أحوال الأمم السابقة، ومحاولة تلافي الأخطاء التي وقعت فيها تلك الأمم، وقد قال سبحانه وتعالى مبيناً ذلك: ((وكُلاًّ نقُصُّ عليك مِن أنباء الرسلِ ما نُثبّتُ به فُؤادك، وجاء في هذه الحق وموعِظةٌ وذكرى للمؤمنين )) [هود:120]. وقال تعالى: ((لقدْ كان في قصصهم عِبرةٌ لأولى الألباب )) [يوسف:111]، وكذلك كل معرف نظرية لا تكون ذات قيمة، إلا إذا طبقت على أرض الواقع، وخدمت أهداف الإسلام.
ومن ناحية أخرى، فإن مثل هذه المنطلقات الأساسية، توجه نظرية علم الاجتماع الإسلامي، التي تفسر السلوك البشري، بعيداً عن الوجهة الحالية للنظريات الغربية، فلأنها تحسب لجميع العوامل حسابها، فإنها تسلك مسلكاً وسطاً، ليس فيه تطرف أي جهة، بحيث تستطيع تفسير عمليات الاجتماع والتعاون، والصراع والتنافس، كما أنها تشير إلى وجود الإنسان المادي والروحي، وتركز أيضاً على الإرادة الحرة المختارة، التي تعتبر البداية المباشرة لعمليات الاستنتاج، واتخاذ القرار، كما أن لديها القدرة على تفسير التغير في السلوك الفردي، وفي النظام الاجتماعي(174)، وهذا على خلال النظريات الغربية، التي التزمت بمواقف متطرفة، مما أفقدها القدرة على تفسير المتناقضات الأساسية في العلاقات الإنسانية، "فعلى سبيل المثال عجزت الآراء، التي تدور حول نظرية مصغرة، عن تفسير الأنماط المكبرة، كما تعجز تلك الآراء التي تهتم بالصراع عن تفسير أنماط الوفاق، ولا تزال الآراء التي تفسر الجريمة غير قادرة على تفسير التلاؤم، لأن جميع هذه الآراء تركز على الإنسان، باعتباره كائناً مادياً، وتهمل وجوده الروحي "(175).
إن الهدف الأول من أهداف الصياغة الإسلامية هو أن يسير علم الاجتماع في ضوء المعتقدات الإسلامية الأساسية، التي تكون نظرة الإنسان العامة للوجود، ولا يعني هذا أن هذه المعتقدات هي موضوع علم الاجتماع، ولكنه يعني أنها تكون حاضرة في ذهن عالم الاجتماع، عند بحثه لأي قضية داخلة في حدود موضوع علم الاجتماع، وهو "واقع المجتمعات البشرية في حدود كونها عالماً مشهوداً يمكن ملاحظته واستخراج خصائصه، وقوانين حركته، وتبدله "(176).
الهدف الثاني:
يهدف علم الاجتماع الإسلامي إلى قياس مدى اقتراب المجتمعات الإسلامية، أو بعدها عن الإسلام، وهذا هدف مرتبط ارتباطا أساسيا بالهدف السابق، حيث إنه لا يمكن فصل العقيدة عن الشريعة، أو النظام في الإسلام، فبينهما علاقة وطيدة، تشبه تماما علاقة جذور الشجرة بالشجرة نفسها، فمن المستحيل قيام النظام الإسلامي بدون العقيدة الإسلامية، كما أنه من الخطأ وصف أي مجتمع بأن عقيدته إسلامية، كما أنه من الخطأ وصف أي مجتمع بأن عقيدته إسلامية، وهو لا يطبق الشريعة الإسلامية في حياته.
ويعني ما سبق أن نظام الإسلام نظام شامل، يتناول جميع شعب الحياة، وينظم علاقات الإنسان مع نفسه ومع غيره. ويبتر الإسلام حين، يفهم على أنه مجرد طقوس وعبادات وشعائر يؤديها الفرد بصيغ معينة، ولكن الإسلام طاعة شاملة لحكم الله في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والأسرية والقانونية والتربوية، في الحرب والسلم، وفي كل علاقة بين شخصين. فكل نواحي الحياة لها حكم في الإسلام، إما ينص من كتاب أو سنه، أو باستنباط من نص، أو بقاعدة عامة.
بل إن لفظة الإسلام نفسها، تدل على هذا المعنى، فهي تعني "الانقياد والامتثال لأمر الآمر، ونهيه، بلا اعتراض ". وقد سمي ديننا بالإسلام، لأنه طاعة الله، وانقياد لأمره ونهيه، بلا اعتراض (177).
ولفظ العبادة مثل لفظ الإسلام، لا يمكن قصرها على الشعائر فقط، ولكنها تعني طاعة الله سبحانه وتعالى، وتنفيذ أمره، وهي بالتحديد كما عرفها ابن تيمية: "اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال ، والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة، والزكاة، والصيام،والحج، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وبر الوالدين ،وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد للكفار والمنافقين، ولإحسان للجار، واليتيم، والمسكين، وابن السبيل، والمملوك من الآدميين والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة، وأمثال ذلك، من العبادة "(178).
إن المسلم لا يجد أي مشكلة في معرفة شمولية الإسلام، ولكن المشكلة في النظرة العامة السائدة عند بعض المثقفين، الذين درجوا على رؤية العالم محصور بين رؤيتين أيديولوجيتين هما : الاشتراكية والرأسمالية، ولو أنهم بذلوا أقل الجهد في فهم الإسلام، لأدركوا أن له رؤية متكاملة وشاملة، ليست بالاشتراكية ولا بالرأسمالية، بل تختلف عنهما، حيث تسلك مسلكا وسطا بالنسبة للمسائل الاجتماعية، كما أنها رؤية سابقة، برزت إلى الوجود قبل إن توجد الرأسمالية والاشتراكية، وهي ليست فكرا بشريا، ولكنها وحي إلهي.
"ومسألة تنظيم الإسلام للحياة الاجتماعية في جوانبها المختلفة... كانت نتيجة للوحي القرآني، ولوقائع السيرة النبوية، أكثر مما كانت ثمرة للاجتهاد النظري الفقهي الذي اتسعت آفاقه على تعاقب الأيام. بل إن نظريات الفقهاء والأئمة في الأحوال الشخصية، والنظم العائلية، والحقوق الدولية، والتنظيمات السياسية العسكرية، والتفرعات المالية والاقتصادية، ليست إلا امتدادا لعض الوقائع الجزئية، التي حدثت على عهد الرسول عليه السلام. وكان له فيها قول أو تنبيه أو إرشال أو تقري "(179) والحقيقة أنه ليس من الغلو التأكيد على أن أي واقعة جديدة في الحياة الإنسانية المعاصرة كلها، لها بشكل أو بآخر، أصل في الكتاب أو السنة، أو وقائع السلف الصالح، أو كليات الإسلام وقواعده العامة.
ويشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام على تشريع للأسرة، يوضح علاقات أفرادها ببعضهم، كما يشتمل على نظام اقتصادي مالي، يحدد طرق الكسب والإنفاق، وينظم العلاقات المالية بين الناس، ويحدد مفهوم الملكية وبين قيودها. كما يتعرض لأسس التكافل بين أفراد المجتمع.
كما يشتمل على نظام سياسي أو نظام الدولة، يتضمن مبادئ عامة للحكم والسياسة، وبيان لعلاقة الراعي الرعية، وحقوق الرعية مسلمة كانت أو غير مسلمة، وقواعد السلم والحرب. كما يشتمل على نظام للعقوبات يكفل للمجتمع السير في الطريق السليم، الذي شرعه الله لهم(180).
وجميع التشريعات الإسلامية السابقة، تقف موقفا وسطا بين الانغلاق والانفتاح، بين التضييق والحجر، وبين الحرية غير المحدودة. فمنهج الإسلام يقوم على الضبط والتهذيب، لا على الكبت، ولا على الانفلات.
ولا شك أن الموقف الوسط هو الأمر الطبيعي، الذي نوفق بين الأطراف المتنافرة، "وبما أن الإسلام هو القانون الطبيعي للتعامل، فإذا لم يطبقه مجتمع إسلامي ما، فإنه يتجه آليا إلى الظلم والانحدار. وحتى لو طبّق هذا القانون مجتمع غير مسلم فإنه ينتعش(181) ".
وسنعرض فيما ياي عرضا موجزا لتشريعات الإسلام العامة في الأمور الاجتماعية السابقة، حيث تعتبر هي المقياس، الذي نقيس على ضوئه مدى بعد المجتمعات الإسلامية أو قربها منه، فهي تشكّل الصورة المثالية للمجتمع الإسلامي، فكل انحراف عن هذه الصورة يعني ابتعادا عن الإسلام. وهذا ما اقترحه أحد علماء الاجتماع المسلمين حيث قال : "كما نريد أن تمثل هذه الصورة ما يسميه علماء الاجتماع: النمط المثالي، الذي يمكن استخدامه لقايس مدى انحراف المسلمين في تصرفاتهم عن الإسلام "(182).
والحقيقة أن هذه الصورة مجردة هكذا، ناقصة، ولا تكون مكتملة إلا حينما تكون مصحوبة بالقيم الأخلاقية، التي أمر بها الإسلام، والتي يكون لها أكبر الأثر في تطبيق شريعة الإسلام في كل أمر.
ولعل من أهم هذه القيم: التقوى، الاستقامة، والصدق، ولإصلاح، الإيثار، التعاون، والصبر. ونلاحظ أثر هذه القيم خلال الحياة العامة، فمثلا السبب المباشر في اللجوء إلى القوانين الوضعية، بدل الشريعة، هو فقدان التقوى، التي هي أهم قيمة أخلاقية في الإسلام، وتعني: اتقاء عذاب الله بطاعته، وتنفيذ أوامره. وإلاّ كيف يفسر لجوء جماعة مسلمة إلى الحكم بغير الإسلام، ومخالفته في أمور أساسية؟.
والذي رشك فيه أيضا، أن صورة المجتمع الإسلامي المثالي، لا يمكن فصلها عن التقوى وسائر الأخلاق الإسلامية. بل إن لهذه العبادات كالصوم، والصلاة، والزكاة، والحج، ولا يمكن فصلها عن التقوى وسائر الأخلاق الإسلامية. بل إن لهذه العبادات التي يظن أنها فردية للوهلة الأولى، آثارا اجتماعية.
وقد وصف الله تعالى الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر: ((إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر )) (العنكبوت: 45)، وذلك نتيجة لما تزرعه في نفس المسلم من حب الطاعات، ومن كراهية المعاصي. ونظرا لأن المسلمين يؤدون الصلاة في جماعة خمس مرات في اليوم، ويجتمعون لأداء الجمعة في كل أسبوع، فإنها تنشئ بين المسلمين المحبة والإخاء، وتقوي الروابط بينهم. كما أنها تعلمهم على النظام والانضباط، والمحافظة على الأوقات.
وأما الصيام، فغن آثاره الاجتماعية واضحة، فالمسلمون يصومون جميعا في شهر واحد. ومع بداية هذا الشهر يظلل المجتمع كله جو من الطهارة والنظافة والإيمان، ودماثة الأخلاق ، وحسن الأعمال، وتنشأ عطفة كبيرة بين فضلاء المسلمين ، نحو الفقراء والمساكين. ولعل من حكم الصوم الظاهرة هي الإحساس بما يحس به الفقير، الذي يطوي على الجوع بطنه أياما عديدة. وهذا ما يدفع المسلم أكثر فأكثر، نحو مد يد العون لكل محتاج. بالإضافة إلى أن الصوم يعوّد إلى الصبر، والتجلد، وقوة التحمل. كما أنه كالصلاة تماما، يزيد من التقوى، التي تعتبر ركيزة في تصرفات المسلم.
وكذلك الحج والزكاة، لا تقل عنهما أبدا في آثارهما الاجتماعية (183).
وبناء على ماسبق فإن المجتمع الإسلامي المثالي ترتبط فيه الشريعة بالعبادة، والقيم الأخلاقية .
وسوف تتجاوز التفصيل في الهيكل الاجتماعي العام للمجتمع الإسلامي، المكون من أنظمته الثلاثة : النظام الأسري، والنظام السياسي، والنظام الإقتصادي، لأن ذلك معروف ومدروس بشكل يسهل الرجوع إلأيه، والاطلاع عليه في كثير من المصادر (184).
الهدف الثالث:
يهدف علم الاجتماع الإسلامي إلي وضع الخطط المستقبلية، وإيجاد الوسائل والسبل، التي تكفل سير المجتمعات الإسلامية المعاصرة في حدود مبادئ الإسلام، وتقلل من ابتعادها عنه.
ويعني هذا الهدف مواجهة التغييرات التي تطرأ على المجتمعات الإسلامية، وذلك باعتماد التغيير الاجتماعي المخطط، الذي يسير وفق خطط مدروسة، وموضوعة بعناية.
إن أي مجتمع لا بد أن يتغير، حيث إن التغير سنة من سنن الحياة، وإذا سلمنا بوقوع التغير، فلا بد أن نتأكد من أنه لا يتعدى حدود الإسلام، ولا بد من إيجاد الوسائل والسبل، التي تقلل من ابتعاد المجتمع عن النموذج الإسلامي.
وهذا يتطلب من عالم الاجتماع المسلم، مواجهة كم كبير من المشاكل الأساسية في المجتمعات الإسلامية، ويأتي في مقدمتها قضايا التنمية. فكل الحكومات الإسلامية، تحاول جاهدة الخروج من حالة التخلف، التي تعيش فيها، وقد اتبعت كل منها أحد الطريقين الرئيسين في هذا العصر، وهما الطريق الرأسمالي، أو الطريق الاشتراكي. ومع أن التنمية تسير في هذه الدول بخطى حثيثة منذ قرابة ربع قرن، إلا أن مشكلة التخلف لم تختف حتى الآن، بل إنها تزداد يوما بع يوم، "فالدول التي تتبع نظام التنمية الرأسمالية في العالم الإسلامي، هي دول غارقة في الديون بصورة مخيفة، ذلك أنها تشري أساليب التصنيع الغربي بأسعار مرتفعة جدا، وتكاليف باهظة. أما الدول الإسلامية التي تتبع النظام الاشتراكي، فإنها تعاني من العجز البيروقراطي والتسلط، الذي تمخض عنه تبديد الموارد الوطنية، وغرس الإحساس بالغربة بين العمال. ونتيجة لهذا، فإن الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه هذه الدول بشق الأنفس، بعد سيطرة أجنبية طويلة، يضيع ويفقد بسبب التبعية الاقتصادية، التي لم تؤت ثمارها بعد "(185).
ولعل أفضل ما يصف نتائج التنمية التي اتبعت في الدول الإسلامية، هو التقرير الرسمي الذي قدمه أمين الجامعة العربية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. وتجربة الدول العربية لا تختلف عن تجربة الدول الإسلامية غير العربية. وهذه مقتطفات من هذا التقرير(186):
"لقد كان للطموح العربي إلى التقدم السريع، أثره في زيادة الاعتماد على السوق الدولية، وتنامي ظاهرة العلاقة غير المكافئة على حساب التكامل القومي المتوازن. وحسبنا هنا أن نشير إلى بعض الدلالات الاقتصادية التي قد تبدو بسيطة في ظاهرها، ولكنها بليغة في مغزاها: إن 70% من المواطنين العرب لا يزالون يعانون من الأمية، وما زال أكثر من نصف المجتمع العربي، يشكو من عناية الصحية وما زال الوطن عن العرب يعتمد على الخارج للحصول على أقصى من نصف حاجته من الغذاء، ولا يستخدم إلا عشر قواه البشرية في وقت يتزايد فيه اعتماده على اليد العاملة الأجنبية. وفي الوقت ذاته يشكو من نزيف حاد في طاقاته العلمية والتقنية ".
وبعد أن ذكر التقرير أرقاما عن انخفاض الإنتاج الزراعي، قال: ولم تأت الصحوة في المنطقة العربية إلا في بداية الثمانينيات، لتبرز هذه الحقيقة الفاجعة، وهي: أنها اليوم، وبالقياس إلى الدول النامية، أبعد مناطق العالم تخلفا من حيث الإنتاجية، وأبلغها عجزا غذائيا، وأكثرها انغماسا في التبعية، وبالتالي أسرعنا تأثرا بالأزمة العالمية الغذائية، ولم يعد خافيا على أحد، أن سلاح الغذاء هو اليوم من أخطر الأسلحة، وأشدها تعقيدا لحرية القرار الاقتصادي والسياسي، بحكم طبيعة إنتاج الأغذية وأسواقها، التي تهيمن عليها قلة احتكارية، لم تتردد في التلويح بإمكان استخدام هذا السلاح لتنفيذ سياستها الخارجية.
وعلى الرغم من أن هذا التقرير يثبت فشل اتجاهات التنمية الخالية، التي تعتمد على التغريب بشقيه الماركسي والرأسمالي، إلا أن أغلب علماء الاجتماع لا يعدمون تبريرا المثل هذا الفشل ويشاركون بذلك في عملية التنمية المزيفة. فمثلا كثيرا ما نسمع عن أن النمو السكاني المتزايد يساهم بشكل كبير في إفشال مجهودات التنمية. والحقيقة أن هذه دعوى زائفة "فالدول الإسلامية ككل، تجمع بين معدلات النمو السكاني المنخفضة مثل "تركيا"، ومعدلات النمو السكاني المرتفع "مثل مصر وبنجلاديش"، وإذا كانت مصر وبنجلاديش حالة سيئة في مجال النمو، فإن الوضع في تركيا التي تنهج نهجا غربيا لا تبشر بأي تقدم في هذا المجال أيضاً، بل أن الواقع هو أن الديون الأجنبية قد أثقلت الاقتصاد التركي، وجعلته اقتصادا مريضا شأنه في ذلك شأن اقتصاد بنجلاديش "(187).
ويتغاضى كثير من علماء الاجتماع، عن الهدف الأساس الذي يوجه عمليات التنمية في الدول الإسلامية، حيث كان التركيز فقط على النواحي المادية من التنمية، وأهملت النواحي الروحية إهمالا كاملا، وهذا أمر طبيعي ما دامت الدول الإسلامية تسير في الطريق الرأسمالي، أو الماركسي. والحقيقة أنه مهما بلغ التقدم المادي، فإنه يظل ناقصا، ولا يمكن أن يشبع حاجة الإنسان، ما لم يواكبه إشباع لمطلب الإنسان الروحية. "فأي جهد يخلو من إرضاء الجانب الروحي في الإنسان " لا يخلِّف وراءه إلا إحساس بعدم الرضا، رغم كل مظاهر التقدم المادي، التي يمكن تحقيقها(188). وغياب البعد الروحي، أحد أهم الأسباب ، التي أدت إلى تعثر عمليات التنمية في العالم الإسلامي، فلا يمكن قيام تنمية متقدمة باستمرار، ما لم يمكن مجتمع التنمية نفسه "متمتعا بالحساسية الأخلاقية النابعة من أداء الواجب، لأنه واجب، ومراعاة الضمير، والبعد عن السلبيات العديدة، التي تنخر في عملية التنمية نخر السوس في العظام المتهالكة، كالانتهازية، والأنانية، والوصولية، والرشوة، وعدم تقدير المسؤولية، والبحث عن الثراء الحرام، فهي سلبيات لا يمكن أن تتحقق معها تنمية مجتمع ما مهما توافرت له سائر العناصر الاقتصادية والاجتماعية " (189).
ونظرا لأن عمليات التنمية في الدول الإسلامية لم تعط الجوانب الروحية في الإنسان أي اهتمم، فإن السلبيات السابقة، تجمعت في الشعوب الإسلامية، لتكون أهم العوائق في وجه التنمية. ولفرط وجود عنصر الفساد في كثير من الدول الإسلامية، وغيرها، فقد أطلق عليها تعبير الدول "الهشة "، فهناك عدد لا بأس به من الدول الإسلامية في يومنا هذا تتفشى فيها الرشوة، والاختلاس، والغش في الأموال الحكومية في صورة مرتبات وهمية، ونفقات سفر لكبار الموظفين، بين الأمور غير الواضحة للعيان، تصبح الرشوة أمرا علنيا، بعيدا عن السرية، ونتيجة لهذا الوضع فإن الحصول على خدمات غير قانونية.. يعتبر أمرا سهلا بعد تقديم الرشاوى. أما الأعمال الهامة والمشروعة، فإنها تعرقل وتؤجل إلى ما لا نهاية، إذا لم يتقاض الموظفون المعينون الرشاوى (190).
إن التنمية التي ينشدها الإسلام هي التي توازن بين مطالب الإنسان المادية والروحية، وتكون منطلقة من الإسلام نفسه، وبذلك تتجنب الانغماس في المادية، كما أنها لا تتطرف تطرفا روحيا كما تطرقت الهندوسية، والبوذية. ورهبان المسيحية، وبعض الصوفية من المسلمين. وتستهدف مثل هذه التنمية: "إقامة مجتمع يعتمد في بنائه على وجود بيئة سياسية واقتصادية واجتماعية، تغذي مطالب الإنسان المادية والروحية على حد سواء(191). والحقيقة أن قضية التنمية تقود إلى قضايا أخرى، مثل قضية التجزئة، وهي العملية التي فرضها الأعداء على الأمة الإسلامية، وقسمت على ضوئها إلى دويلات كثيرة، بحيث يسهل السيطرة عليها. وهي السياسة المعروفة بسياسة فرق تسد. والدول الإسلامية الآن تفقد أي نوع من أنواع التكامل بينها، بل إن العلاقات فيما بينها كثيرا ما يشوبها التوتر، بل والنزاع بسبب الخلاف على الحدود، أو نتيجة سياسة معينة. وهذا أمر يزيد من ضعف الأمة الإسلامية، وخرمها استخدام إمكانيتها كاملة، وقد حدث هذا بعد أن كانت الدولة الإسلامية واحدة، تعيش في ظل الخلافة، وتحكم الشرع(192).
ويتطلب الوضع الحالي من عالم الاجتماع المسلم، دراسة عميقة يبتعها وضع الخطط المستقبلية، التي تكفل التكامل بين الدول الإسلامية، في جميع المجالات، بحيث يؤدي ذلك إلى وحدة القرار، ووحدة السياسة، والتكافل والتكامل الاقتصادي، وغيره.
ولكي يضمن عالم الاجتماع المسلم أن يكون التغير الاجتماعي لا يخرج عن الإسلام، فإنه لا بد له من تخطيط شامل على كل المستويات يستهدف أمرين، هما:
(أ) التخطيط الداخلي: وهو عبارة عن الجهود المبذولة لتطوير المؤسسات الاجتماعية، والحفاظ عليها في داخل الأمة الإسلامية ذاتها.
(ب) التخطيط الخارجي: ويستهدف نشر الإسلام عن طريق الدعوة بين المجتمعات والأفراد التي لا تدين بالإسلام(193).
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نور الدين- عضو نشيط
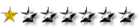
-

تاريخ التسجيل : 14/01/2010
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع مفهوم الصياغة وأهميتها
» مصادر الصياغة الإسلامية
» عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
» كتب في علم الاجتماع
» علم الاجتماع
» مصادر الصياغة الإسلامية
» عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
» كتب في علم الاجتماع
» علم الاجتماع
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى


