عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
صفحة 1 من اصل 1
 عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
عوائق الاستفادة من علم الاجتماع المعاصر . المبحث الأول : معايير علم الاجتماع القائم
لا يشك أحد في أن علم الاجتماع يعتمد على حقائق جزئية، وحوادث واقعية، لا ينكرها عقل، ولا علم، ولا دين، ومع ذلك نجد علماء الاجتماع يختلفون اختلافاً كبيراً عند دراستهم لهذه الوقائع، وقد اعترف بهذا الاختلاف كثير من علماء الاجتماع (54).
ولا شك أن وراء هذا الاختلاف تقف المعايير التي يسير على ضوئها هذا العلم، ونقصد بها الموازين التي تزن وتقوِّم الأبحاث الاجتماعية.
ويهمنا في هذا المقام، أن نتحدث عن معيارين، كان لهما الأثر الكبير في إعاقة الاتفادة الكاملة من علم الاجتماع بالنسبة للمسلمين، مما يحتم بعد ذلك دفع عملية الصياغة الإسلامية إلى الأمام، خصوصاً ونحن نعرف أن هذا العلم مرتع لتعدد وجهات النظر.
وهذان المعياران هما:
1- الدقة العلمية والتحليل الموضوعي.
2- الارتباط الوثيق بالفلسفات والعقائد المختلفة.
وسيكون الحديث في البداية عن عرض ومناقشة المعيار الأول، ثم نتكلم بعد ذلك عن المعيار الثاني.
المعيار الأول
الدقة العلمية والتحليل الموضوعي
ويعني هذا المعيار: أن المجتمع بظواهره ومشاكله، يعتبر موضوعاً لعلم " Science " هو علم الاجتماع.
والعلم، مصطلح يعني: الدراسة الموضوعية المنظمة للظواهر الواقعية، وما يترتب على ذلك من بناء للمعرفة. وعليه فإنه يتميز بالخصائص التالية، وهي : أنه منظم، وموضوعي، وواقعي "أمبريقي ".. ويقوم العلم على دعوى جوهرية، محصلتها أنه من الممكن استقاء المعرفة بالعالم من خلال الحواس، وأن صدق هذه المعرفة يتأكد بواسطة الملاحظات المتشابهة التي يقوم بها كثير من الأشخاص. وأنه من الممكن -نسبياً - التحكم في تحيز الملاحظ وقيمه الشخصية، حتى تتوافر درجة ملائمة من الموضوعية (55).
وقد قاد هذا المفهوم للعلم إلى التأكيد على قيمة الموضوعية العلمية التي لا تعني النزاهة والأمانة فقط، ولكنها تتعدى ذلك إلى التخلص من ضغوط الأهواء السياسية، والذهنية والفكرية، وعدم الخضوع أو الأخذ بأي نظرية أو فكر اجتماعي، أو سياسي، عند بحث أي ظاهرة، وتقتصر على رؤية العالم كما يبدو بالفعل، وتكتفي بملاحظة الظواهر المشاهدة فحسب، مما يعني تنحية القيم، حيث يعتبر مفهوم القيمة مفهوم غير ضروري، وغير مرغوب فيه، في علم الاجتماع كما يقول أدلر (56) (57).
وتعني دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية، أن تدرس بعيداً عن الفلسفات التأملية، والعقائد الدينية، فالدراسة العلمية تعتمد على الملاحظة والتجريب فحسب، وتقابلها الدراسة الدينية والفلسفية والفنية التي تعتبر غير علمية. ولكنها ربما تزودنا بنوع من المعرفة، إلا أنها على كل حال غير علمية (58).
نشأة الدراسة العلمية
للظواهر الاجتماعية "الموضوعية" ورسوخها
لقد نشأت المطالبة بالدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية، باعتبار هذه الدراسة متميزة عن الدراسة الدينية والفلسفية، في أجواء الثقافة الغربية، حيث تأثر الباحثون في الشؤون الإنسانية، بالنجاح الذي حققه المنهج العلمي في العلوم الطبيعية والبيولوجية. فقد نجح العلم الطبيعي في كشف ظواهر الكون، والسيطرة عليها، بعد أن تخلص من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية، قبل عصر النهضة، التي كانت ترى أن غاية البحث هي فهم كلمة الإله في الكون. وعين الضلالة عندها هي: البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدس، حيث يقول أحد الآباء: "لو كان هناك احتمال للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث والدراسة، لكنا قد توصلنا إليها من زمن بعيد، وبما أنه لم يتوصل إليها برغم ما ضاع في سبيل ذلك من وقت وجهد، فمن الواضح الجلي إذاً أن الحكمة والحقيقة لا وجود لهما "(59).
وقد استخدمت الكنيسة العنف في سبيل حمل العلماء على اعتناق هذا المبدأ، مما ولد عندهم ردة فعل ضدها، فاستبدلوا مبدأ آخر بمبدأ الكنيسة فحواه: أن المعارف يجب أن تنمى عن طريق ما يمكن أن يلاحظ، أو ما يمكن جعله قابلاً للملاحظة. . وكانت الروح المميزة للقرن الثامن عشر، هي روح المشاهدة، والدقة، والمراقبة، وإجراء التجارب، واستنباط القوانين العامة الواضحة والدقيقة، وكما يقول أحد المؤرخين:
"لقد انشغل الناس بالمنهاج المعصوم من الخطأ "المنهج العلمي"، وخُيل إليهم أنه لم يبق من مهمة سوى أن يسحبوا المنهاج العلمي الذي ولد على يدي ديكارت (61) ونيوتن (62)، ليغطي تلك المناطق التي لا تزال خاضعة للخرافات وعدم الانتظام "(60).
ونظراً لنجاح المنهج العلمي في كشف الظواهر الطبيعية، فقد أفترض أن هذا المنهج سيحقق نفس النجاح في كشف حقائق الظواهر الاجتماعية، لأنها طبيعية يجب إخضاعها لنفس المنهج، حتى يمكن التحكم فيها. ومن هنا بدأ العلماء يدرسون الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي السالف، وأصبح هذا المنهج ركيزة من ركائز علم الاجتماع، تقاس قيمة الأبحاث، بقدر تمسكها به. وعلى كل حال، فقد سيطرت الفكرة القائلة: بأن نجاح علم الاجتماع خاصة، والعلوم الاجتماعية على وجه العموم، وتقدمه، رهن بقدرته على استخدام مناهج العلوم الطبيعية، وطرق البحث فيها، وبخاصة استخدام القياس، والإحصائيات، والاستبيانات، والجداول، وغيرها.
ومن هنا فقد كثر الحديث عن المقارنة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، الذي ينتهي غالباً بتأكيد أن الفرق بينهما هو فرق في الدرجة فقط (63).
بمعنى أن العلوم الاجتماعية، ستصل يوماً ما إلى ما وصلت إليه العلوم الطبيعية، من دقة، فهذا أحدهم يقول: "إن المنهج العلمي إنما ينحصر في المشاهدة، والتجريب، مشاهدة الوقائع البسيطة، لا الغليظة (المعقدة) حيث إن الواقعة العلمية هي التي يمكن إجراء التجارب عليها " (64).
ويقول آخر: "إن المعرفة التي لا يمكن قياسها، هي معرفة هزيلة، وغير مقنعة "(65).
والحقيقة أن الاقتناع السابق بضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهاج العلمي، ظهر تدريجياً، ولم يظهر دفعة واحدة، فلما جاء كونت أعلن علمية علم الاجتماع، ووضعه على رأس القائمة عند تصنيفه للعلوم، واعتبره علماً طبيعياً. فقد كان يقيس الأشياء جميعها بمقياس العلم، الذي يعتبره الصيغة الوحيدة للمعرفة الإنسانية. وقد رفض اعتبار اللاهوت والميتافيزيقا مجالات للمعرفة، بناء على أنه لا يمكن تبرير ما تدعيه من معرفة، بمنهج البحث العلمي(66).
وهذا أمر طبيعي أن يصدر من رائد الوضعية، التي تكتفي بملاحظة الظواهر المحسوسة فقط.
ويمكن تحديد الملامح العامة لمنهج كونت في القضايا الرئيسة التالية:
1- إن الحقيقة تنحصر في كل ما هو متاح أمام إدراك الحواس.
2- إن العلوم الطبيعية والاجتماعية تشترك في أساس منطقي ومنهجي واحد.
3- أن ثمة فرقاً جوهرياً بين الواقع والقيمة، فالعلم يتعامل مع الواقع فقط، وأما القيمة فإنها تعكس نظاماً للظواهر، يتميز باختلافه التام، وخروجه عن نطاق العلم(67).
وهذه الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية، التي أكدها كونت، صارت فيما بعد عقيدة أساسية في المناهج الاجتماعية المعاصرة. حيث يحذر الباحثون من الوقوع تحت طائلة التعصب لأقوامهم، أو أديانهم، أو وجهات نظرهم الخاصة. ويكتفون فقط باستنباط افتراضاتهم ونظرياتهم من النتائج التجريبية فحسب. وعليه، فما لا يمكن تحقيقه بالتجربة، فهو تأملي تماماً كما يفعل علماء الطبيعة (68).
ولعل "دوركايم " كان أكثر علماء الاجتماع اجتهاداً في تحديد كيفية دراسة الظواهر الاجتماعية، وقد ألف كتاباً في هذا الموضوع سماه: "قواعد المنهج في علم الاجتماع "، حدد فيه خواص الظاهرة الاجتماعية. ثم بين القواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية.
وقد كانت أولى القواعد، وأكثرها أهمية -على حد تعبيره- هي أنه يجب ملاحظة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء.
ويعني بذلك أن على عالم الاجتماع أن يسلك مسلكاً شبيهاً بالمسلك الذي ينهجه كل من عالم الطبيعة والكيمياء، أو وظائف الأعضاء، حينما يأخذ في دراسة بعض الظواهر، التي لم تكتشف بعد في دائرة اختصاصه العلمي (69). وذلك على أساس أنها أشياء تقدم نفسها للملاحظة، كنقط بدء للعمل.
وقد أضاف قواعد متممة لهذه القواعد كانت أولاها: أنه يجب على علام الاجتماع أن يتحرر بصفة مطردة من كل فكرة سابقة(70). ويعني بذلك التحرر من سيطرة الأفكار الشائعة، وإسكات المعتقدات والعادات الأخلاقية مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من دراسة الظاهرة. كما يجب عليه أن يزيح عن كاهله تلك الآراء البدهية الكاذبة، التي تسيطر على قعول العامة من الناس، ويحذر قواعد التفكير التقليدي، وهي تلك القواعد التي تنقلب مستبدة قاهرة في نهاية الأمر، وذلك بسبب شدة إلفه إياها. وإذا اضطر إلى استخدامها، فلا بد أن يتذكر أنها قليلة الجدوى، حتى لا يعطيها أكبر من حجمها أثناء بحثه(71).
ويقول أحد أساتذة علم الاجتماع عن جهود دوركايم في ترسيخ المنهج العلمي في علم الاجتماع: "وجدير بالذكر أن دوركايم حين يسعى إلى إقامة علم الاجتماع على أسس علمية، إنما هو في الحقيقة يعيد صياغة أفكار سبقه إليها سان سيمون، وكونت، وسبنسر، ولكن الشيء الوحيد الذي يؤكده دوركايم: هو أن هؤلاء لم ينجحوا في فصل علم الاجتماع عن الفلسفة والتصورات الميتافيزيقية.
فهو وإن كان يؤمن بالمنهج الوضعي، إلا أنها ليست تلك الوضعية الميتافيزيقية، التي تبناها كونت، وسبنسر، حيث نظرا إلى الظواهر الاجتماعية بوصفها تسير عبر خط تطوري وتقدمي واحد (72).
ويعني هذا أن دوركايم أوغل في علمية علم الاجتماع، إلى درجة أبعد مما وصل إليه كونت.
وامتداداً لدراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي، ظهرت النظرية الوضعية المحدثة في علم الاجتماع، التي اعتبرت المناهج غير الكمية في دراسة السلوك الإنساني شديدة السطحية، على خلاف المنهج الكمي الذي يعتبر العد والقياس منهجاً لا غنى عنه للبحث العلمي في أي ميدان.
وعلى كل حال فإن علم الاجتماع، لم يتجاوز ما وضعه له كونت من أسس، بالرغم من تعدد نظرياته. فهذه النظريات جميعاً تؤكد علميته نفسها. وتتفهم تلك العلمية كاعتماد على المحسوس دون غيره. وكما يقول تيماشيف: "فلقد كان الهدف الأساس للرعيل الأول من علماء الاجتماع، هو إرساء الدعائم العلمية لدراسة المجتمع. ونحن نعتقد أن أغلب علماء الاجتماع خلال مراحل تطوره المختلفة، كانونا يسعون إلى تحقيق هذا الهدف (73).
أوجه الاعتراض على هذا المعيار:
يمكن حصر الاعتراضات على هذا المنهج، في ثلاث نقاط:
1- خطأ التسوية بين الظاهرة الطبيعية، والظاهرة الاجتماعية.
2- الحياد حيال القيم.
3- عدم الواقعية في هذا المعيار.
و نبدأ بالاعتراض الأول:
1- خطأ التسوية بين الظاهرة الطبيعية، والظاهرة الاجتماعية:
لقد كان الخطأ الأساس في المنهج العلمي الذي تبناه علم الاجتماع، هو التسوية بين البحث في الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية، علماً بأنه لا مجال للاتفاق بينهما، فبينما يمكن الوصول إلى حقيقة الظاهرة الطبيعية، حين تنفصل عن سياقها الزماني والمكاني، الذي تقع فيه، فإن الوصول إلى حقيقة الظاهرة الاجتماعية، يستحيل، حيث تجرد من سياقها الزماني والمكاني، وحين تسلب من محيطها الديني الخلقي والاجتماعي الذي يتحكم في حركتها(74).
إن أي ظاهرة إنسانية، اجتماعية كانت أو فردية، لا تتكون من عناصر مادية خالصة، يمكن ملاحظتها بالحواس، ومعرفة كمها وقياسها، بل هناك عناصر أهم تتدخل في تكوينها والتحكم فيها وهي العناصر المعنوية والروحية، ولا يكتمل وصف الظاهرة الإنسانية دن الرجوع إليها، كما لا يمكن ردها إلى المحسوس، ولا يمكن عزلها ولا فصلها عن محيطها. كما لا يمكن أيضاً إخضاعها للقياس الكمي الذي لا يعرف العلم غيره، ولا تخضع لقانون ثابت أبداً، وفي هذا المجال يمكنني أن أضرب هذا المثال:
إن الشعور بالفقر والحرمان والإخفاق، قد يسلم صاحبه إلى اليأس والقنوط من الحياة، ومن ثم الانتحار هرباً من مشاكله. كما يؤدي بإنسان آخر إلى الجد والاجتهاد والثبات، وحضور المل، وبالتالي قهر المشاكل والتغلب عليها.
ومرد ما سبق إلى اختلاف الشخصين في مدى حظهما من الإيمان العميق، وسلامة الشخصية، وسداد التفكير، ونوع التربية (75).
ومن ناحية أخرى، فإن الظواهر الاجتماعية لا تتشابه، بل تختلف باختلاف الجماعات الإنسانية، حيث تعتمد على تقاليد الثقافة والدين، وعلى الهوى الشخصي والجماعي، الذي لا يمكن تحديده بشكل شامل (76).
ومن هنا فإن تحديد مادة العلم بما يمكن رصده وقياسه، يعتبر انتقاصاً لجانب الحقيقة، التي تشتمل على جانب آخر لا يقاس.
فعلماء الاجتماع الذين يتمسكون بالمنهج العلمي، كما ورد سابقاً يؤمنون بعالم الشهادة فقط، وهو العالم الذي تدرك الحواس جزئياته في الحياة الأرضية، وما يحيط بها من كون مادي، ولا شيء قبل هذا الكون المادي المشاهد، ولا شيء بعده، فلا يعالج ما وراء الطبيعة، ولا يتعامل مع عالم الغيب، كما يرفض الوحي السماوي بصورة مطلقة، ويهدم حقيقة النبوات والمعجزات، ولا يؤمن إلا بما هو محسوس.
أمثلة على التسوية بين الظاهرتين:
نظراً لاعتماد علم الاجتماع على المنهج العلمي، الذي يسوي بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية، مع خطأ التسوية بينهما، فقد كثرت الأخطاء في البحوث الاجتماعية، خصوصاً عند تناولها للدين.
ولعله من المناسب هنا أن نورد رأي محرر دائرة معارف العلوم الاجتماعية، عند حديثه عن الدين، لنوضح أن المنهج العلمي عند علماء الاجتماع الغربيين، ليس كاملاً بل ينقصه التعامل مع عالم الغيب.
فقد رأى أنه يمكن تشبيه "الدين " بـ "الفن "، فكما أن بعض الناس يتمتعون بقوة غير عادية في التذوق الفني، كذلك ينفرد بعض الناس بخصائص "العيون والآذان الداخلية "، يلتقطون بها ما لا يتمكن الإنسان العادي من سماعه أو رؤيته. وهذا الشيء هو الذي قاد الإنسان إلى تجارب الدين(77).
ويكتب آخر: "إن خصائص الدين المتعلقة بما بعد الطبيعة، لا معنى لها إذا نظرنا إليها بمفهومها الديني. أما إذا أعطينا هذه الحقائق لغة المجاز، فإنها قد تصبح ذات معنى مثلما نقول على شخص ما إذا اكتشف شيئاً جديداً: "لقد كان هذا إلهاماً"، فهكذا "يتنزل" الإلهام على الشاعر، وكذلك على النبي "(78).
ويرى أيضاً أن الوحي، لا معنى له إذا نظرنا إليه على أنه كلمات الله التي نقلها أحد الملائكة إلى إنسان مخصوص. بل إن أمر الوحي يكون مفهوماً لو قلنا عنه: إنه "ضوء البصيرة الداخلية ". لأننا نعرف أن الفنان أو المفكر كليهما تخطر له بصورة خاطفة، أفكار من نوع ما، وهكذا الحياة بعد الموت، يمكن فهمها في لغة تمثيلية، أما إذا نظرنا إليها بالمفهوم اللفظي الظاهري، فإنها تصبح بدون معنى، وذلك لأننا نعرف أن الجسم تنتشر أعضاؤه بعد الموت، وتنتهي معه الروح، ففي ضوء هذا الأمر تكون الحياة بعد الموت غير مفهومة بمعناها اللفظي (79).
ولعل من أشهر من درس الدين من علماء الاجتماع "دوركايم "، الذي ألف كتاباً بعنوان "الصور الأولية للحياة الدينية " عام 1912م، حاول فيه تطبيق المنهج العلمي السابق على دراسة الدين في أكثر صوره أولية.
والحق أن أصل الدين، لا يمكن أن يستخلص من دراسة مجموعة الطقوس والشعائر الدينية، حين تدرس بمنهج الملاحظة الاجتماعية أو الأسلوب الإحصائي، أو دراسة الحالة، أو المسوح الاجتماعية، وغيرها من مناهج علم الاجتماع، وأي دراسة من هذا القبيل لا تستعين بالوحي، فإنما هي ضرب من الحدس والتخمين، لا تمتُّ إلى العلم بصلة، وذلك لأنه لا سبيل إلى البحث في أصل الدين ونشأته عن طريق التجربة، والبحث العلمي، لبعده عن حيز المشاهدة، وارتباطه بالزمن الماضي البعيد، لذلك فلا مندوحة عن استعمال التأمل والتفكير المجرد، الذي كثيراً ما تندس خلاله العناصر الشخصية، غير العلمية، بحيث تسيطر على الباحث فكرة سابقة، لا يستطيع التخلي عنها حتى ولو حاول، فإذا انطلق الملحد ليبحث في أصل الدين، فلا يمكن أن يتحرر من فكرته عن الدين. وكذلك من يحمل فكرة خاطئة عن الدين، كعدم التمييز بين السحر والدين، أو عدم التمييز بين وجود الله في ذاته، وفكرة الإنسان عن الله وعقيدته به.
وغالبية علماء الاجتماع من الغربيين، لا يستطيعون التخلص من ردة الفعل، التي أحدثتها عندهم المسيحية المحرفة، حيث أورثتهم عداء للدين عامة، نتيجة لطبيعتها في ذاتها عندما حرفت، ونتيجة لمحاربتها للعلم وأهله، ومصادمتها للعقل. ومن هنا فقد كانت بحوثهم عن أصل الدين خاطئة ومضللة، ومخالفة لحقائق القرآن الكريم.
وعلماء الاجتماع يسوون بين نوعين من الموضوعات والنظريات والحقائق في البحث، مع اختلافهما الواضح، ومن المهم جداً التفريق بينهما:
1- الحوادث الاجتماعية التي هي تحت سمعنا وبصرنا، مما يمكن مشاهدته، وجمعه، ودراسته، ووصفه، وتصنيفه.
2- الأمور التي لا يمكن إخضاعها لطرائق البحث العلمي الدقيق، وذلك كالبحث في نشأة الأديان، وأصول اللغات، وما إلى ذلك (80).
فالأمر الثاني تحدثنا عنه فيما سبق، وعرفنا كيف تخبط علما الاجتماع في دراسته. وقد كثرت فيه النظريات واختلفت، وجميعها لا تمتُ إلى العلم بصلة. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن موضوعاً كالظواهر الدينية بالنسبة لكل دين عند المؤمنين به، وذلك كالفرق الإسلامية مثلاً، لا تعتبر من هذا الصنف، بل تكون مندرجة تحت الصنف الأول، وكذلك تطور اللغات وأصواتها ومعاني مفرداتها وتراكيب جملها، فإنها من الأمور المشاهدة التي يمكن جمعها والنظر فيها، ومقارنة بعضها ببعض.
وأما بالنسبة للصنف الأول، فإنه يمكن دراسته، والوصول فيه إلى نتائج صادقة وصحيحة، إلا أنها لا تبلغ ما تبلغه نتائج البحوث الطبيعية من صدق وصحة. علماً بأن المنهج المتبع حالياً لا يخلو من ملاحظات.
ويمكننا أن نلخص ما سبق في: أن مصدر المعرفة بالواقع الاجتماعي، لا يقتصر على المنهج العلمي المتمثل في التجريب والتحليل وحده، بل هناك مصادر أخرى لاكتساب المعرفة، أهمها الوحي، إضافة إلى الإلهام والحسد، كما أن الواقع الاجتماعي نفسه، ليس مقصوراً على الشاهد المحسوس فقط، بل إنه يشتمل على المعنويات والروحانيات التي لا تحس ولا تقاس. وإذا قصرنا الواقع على ما يلاحظ ويحس، فإننا بذلك نستبعد القيم الأخلاقية والدينية، التي تعتمد على معايير محددة سلفاً.
2- الحياد حيال القيم:
إن المنهج العلمي يؤكد الحياد حيال القيم من قبل الباحث، حتى لا تغطي عقيدته الموجهة، وأمانيه ورغباته على حقيقة الواقع الاجتماعي، تحقيقاً للموضوعية الكاملة. وليس معنى هذا أن عالم الاجتماع شخص بلا قيم، ولكنه يعني - كما يرى علماء الاجتماع - أن يبذل الباحث جهداً لكي يعلق قيمه كما يعلق معطفه، فما دام خاضعاً لاعتبارات الخطأ والصواب، فإن تصوراته ومقاييسه الخاصة عن الحقيقة، سوف تتسلل إلى بحوثه وتحليلاته الاجتماعية. وقد خصص عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، جزءاً كبيراً من اهتمامه لمعالجة هذا الموضوع، وقد شدد على الابتعاد عن خطر الأحكام الأخلاقية، التي تعتبر من مشوهات نتائج الدراسة، وذهب إلى أكثر من هذا حين دعا إلى الإقلاع عن كل فكرة إصلاح، أو تقويم، فعالم الاجتماع في رأيه ليس مصلحاً اجتماعياً ولا نبياً. وأكثر ما يجب عليه هو أبحاث تفيد المعرفة كمعرفة (81).
فليس من حق الباحث في علم الاجتماع، أن يصدر أحكاماً تقويمية، فيقول: بأن هذا السلوك أو هذه الظاهرة صحيحة أو معتلة، ويجب تقويمها أو المحافظة عليها.
وبذلك تكون مهمة عالم الاجتماع: الملاحظة، والوصف، والتحليل، والتفسير فقط، ولا يجوز له أن يعدوها إلى إيرها، كأن يقف موقفاً نقدياً، أو أن يبدي وجهة نظر معينة، أو يصدر حكماً تقويمياً.
ومع أن هذه الدعوة مستحيلة التحقق، نظراً لأن مواضيع علم الاجتماع تتعلق، بالنسبة لأي باحث، بميوله، ورغباته، وعقيدته، وحبه، وبغضه، إلا أنها تشكل مبدأ هاماً من البحث في علم الاجتماع، وعلى حد تعبير جولدتر فقد اتخذت هذه الدعوة شكل وصية تقول: "لا تصدر حكماً تقويميا ً"، وهي وصية تمتلئ بها الآن كل الكتب المدرسية (82).
ونظراً لأن علم الاجتماع يأمر الباحث بإخفاء عواطفه وميوله ومعتقداته، في سبيل الوصول إلى الحقيقة، "التي يظن أنها خارج الذوات والرغبات والمعتقدات، وأنها لا علاقة لها بما يشعر به الإنسان، أو يدركه، أو يحياه، بل هي في عالم منفصل عن الإنسان، وتدرك عن طريق التجربة والملاحظة "، فإن علم الاجتماع، في نظر علمائه، يؤدي خدمة جليلة، وذلك بتوعيتنا بنسبية القيم والأخلاق، وأساليب السلوك الشائعة في عالمنا الإنساني. وإدراك هذه الحقيقة هو بداية الطريق نحو إكسابنا القدرة على فهم القيم، وأساليب السلوك الشائعة، عند أبناء مجتمعات وثقافات غريبة عن مجتمعنا وثقافاتنا، وتمكيننا من الإحساس بحقيقة مشاعر غيرنا من البشر. ويعني هذا: التخلي عن الشعوبية، ومشاعر التمركز حول السلالة (83).
ويعني هذا أيضاً في النهاية: تلك العبارات التي ذكرها عالم الاجتماع الأمريكي "ويليام سمنر (84)، ومؤداها، أن الأعراف تصنع الصواب"، وكان يقصد بذلك أن مفاهيم الصواب والخطأ والخير والشر تعتبر نسبية، وأن الذي يضفي عليها النسبية، هي المعايير والعادات الشعبية السائدة في نظام اجتماعي معين. فالزنا يعتبر سلوكاً انحرافياً يوجب العقوبة التي تصل إلى حد القتل في مجتمعنا، ولكنه لا يعتبر كذلك في مجتمعات أخرى، فمصر القديمة مثلاً كانت تنظر إلى الاتصال الجنسي بين أبناء الصفوة، بوصفه سلوكاً لا يخضع للتحريم (85).
وعندما يعلق عالم الاجتماع قيمه، كما يعلق معطفه، فإنه يتحاشى البت في مثل عادة بعض قبائل الأسكيمو "الذين يعلقون الرجل المسن الذي يعجز عن الصيد، على حائط، أو يلقون به في البحر ليموت "، من ناحية الصواب والخطأ، ويكتفي بالقول: إن مستويات الصواب والخطأ، والحسن والرديء، تنسب إلى الثقافة التي تظهر فيها، فما يكون صواباً في مجتمع ما، قد يكون خطأ في مجتمع آخر. فقتل الأطفال الذي توافق عليه بعض الجماعات تحت ظروف خاصة، يعتبر إجراماً في جماعات أخرى، والعفة قبل الزواج مطلوبة في أحد المجتمعات، وغير مستحبة في الآخر. و بناءً على ذلك، فإن الصواب والخطأ يعتمدان على ما يتقبله الناس على أنه كذلك، ويصبح بإمكان الثقافة أن تجعل أي شيء صواب أو خطأ، بالنسبة لأعضاء مجتمع معين، ويصبح معنى الأخلاق: "ما هو أخلاقي بالنسبة لنا " (86).
إن الاختلاف بين المجتمعات في معتقداتها وعاداتها ونظمها، واقع يُشاهد ويُوصف. ولكن عالم الاجتماع المسلم لا يختلف عنده الحكم عليها عن وصفها وصفاً حقيقياً مطابقاً للواقع، وذلك لأنه يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يملك الحقيقة المطلقة، وهي الإسلام، الذي ارتضاه الله للناس كافة، فليس الواقع الاجتماعي شيئاً، إذا لم يكن خروجاً على قيم الإسلام، أو دخولاً في قيمه (87) ومن ثم فهو لا يغفل ما ينبغي أن يكون عليه الواقع المدروس: ((كُنتم خير أمّةٍ أخرجتْ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنِ المُنكر وتؤمِنون بالله ))
[آل عمران:110].
فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من أبجديات إسلام المرء، ولا يعفيه من هذه المسؤولية كونه عالم اجتماع، أو اقتصاد، أو طب، أو هندسة، بل الجميع يتحملون مسؤولية جعل كلمة الله هي العليا. وإن المسؤولية لتتضاعف إذا علمنا أن "العلماء ورثة الأنبياء "، وقد بعث الله الأنبياء والرسل لا لمجرد التبليغ والإعلام فقط، بل لطاعتهم فيما جاءوا به، ((وما أرسلنا مِن رّسولٍ إلاّ لِيُطاع بإذنِ الله )) [النساء:64].
فمهمتهم هداية الناس لمنهج الله، وكذلك العلماء يتحملون هذه المهمة بعد أن ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي.
وما كان الأنبياء يكتفون بوصف ومعرفة أحوال المجتمعات، بل كان كل منهم رافضاً لكل انحراف، وداعياً إلى ما يحمله من خير:
((وَلقد أرسلنا نوحاً إلى قومِه إنّ لكم نذيرٌ مبينٌ، ألاّ تعبدوا إلا الله )) [هود:25-26].
((وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مِّن إلهٍ غيره )) [هود:50].
((وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ))[هود:61].
((وإلى مدْين أخاهم شُعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المِكْيال والميزان )) [هود:84].
إن عالم الاجتماع المسلم له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فهو مشغول دائماً بقضية الإسلام، سواء بدعوة غير المسلمين إليه، أو رصد حركة المجتمع المسلم السلبية والإيجابية، فيقوّم السلبي، ويعزز الإيجابي. فهو لا يقف عند فهم وتحليل الوضع الاجتماعي فحسب، بل يتعداه إلى تغييره وتحويله إلى وضع يقوم على هدي الإسلام الحنيف. فهو ناقد، ومقوم في الوقت نفسه، إضافة إلى أنه علمي في منهجه، لا يكف عن البحث عن الحقيقة.
3- عدم الواقعية في هذا المعيار:
في ملاحظاتنا السابقة على المنهج العلمي في علم الاجتماع، لاحظنا الحرارة الزائدة عند الحديث عن قيم الباحث وحياده حياله، وفي هذه الملاحظة نتساءل: هل طبق علماء الاجتماع الغربيون هذا المبدأ؟
لقد كشف علم اجتماع المعرفة، عن تداخل مجموعة كبيرة من العوامل المرئية وغير المرئية في تشكيل فكر الباحث. فالباحث لا يستطيع الانفلات من معتقداته وقيمه،والظروف المحيطة به، بل إنها تؤثر تأثيراً كبيراً لا على رؤيته للحقيقة الاجتماعية فحسب، بل حتى على انتقائه لموضوعات دراسته. وإذا عرفنا أن عالم الاجتماع يبحث المواضيع المتصلة بالقيم والدين والمعتقدات، وكذلك مواضيع أنظمة الحكم، والأسرة، والاقتصاد، والاجتماع، عرفنا إلى أي درجة يلتصق عالم الاجتماع بموضوعات بحثه. وإنه لا يمكن إلا أن يكون إنساناً عادياً تجاهها. فكما أن الإنسان العادي يتأثر بأوضاعه الدينية والاقتصادية والأسرية، فكذلك عالم الاجتماع لا يمكن أن يتحرر من كل ذلك.
لقد أكد "جون ديوي (88) أن الإدراك، وهو أول ثمرة للملاحظة الحسية، لا يمكن أن يكون محايداً، وإنما يتأثر دائماً بخلفيات الملاحظ السابقة، وحظه من المعرفة، وبذكائه "(89).
ومن هنا، فإن أحكام الباحثين تتأثر بنظرياتهم، وفروضهم، وخلفيتهم المعرفية، وهذا هو السبب الذي دعا روبرت مرتون (91) لأن يعترف بأن في الولايات المتحدة خمسة آلاف عالم، لكل واحد منهم علم الاجتماع الذي يخصه (90) وحده، وذلك نتيجة تعدد العقائد الخاصة بكل عالم، رغم انتماء غالبيتهم إلى عقيدة المجتمع الرأسمالي.
ورغم اعتراف ميرتون السابق، واعتراف غيره بتعدد علوم الاجتماع، فإنه يذهب مع غيره من العلماء مثل لا زارس فيلد، وتالكوت بارسونز (92) إلى أنهم يعتبرون أنفسهم علماء اجتماع علميين، يقومون بدراسات نظرية وأمبريقية بحتة، لا علاقة لها بعقيدة سياسية أو غيرها. ومع هذا فإن الواقع يكشف عن أن الدراسات التي قام بها عالم غربي في مجتمع غربي، هي بالضرورة غربية، لا تنطبق على مجتمعات المسلمين.
ومن ناحية أخرى، فإن علماء الاجتماع، لم يكونوا منعزلين، رغم ادعاءاتهم السابقة، عن عقائد الغرب السياسية والفكرية، بل كانوا مخلصين في خدمتها. يكشف هذا بجلاء ، علم الاجتماع في عهد الاستعمار، فقد كان ذا نزعة استعمارية.
فالدراسة المقارنة للإدارات الاستعمارية، والثقة الكبيرة في التحليلات الاجتماعية، والدراسة المنهجية للمجتمع، والدين، والمؤسسات، واقتصاد المنطقة، التي يراد استعمارها، كل ذلك جعل من الممكن إقامة الاستعمار على أساس علمي، يخفف كثيراً من الخسائر التي تلحق بالدول الاستعمارية فيما لو سلكت سبيل الهجوم والطعنات الخاطفة. فبواسطة علم الاجتماع الاستعماري، يمكن تسجيل نقط ضعف المجتمع واستغلالها، وتسجيل نقط القوة وإضعافها، أو تحييدها. ويمكن أن نمثل على ذلك بالجهود التي بذلت في أواخر القرن الماضبي، وأوائل هذا القرن في دراسة المغرب العربي من قبل الاستعمار الفرنسي.
المعيار الثاني
الارتباط الوثيق بالفلسفات والعقائد المختلفة
يشكل ارتباط علم الاجتماع بالعقائد والفلسفات المختلفة، عائقاً كبيراً أمام الاستفادة الكاملة من علم الاجتماع. وقد اتضح بجلاء أن علماء الاجتماع يقدمون أبحاثاً تخدم المعرفة، بل أنهم يخدمون أوضاعهم وعقائدهم (93).
والدليل الأكبر على ذلك انقسام علم الاجتماع إلى قسمين هما علم الاجتماع الماركسي، وعلم الاجتماع الغربي الليبرالي. وطبيعة هذا الانقسام تعود بالدرجة الأولى إلى التصورات العقدية والأطر الفكرية للباحثين حول الإنسان، والمجتمع،والتاريخ، ولقد أكد جولدتر وغيره "أن أغلب النظريات في علم الاجتماع المعلنة ذات طابع فلسفي. بمعنى أنها ليست سوى تبريرات عقلية، لبعض الفروض الخلقية التي يقتنع بها الباحث "(94).
كما أكد "أ.ك أوتاواي " في كتابه "التربية والمجتمع ": أنه من المستحيل الكتابة في علم الاجتماع، دون التعرض للأسئلة المتعلقة بطبيعة الإنسان ومعنى الحضارة، ولا يمكننا أن نتجنب بعض مسئوليتنا في تحديد الاتجاه الذي نعتقد أنه يجب على المجتمع أن يتطور فيه (95).
وعلى هذا، فإن لكل من الفلسفة الماركسية والفلسفة الوضعية، مذهب في علم الاجتماع، يتناسب مع مقولاتها، ويبني على آرائها، ويقوم أولاً وأخيراً على الوقائع المحسوسة، وإنكار الغيب، وما وراء الطبيعة.
علاقة علم الاجتماع بالوضعية واللادينية:
لقد تركت التطورات الفكرية والفلسفية في المجتمع الغربي نقاشاً حاداً بين المفكرين والمصلحين حول طبيعة النظام الذي يجب أن يسود، وانقسم الناس تبعاً لذلك إلى فريقين: فريق يطالب بالتغييرات الجذرية، التي تقضي على القديم، وفريق يطالب بالحفاظ على القديم وعدم الإضرار به(96).
وعلى هذا فقد كان النظام الأمثل، مسرحاً لعراك فكري بين أنصار فلسفة التنوير، وبين الرومانسية المحافظة، وبمعنى آخر كان العراك قائماً بين دعاة التقدم، وبين دعاة النظام، "فدعاة النظام يذهبون إلى أن المشكلة ترجع إلى تحطيم النظام القديم، بينما يذهب دعاة التقدم، وهم الثوريون، إلى أن الأزمة ناتجة عن أن النظام القديم، لم يحطم تحطيماً كاملاً "(97).
وفي هذه الأجواء ظهرت الفلسفة الوضعية، مرتدية ثوب العلم وحده، وكما يقول "جولدتر ": ظهر جيل جديد لم يناصر الأيديولوجية الثورية، ولكنه لم يناهضها، وتأثر هذا الجيل بتطور العلم السريع. وقد اتصف هذا الجيل بصفتين: القدرة على الانفصال عن الأطر الفكرية السائدة من ناحية، والاستعداد للتأثر بنسق فكري جديد من ناحية أخرى.
لقد أحس هذا الجيل بالحاجة إلى أيديولوجية تضفي على العلم صورة رومانسية، وتتفق في نفس الوقت مع النظرة العلمية الجديدة. فكانت الفلسفة الوضعية هي ما قدمه ذلك الجيل. وقد ظهر من خلالها علم الاجتماع وهو الذي تقبلها ونشرها(98).
وانطلاقاً من هذه الفلسفة، صاغ "كونت " مصطلح "علم الاجتماع " وأدرجه ضمن تصنيفه للعلوم، الذي يبتدأ بالرياضيات، وينتهي بعلم الاجتماع، الذي أضفى عليه أهمية فائقة، فقد كتب يقول: "لدينا الآن فيزياء سماوية، وفيزياء أرضية ميكانيكية أو كيميائية، وفيزياء نباتية وفيزياء حيوانية. وما زلنا بحاجة إلى نوع آخر وأخير من الفيزياء وهي الفيزياء الاجتماعية، حتى يكتمل نسقنا المعروف عن الطبيعة، وأعني بالفيزياء الاجتماعية، ذلك العلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعاً لدراسته، باعتبار هذه الظواهر من نفس روح الظواهر الفلكية، والطبيعية، والكيميائية، والفسيولوجية، من حيث كونها موضوعاً للقوانين الطبيعية الثابتة "(99).
لقد آمنت الوضعية بمنهاج العلم التجريبي، ورفضت أي قضية لا تثبت بهذا المنهج، وذلك محاولة منها لغرس العقلية التي لا تفكّر إلا باصطلاحات علمية، وترفض قضايا الدين التقليدي، والغيبيات بكل بساطة على أساس أنها غير علمية.
ومن ناحية أخرى، فقد أثرت الوضعية على الاتجاهات النظرية التي سادت فيما بعد، فعلم الاجتماع الذي دعا إليه كونت، هو الذي أصبح علم الاجتماع السائد في الجامعات في أوروبا الغربية، والذي وصل إلى قمة تطوره التنظيمي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد كان الاتجاه البنائي الوظيفي هو الوليد الأكبر للوضعية. فهو لا يعدو أن يكون صياغات جديدة لأفكار ومسلّمات تنتمي إلى المؤسسين لعلم الاجتماع الوضعيين العضويين. لذلك فهو يعتمد على فكرة النسق العضوي، التي اعتمدت عليها النظريات العضوية.
ومع أن من أهم مظاهر علم الاجتماع الحديث تعدد الاتجاهات النظرية، إلاّ أنها تتغذى على المذاهب الفلسفية، التي من أهمها الوضعية والتطورية، وكذلك البرجماتية.
وقد اختلطت الوضعية والتطورية في دراسات علماء الاجتماع التي تتبع مسيرة الإنسان الفكرية والاجتماعية، حيث ساروا على خطى "كونت " الذي أعلن أن هدف علم الاجتماع عنده هو : "اكتشاف سلسلة التحولات الثابتة المتتابعة للعنصر الإنساني، الذي بدأ من مستوى لا يرقى عن مجتمعات القردة العليا، وتحوّل تدريجياً إلى حيث يجد الأوروبيون المتحضرون أنفسهم اليوم "(100).
وكما يتضح من هذه العبارة، فإن علم الاجتماع يضع المجتمع الغربي في القمة، ويسعى جاهداً إلى أن تحذو المجتمعات الأخرى حذوه. وهذا بالفعل ما أكدته النظريات والقوانين، التي توصّل إليها علماء الاجتماع "قديمهم وحديثهم "، حيث ركزت على مسيرة الإنسانية، خلال عمرها المديد، مؤكدين سيرها نحو الأحسن الذي يتمثل في حياة الإنسان الأوربي المعاصر.
وقد كان لفكرة التطور، التي انتشرت في أوروبا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، إضافة إلى فلسفة التاريخ، والإيمان المتزايد بقيمة العلم ومنهجه، الأثر الكبير في أن يتتبع علماء الاجتماع مسيرة الحياة الاجتماعية والفكرية، ويقدموها في شكل نظريات وقوانين.. من هذا القبيل، دراسة كونت الشهيرة عن قانون التقدم البشري، والذي عرف بقانون الحالات الثلاث.
لقد صرح "كونت" بأن الدين قد استنفد موضوعه، ولم يعد هناك ما يبرر وجوده، وقد أفسح المجال الآن للعلم الوضعي الذي حلّ محله، بل إنه رأى أن سبب الفوضى وعدم النظام يعودان بدرجة كبيرة إلى أن الفكر الديني والميتافيزيقي، لا يزالان يعيشان جنباً إلى جنب مع الفكر الوضعي، في حين أنه من المفروض أن يفسحا المجال له.
ويلاحظ على هذه النظرية ما يلي:
1- الإيمان بفكرة التطور الخطي حيث يحل الجديد محل القديم.
2- اعتبار الدين مرحلة أولى، يناسب العقلية البدائية، ولا يصلح للعقلية المعاصرة.
3- تعميم هذه النظرية وجعلها قانوناً عاماً، مع أنها تاريخ مشوه لمسيرة الإنسان الغربي الفكرية. فالمرحلة اللاهوتية تخص المسيحية الكاثوليكية، والمرحلة الميتافيزيقية تنطبق على فلسفة التنوير، والمرحلة الوضعية هي المرحلة الصناعية الحديثة.
ومن النظريات الحديثة التي سارت على خطى نظرية "كونت "، ما قدمه "سوركين" على أنه نظرية التواتر المتحول، والتي عرضها في مؤلفه الشهير "الديناميات الاجتماعية والثقافية "، حيث رأى أن كل مجتمع من المجتمعات البشرية، يمر بثلاث مراحل، يحكم كل منها نسق معين من الثقافة، ولكل ثقافة عدة مراحل يمر المجتمع بكل منها في خط مستقيم، ثم يتحول إلى الثقافة التي تليها، وهكذا حتى ينتهي من مراحل الثقافة الثلاث، وحينئذ يتحول المجتمع إلى الثقافة الأولى، وهكذا تدون الدورة.
وبغض النظر عن صدق أو عدم صدق هذه المراحل، فإن الملاحظ في هذه النظريات هو النظرة العدائية للدين، حيث تربطه دائماً بالمجتمعات المتخلفة، كما أن كل مجتمع متقدم، يكون قد تخلّص من الدين وثقافته وروابطه.
ويؤكد هذا أيضاً تالكوت بارسونز في نظريته التطورية، التي حاول خلالها أن يوسع نطاقها، بحيث تشمل التاريخ الإنساني بأكمله. وقد حدد ثلاثة مستويات تطورية تتيح كل منها وجود مجتمعات متنوعة ومختلفة:
المرحلة الأولى: وهي "البداية " ، وتنقسم إلى مرحلتين فرعيتين.
فيتميز المجتمع البدائي أولاً، بأن الدين وروابط القرابة يلعبان فيه دوراً بالغ الأهمية. وثانياً يشير النموذج المتقدم من هذه المرحلة، إلى المجتمعات التي تشهد نسقاً للتدرج الاجتماعي، وتنظيماً سياسياً، يقوم على وجود حدود إقليمية آمنة مستقرة نسبياً.
المرحلة الثانية: وهي "الوسيطة "، وتضم أيضاً نمطين فرعيين من المجتمعات:
(أ) المجتمعات القديمة التي تتميز بوجود "تعليم حرفي "، أي تعليم محدود وخاضع لتنظيم وسيطرة الجماعات الدينية في المجتمع.
(ب) النموذج المتقدم من المجتمعات القديمة، كمجتمع الصين والهند والإمبراطورية الرومانية، والدولة الإسلامية، حيث ينتشر ما سمي بالدين التاريخي.
المرحلة الثالثة والخيرة: "المتقدمة "، وتشير إلى المجتمعات الصناعية الحديثة(101).
وتلعب التطورات الحاسمة التي تطرأ على عناصر النسق القيمي، دوراً بارزاً في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.
إن هذه النظريات وغيرها من النظريات التي يعج بها علم الاجتماع، تهدف إلى إقامة فكرة التطور المطلق، وإنكار فطرة الدين والأسرة والزواج (102). وفي هذا نفي لقداسة الدين والأخلاق والأسرة، والتشكيك في قيمها، كما أنها تحمل دعوة لتحطيم الدين باعتباره عاتقاً عن التطور، ومرحلة مضت وانقضت من تاريخ البشرية.
وهي تحمل من ناحية أخرى، إلغاء مفهوم الإسلام القائم على إطار من الثوابت، في داخله حركة وتغيير.
والحق أن علماء الاجتماع يظهرون عداء للدين وأحكامه، الأمر الذي يظهر جلياً في نظرياتهم وأحكامهم. حيث اعتبروا أنفسهم ممثلين للعلم الذي يعتبر مضاداً للدين. وقد كانت المشكلة التي عالجها رواد علم الاجتماع واعتبرها جوهرية، كما قرر ذلك "ريموند أرون "، هي التناقض بين الاعتقاد الديني وبين العلم. "فدوركايم " مثلاً علماني، باعتباره أستاذاً للفلسفة، وقد وجد أن الدين التقليدي، لم يعد قادراً على مواجهة ما أطلق عليه الروح العلمية، كما أن أزمة المجتمع الحديث، هي في أنه لم يستطيع أن يستبدل الأخلاقيات التقليدية القائمة على الدين، بأخلاقيات قائمة على العلم، وكان يرى أن علم الاجتماع يستطيع أن يعاون في إقامة هذه الأخلاقيات (103).
و "باريتو " الإيطالي، كان مصراً طوال حياته على أنه عالم فقط، ولذلك اعتبر القضايا العلمية، هي ما يمكن التوصل إليها عن طريق المنهج التجريبي فقط. وأما غيرها من القضايا، وخاصة الأخلاقية، والميتافيزيقية، والدينية، فليس لها أي قيمة علمية، ومع أنه يؤمن بتأثير الدين في تصرفات الناس، إلا إنه يقول: "المرء لا يستطيع أن يفسر عن طريق المنهج المنطقي التجريبي الوضع القائم للنظام الاجتماعي، دون أن يدمر أساسه.
فالمجتمع يقوم عن طريق المشاعر، التي لا حقيقة فيها، إلا أنها ذات تأثير عظيم. إن عالم الاجتماع إذا كشف للناس ما يجري خلف أنظارهم، فإنه بذلك يخاطر بتدمير أوهام، لا يمكن الاستغناء عنها ". فهو يعتبر الدين أوهاماً لا يمكن الاستغناء عنها (104).
وهذا "ماكس فيبر" الألماني ينظر إلى التنظيم البيروقراطي والعقلاني على أنه قدر المجتمعات الحديثة. وكان يرى التناقض قائماً بين مجتمع يقوم على العقلانية، وبين الحاجة إلى الإيمان. وقد رأى أن الطبيعة كما يفسرها العلم وكما تعالجها التكنولوجيا، ليس فيها متسع لسحر الدين، وأساطيره القديمة. إن الإيمان يجب أن ينسحب ليعيش في عزلة مع الضمير.
ولقد رأى أن أهم ميزة للحضارة الغربية، هي غياب العقلية الغيبية القديمة، وسيادة الروح العقلية الرشيدة، لجميع جوانب الثقافة الغربية(105).
وهذا "ليفي بريل " (106) الفرنسي يسير على خطى الوضعية، فيرفض القول بمعيارية الأخلاق، لأنه رأى أن العلم لا يكون إلا وصفاً للأحداث الخلقية دون أن يتجاوز الوصف إلى تصوير ما ينبغي أن يكون. وقد أنكر عمومية المثل العليا، مستنداً إلى أن التجربة تشهد بأنها تختلف باختلاف الشعوب وعصورها. وزاد على ذلك حين رأى أن الأخلاق التقليدية تقوم على مصادرتين هما:
1- أن الطبيعة الإنسانية واحدة في كل زمان ومكان، ومن هنا أمكن وضع مبادئ عامة للسلوك الإنساني، في حين أن التجربة تشهد بأن طبائع الناس تختلف باختلاف زمانهم ومكانهم.
2- القول بالفطرة المطلقة، في حين أنه يرى أن الضمير وليد التجربة من ناحية، ونسبي متغير من ناحية أخرى.
ولذلك فقد رأى أن الظواهر الخلقية يجب أن تدرس دراسة موضوعية مستخدمة المنهج التجريبي، الذي تعالج به الظواهر الطبيعية المادية، وذلك لمعرفة قوانين الحقائق الاجتماعية، للسيطرة عليها ما أمكن ذلك(107). وهذا الرأي الذي يعتنقه "بريل" هو نفس الرأي الذي اعتنقه من قبله "دوركايم "، حيث حاول إقامة علم للأخلاق على أساس وضعي، فقد نظر إليها نظرة نفعية، وتصورها روابط تشيع التماسك في المجتمع وفي ذلك يقول: "لقد استقر عزمنا على أن تكون التربية الخلقية التي نلقنها لأبنائنا في المدارس، ذات صيغة دنيوية محضة. ونعني بذلك التربية التي لا تستند إلى المبادئ التي تقوم عليها الديانات المنزلة، وإنما ترتكز فقط على أفكار ومبادئ يبررها العقل وحده، أي أنها في كلمة واحدة: تربية عقلية خالصة "(108).
كل ما سبق ذكره يصب في قالب واحد يسمى: "العلمانية "، فقد تغلغلت العلمانية في علم الاجتماع عن طريق منهجه، وتكوين رواده الغربيين العقدي. يقول المستشرق "أربري " عن العلمانية: "إن المادية العلمية والإنسانية، والمذهب الطبيعي، والموضوعية، كلها أشكال للادينية، واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكا ".
وفي المعجم الدولي الثالث الجديد، مادة ""Secularism :
"هي نظام اجتماعي في الأخلاق، مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة، والتضامن الاجتماعي، دون النظر إلى الدين "(109).
والعلمانية تعني صراحة، كلفظ في اللغات الأوروبية: "اللادينية " أو "الدنيوية "، وهي تعني ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد(110).
لقد درس علماء الاجتماع الدين على أنه واحد من النظم الاجتماعية الكثيرة الموجودة في المجتمع، مهمته توفير الوحدة الجماعية، كما يقول "دوركايم"، وهذه نظرة تتفق مع الفلسفة الرأسمالية الحديثة، بمعنى أن الدين والدولة شيئان منفصلان تربطهما علاقة تعاون(111).
فمثلاً يذهب أودييه في كتابه المعنون "علم اجتماع الدين "، إلى أن الدين، أحد البناءات النظامية الهامة في أي مجتمع، وأن الدين يختلف عن الحكومة التي تهتم بالسلطة والقوة، ويختلف أيضاً عن النظام الاقتصادي الذي يهتم بالعمل والإنتاج والتسويق، ويختلف عن نظام الأسرة المسؤول عن تنظيم العلاقات بين الجنسين، وبين الأجيال.. كما يرى أيضاً أن الاهتمام الرئيس بالدين يبدو وكأنه اهتمام بشيء غامض، ليس من اليسير إدراك حقيقته الواقعية. أي أن الدين - في نظره - يهتم أصلاً باتجاهات الإنسان نحو ما هو فوقي، والتنظيمات العملية لما هو فوق الحياة البشرية. فلقد حدد الدين على أنه المجسد لكل الإلهامات الرفيعة، كذلك فهو حصن الأخلاق، ومصدر النظام العام، وسلام الفرد الداخلي (112).
والحق، فإن اعتبار الإسلام أحد النظم العديدة في المجتمعات الإسلامية، ليس خطأ فحسب ولكنه تحريف لمعنى الدين الإسلامي. فهو بهذا المعنى لا يتعدى كونه ظاهرة اجتماعية، نشأت من المعيشة في جماعة، ويعادل في أهميته الظواهر الاجتماعية الأخرى التي يعرفها المجتمع.
بينما الحقيقة، أن الدين الإسلامي، بناء شامل يضم جميع الأبنية الفرعية كالاقتصاد، والأسرة، والسياسة، وغيرها من الأنظمة. كما يشمل في الوقت ذاته الإطار التصوري العقدي، ويشمل أيضاً العبادات ومختلف الطاعات.
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ولا شك أن وراء هذا الاختلاف تقف المعايير التي يسير على ضوئها هذا العلم، ونقصد بها الموازين التي تزن وتقوِّم الأبحاث الاجتماعية.
ويهمنا في هذا المقام، أن نتحدث عن معيارين، كان لهما الأثر الكبير في إعاقة الاتفادة الكاملة من علم الاجتماع بالنسبة للمسلمين، مما يحتم بعد ذلك دفع عملية الصياغة الإسلامية إلى الأمام، خصوصاً ونحن نعرف أن هذا العلم مرتع لتعدد وجهات النظر.
وهذان المعياران هما:
1- الدقة العلمية والتحليل الموضوعي.
2- الارتباط الوثيق بالفلسفات والعقائد المختلفة.
وسيكون الحديث في البداية عن عرض ومناقشة المعيار الأول، ثم نتكلم بعد ذلك عن المعيار الثاني.
المعيار الأول
الدقة العلمية والتحليل الموضوعي
ويعني هذا المعيار: أن المجتمع بظواهره ومشاكله، يعتبر موضوعاً لعلم " Science " هو علم الاجتماع.
والعلم، مصطلح يعني: الدراسة الموضوعية المنظمة للظواهر الواقعية، وما يترتب على ذلك من بناء للمعرفة. وعليه فإنه يتميز بالخصائص التالية، وهي : أنه منظم، وموضوعي، وواقعي "أمبريقي ".. ويقوم العلم على دعوى جوهرية، محصلتها أنه من الممكن استقاء المعرفة بالعالم من خلال الحواس، وأن صدق هذه المعرفة يتأكد بواسطة الملاحظات المتشابهة التي يقوم بها كثير من الأشخاص. وأنه من الممكن -نسبياً - التحكم في تحيز الملاحظ وقيمه الشخصية، حتى تتوافر درجة ملائمة من الموضوعية (55).
وقد قاد هذا المفهوم للعلم إلى التأكيد على قيمة الموضوعية العلمية التي لا تعني النزاهة والأمانة فقط، ولكنها تتعدى ذلك إلى التخلص من ضغوط الأهواء السياسية، والذهنية والفكرية، وعدم الخضوع أو الأخذ بأي نظرية أو فكر اجتماعي، أو سياسي، عند بحث أي ظاهرة، وتقتصر على رؤية العالم كما يبدو بالفعل، وتكتفي بملاحظة الظواهر المشاهدة فحسب، مما يعني تنحية القيم، حيث يعتبر مفهوم القيمة مفهوم غير ضروري، وغير مرغوب فيه، في علم الاجتماع كما يقول أدلر (56) (57).
وتعني دراسة الظواهر الاجتماعية دراسة علمية، أن تدرس بعيداً عن الفلسفات التأملية، والعقائد الدينية، فالدراسة العلمية تعتمد على الملاحظة والتجريب فحسب، وتقابلها الدراسة الدينية والفلسفية والفنية التي تعتبر غير علمية. ولكنها ربما تزودنا بنوع من المعرفة، إلا أنها على كل حال غير علمية (58).
نشأة الدراسة العلمية
للظواهر الاجتماعية "الموضوعية" ورسوخها
لقد نشأت المطالبة بالدراسة العلمية للظواهر الاجتماعية، باعتبار هذه الدراسة متميزة عن الدراسة الدينية والفلسفية، في أجواء الثقافة الغربية، حيث تأثر الباحثون في الشؤون الإنسانية، بالنجاح الذي حققه المنهج العلمي في العلوم الطبيعية والبيولوجية. فقد نجح العلم الطبيعي في كشف ظواهر الكون، والسيطرة عليها، بعد أن تخلص من هيمنة الكنيسة الكاثوليكية، قبل عصر النهضة، التي كانت ترى أن غاية البحث هي فهم كلمة الإله في الكون. وعين الضلالة عندها هي: البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدس، حيث يقول أحد الآباء: "لو كان هناك احتمال للوصول إلى الحقيقة عن طريق البحث والدراسة، لكنا قد توصلنا إليها من زمن بعيد، وبما أنه لم يتوصل إليها برغم ما ضاع في سبيل ذلك من وقت وجهد، فمن الواضح الجلي إذاً أن الحكمة والحقيقة لا وجود لهما "(59).
وقد استخدمت الكنيسة العنف في سبيل حمل العلماء على اعتناق هذا المبدأ، مما ولد عندهم ردة فعل ضدها، فاستبدلوا مبدأ آخر بمبدأ الكنيسة فحواه: أن المعارف يجب أن تنمى عن طريق ما يمكن أن يلاحظ، أو ما يمكن جعله قابلاً للملاحظة. . وكانت الروح المميزة للقرن الثامن عشر، هي روح المشاهدة، والدقة، والمراقبة، وإجراء التجارب، واستنباط القوانين العامة الواضحة والدقيقة، وكما يقول أحد المؤرخين:
"لقد انشغل الناس بالمنهاج المعصوم من الخطأ "المنهج العلمي"، وخُيل إليهم أنه لم يبق من مهمة سوى أن يسحبوا المنهاج العلمي الذي ولد على يدي ديكارت (61) ونيوتن (62)، ليغطي تلك المناطق التي لا تزال خاضعة للخرافات وعدم الانتظام "(60).
ونظراً لنجاح المنهج العلمي في كشف الظواهر الطبيعية، فقد أفترض أن هذا المنهج سيحقق نفس النجاح في كشف حقائق الظواهر الاجتماعية، لأنها طبيعية يجب إخضاعها لنفس المنهج، حتى يمكن التحكم فيها. ومن هنا بدأ العلماء يدرسون الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي السالف، وأصبح هذا المنهج ركيزة من ركائز علم الاجتماع، تقاس قيمة الأبحاث، بقدر تمسكها به. وعلى كل حال، فقد سيطرت الفكرة القائلة: بأن نجاح علم الاجتماع خاصة، والعلوم الاجتماعية على وجه العموم، وتقدمه، رهن بقدرته على استخدام مناهج العلوم الطبيعية، وطرق البحث فيها، وبخاصة استخدام القياس، والإحصائيات، والاستبيانات، والجداول، وغيرها.
ومن هنا فقد كثر الحديث عن المقارنة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، الذي ينتهي غالباً بتأكيد أن الفرق بينهما هو فرق في الدرجة فقط (63).
بمعنى أن العلوم الاجتماعية، ستصل يوماً ما إلى ما وصلت إليه العلوم الطبيعية، من دقة، فهذا أحدهم يقول: "إن المنهج العلمي إنما ينحصر في المشاهدة، والتجريب، مشاهدة الوقائع البسيطة، لا الغليظة (المعقدة) حيث إن الواقعة العلمية هي التي يمكن إجراء التجارب عليها " (64).
ويقول آخر: "إن المعرفة التي لا يمكن قياسها، هي معرفة هزيلة، وغير مقنعة "(65).
والحقيقة أن الاقتناع السابق بضرورة دراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهاج العلمي، ظهر تدريجياً، ولم يظهر دفعة واحدة، فلما جاء كونت أعلن علمية علم الاجتماع، ووضعه على رأس القائمة عند تصنيفه للعلوم، واعتبره علماً طبيعياً. فقد كان يقيس الأشياء جميعها بمقياس العلم، الذي يعتبره الصيغة الوحيدة للمعرفة الإنسانية. وقد رفض اعتبار اللاهوت والميتافيزيقا مجالات للمعرفة، بناء على أنه لا يمكن تبرير ما تدعيه من معرفة، بمنهج البحث العلمي(66).
وهذا أمر طبيعي أن يصدر من رائد الوضعية، التي تكتفي بملاحظة الظواهر المحسوسة فقط.
ويمكن تحديد الملامح العامة لمنهج كونت في القضايا الرئيسة التالية:
1- إن الحقيقة تنحصر في كل ما هو متاح أمام إدراك الحواس.
2- إن العلوم الطبيعية والاجتماعية تشترك في أساس منطقي ومنهجي واحد.
3- أن ثمة فرقاً جوهرياً بين الواقع والقيمة، فالعلم يتعامل مع الواقع فقط، وأما القيمة فإنها تعكس نظاماً للظواهر، يتميز باختلافه التام، وخروجه عن نطاق العلم(67).
وهذه الدراسة الوضعية للظواهر الاجتماعية، التي أكدها كونت، صارت فيما بعد عقيدة أساسية في المناهج الاجتماعية المعاصرة. حيث يحذر الباحثون من الوقوع تحت طائلة التعصب لأقوامهم، أو أديانهم، أو وجهات نظرهم الخاصة. ويكتفون فقط باستنباط افتراضاتهم ونظرياتهم من النتائج التجريبية فحسب. وعليه، فما لا يمكن تحقيقه بالتجربة، فهو تأملي تماماً كما يفعل علماء الطبيعة (68).
ولعل "دوركايم " كان أكثر علماء الاجتماع اجتهاداً في تحديد كيفية دراسة الظواهر الاجتماعية، وقد ألف كتاباً في هذا الموضوع سماه: "قواعد المنهج في علم الاجتماع "، حدد فيه خواص الظاهرة الاجتماعية. ثم بين القواعد الخاصة بملاحظة الظواهر الاجتماعية.
وقد كانت أولى القواعد، وأكثرها أهمية -على حد تعبيره- هي أنه يجب ملاحظة الظواهر الاجتماعية على أنها أشياء.
ويعني بذلك أن على عالم الاجتماع أن يسلك مسلكاً شبيهاً بالمسلك الذي ينهجه كل من عالم الطبيعة والكيمياء، أو وظائف الأعضاء، حينما يأخذ في دراسة بعض الظواهر، التي لم تكتشف بعد في دائرة اختصاصه العلمي (69). وذلك على أساس أنها أشياء تقدم نفسها للملاحظة، كنقط بدء للعمل.
وقد أضاف قواعد متممة لهذه القواعد كانت أولاها: أنه يجب على علام الاجتماع أن يتحرر بصفة مطردة من كل فكرة سابقة(70). ويعني بذلك التحرر من سيطرة الأفكار الشائعة، وإسكات المعتقدات والعادات الأخلاقية مؤقتاً، إلى حين الانتهاء من دراسة الظاهرة. كما يجب عليه أن يزيح عن كاهله تلك الآراء البدهية الكاذبة، التي تسيطر على قعول العامة من الناس، ويحذر قواعد التفكير التقليدي، وهي تلك القواعد التي تنقلب مستبدة قاهرة في نهاية الأمر، وذلك بسبب شدة إلفه إياها. وإذا اضطر إلى استخدامها، فلا بد أن يتذكر أنها قليلة الجدوى، حتى لا يعطيها أكبر من حجمها أثناء بحثه(71).
ويقول أحد أساتذة علم الاجتماع عن جهود دوركايم في ترسيخ المنهج العلمي في علم الاجتماع: "وجدير بالذكر أن دوركايم حين يسعى إلى إقامة علم الاجتماع على أسس علمية، إنما هو في الحقيقة يعيد صياغة أفكار سبقه إليها سان سيمون، وكونت، وسبنسر، ولكن الشيء الوحيد الذي يؤكده دوركايم: هو أن هؤلاء لم ينجحوا في فصل علم الاجتماع عن الفلسفة والتصورات الميتافيزيقية.
فهو وإن كان يؤمن بالمنهج الوضعي، إلا أنها ليست تلك الوضعية الميتافيزيقية، التي تبناها كونت، وسبنسر، حيث نظرا إلى الظواهر الاجتماعية بوصفها تسير عبر خط تطوري وتقدمي واحد (72).
ويعني هذا أن دوركايم أوغل في علمية علم الاجتماع، إلى درجة أبعد مما وصل إليه كونت.
وامتداداً لدراسة الظواهر الاجتماعية بالمنهج العلمي، ظهرت النظرية الوضعية المحدثة في علم الاجتماع، التي اعتبرت المناهج غير الكمية في دراسة السلوك الإنساني شديدة السطحية، على خلاف المنهج الكمي الذي يعتبر العد والقياس منهجاً لا غنى عنه للبحث العلمي في أي ميدان.
وعلى كل حال فإن علم الاجتماع، لم يتجاوز ما وضعه له كونت من أسس، بالرغم من تعدد نظرياته. فهذه النظريات جميعاً تؤكد علميته نفسها. وتتفهم تلك العلمية كاعتماد على المحسوس دون غيره. وكما يقول تيماشيف: "فلقد كان الهدف الأساس للرعيل الأول من علماء الاجتماع، هو إرساء الدعائم العلمية لدراسة المجتمع. ونحن نعتقد أن أغلب علماء الاجتماع خلال مراحل تطوره المختلفة، كانونا يسعون إلى تحقيق هذا الهدف (73).
أوجه الاعتراض على هذا المعيار:
يمكن حصر الاعتراضات على هذا المنهج، في ثلاث نقاط:
1- خطأ التسوية بين الظاهرة الطبيعية، والظاهرة الاجتماعية.
2- الحياد حيال القيم.
3- عدم الواقعية في هذا المعيار.
و نبدأ بالاعتراض الأول:
1- خطأ التسوية بين الظاهرة الطبيعية، والظاهرة الاجتماعية:
لقد كان الخطأ الأساس في المنهج العلمي الذي تبناه علم الاجتماع، هو التسوية بين البحث في الظاهرة الاجتماعية والظاهرة الطبيعية، علماً بأنه لا مجال للاتفاق بينهما، فبينما يمكن الوصول إلى حقيقة الظاهرة الطبيعية، حين تنفصل عن سياقها الزماني والمكاني، الذي تقع فيه، فإن الوصول إلى حقيقة الظاهرة الاجتماعية، يستحيل، حيث تجرد من سياقها الزماني والمكاني، وحين تسلب من محيطها الديني الخلقي والاجتماعي الذي يتحكم في حركتها(74).
إن أي ظاهرة إنسانية، اجتماعية كانت أو فردية، لا تتكون من عناصر مادية خالصة، يمكن ملاحظتها بالحواس، ومعرفة كمها وقياسها، بل هناك عناصر أهم تتدخل في تكوينها والتحكم فيها وهي العناصر المعنوية والروحية، ولا يكتمل وصف الظاهرة الإنسانية دن الرجوع إليها، كما لا يمكن ردها إلى المحسوس، ولا يمكن عزلها ولا فصلها عن محيطها. كما لا يمكن أيضاً إخضاعها للقياس الكمي الذي لا يعرف العلم غيره، ولا تخضع لقانون ثابت أبداً، وفي هذا المجال يمكنني أن أضرب هذا المثال:
إن الشعور بالفقر والحرمان والإخفاق، قد يسلم صاحبه إلى اليأس والقنوط من الحياة، ومن ثم الانتحار هرباً من مشاكله. كما يؤدي بإنسان آخر إلى الجد والاجتهاد والثبات، وحضور المل، وبالتالي قهر المشاكل والتغلب عليها.
ومرد ما سبق إلى اختلاف الشخصين في مدى حظهما من الإيمان العميق، وسلامة الشخصية، وسداد التفكير، ونوع التربية (75).
ومن ناحية أخرى، فإن الظواهر الاجتماعية لا تتشابه، بل تختلف باختلاف الجماعات الإنسانية، حيث تعتمد على تقاليد الثقافة والدين، وعلى الهوى الشخصي والجماعي، الذي لا يمكن تحديده بشكل شامل (76).
ومن هنا فإن تحديد مادة العلم بما يمكن رصده وقياسه، يعتبر انتقاصاً لجانب الحقيقة، التي تشتمل على جانب آخر لا يقاس.
فعلماء الاجتماع الذين يتمسكون بالمنهج العلمي، كما ورد سابقاً يؤمنون بعالم الشهادة فقط، وهو العالم الذي تدرك الحواس جزئياته في الحياة الأرضية، وما يحيط بها من كون مادي، ولا شيء قبل هذا الكون المادي المشاهد، ولا شيء بعده، فلا يعالج ما وراء الطبيعة، ولا يتعامل مع عالم الغيب، كما يرفض الوحي السماوي بصورة مطلقة، ويهدم حقيقة النبوات والمعجزات، ولا يؤمن إلا بما هو محسوس.
أمثلة على التسوية بين الظاهرتين:
نظراً لاعتماد علم الاجتماع على المنهج العلمي، الذي يسوي بين الظواهر الاجتماعية والظواهر الطبيعية، مع خطأ التسوية بينهما، فقد كثرت الأخطاء في البحوث الاجتماعية، خصوصاً عند تناولها للدين.
ولعله من المناسب هنا أن نورد رأي محرر دائرة معارف العلوم الاجتماعية، عند حديثه عن الدين، لنوضح أن المنهج العلمي عند علماء الاجتماع الغربيين، ليس كاملاً بل ينقصه التعامل مع عالم الغيب.
فقد رأى أنه يمكن تشبيه "الدين " بـ "الفن "، فكما أن بعض الناس يتمتعون بقوة غير عادية في التذوق الفني، كذلك ينفرد بعض الناس بخصائص "العيون والآذان الداخلية "، يلتقطون بها ما لا يتمكن الإنسان العادي من سماعه أو رؤيته. وهذا الشيء هو الذي قاد الإنسان إلى تجارب الدين(77).
ويكتب آخر: "إن خصائص الدين المتعلقة بما بعد الطبيعة، لا معنى لها إذا نظرنا إليها بمفهومها الديني. أما إذا أعطينا هذه الحقائق لغة المجاز، فإنها قد تصبح ذات معنى مثلما نقول على شخص ما إذا اكتشف شيئاً جديداً: "لقد كان هذا إلهاماً"، فهكذا "يتنزل" الإلهام على الشاعر، وكذلك على النبي "(78).
ويرى أيضاً أن الوحي، لا معنى له إذا نظرنا إليه على أنه كلمات الله التي نقلها أحد الملائكة إلى إنسان مخصوص. بل إن أمر الوحي يكون مفهوماً لو قلنا عنه: إنه "ضوء البصيرة الداخلية ". لأننا نعرف أن الفنان أو المفكر كليهما تخطر له بصورة خاطفة، أفكار من نوع ما، وهكذا الحياة بعد الموت، يمكن فهمها في لغة تمثيلية، أما إذا نظرنا إليها بالمفهوم اللفظي الظاهري، فإنها تصبح بدون معنى، وذلك لأننا نعرف أن الجسم تنتشر أعضاؤه بعد الموت، وتنتهي معه الروح، ففي ضوء هذا الأمر تكون الحياة بعد الموت غير مفهومة بمعناها اللفظي (79).
ولعل من أشهر من درس الدين من علماء الاجتماع "دوركايم "، الذي ألف كتاباً بعنوان "الصور الأولية للحياة الدينية " عام 1912م، حاول فيه تطبيق المنهج العلمي السابق على دراسة الدين في أكثر صوره أولية.
والحق أن أصل الدين، لا يمكن أن يستخلص من دراسة مجموعة الطقوس والشعائر الدينية، حين تدرس بمنهج الملاحظة الاجتماعية أو الأسلوب الإحصائي، أو دراسة الحالة، أو المسوح الاجتماعية، وغيرها من مناهج علم الاجتماع، وأي دراسة من هذا القبيل لا تستعين بالوحي، فإنما هي ضرب من الحدس والتخمين، لا تمتُّ إلى العلم بصلة، وذلك لأنه لا سبيل إلى البحث في أصل الدين ونشأته عن طريق التجربة، والبحث العلمي، لبعده عن حيز المشاهدة، وارتباطه بالزمن الماضي البعيد، لذلك فلا مندوحة عن استعمال التأمل والتفكير المجرد، الذي كثيراً ما تندس خلاله العناصر الشخصية، غير العلمية، بحيث تسيطر على الباحث فكرة سابقة، لا يستطيع التخلي عنها حتى ولو حاول، فإذا انطلق الملحد ليبحث في أصل الدين، فلا يمكن أن يتحرر من فكرته عن الدين. وكذلك من يحمل فكرة خاطئة عن الدين، كعدم التمييز بين السحر والدين، أو عدم التمييز بين وجود الله في ذاته، وفكرة الإنسان عن الله وعقيدته به.
وغالبية علماء الاجتماع من الغربيين، لا يستطيعون التخلص من ردة الفعل، التي أحدثتها عندهم المسيحية المحرفة، حيث أورثتهم عداء للدين عامة، نتيجة لطبيعتها في ذاتها عندما حرفت، ونتيجة لمحاربتها للعلم وأهله، ومصادمتها للعقل. ومن هنا فقد كانت بحوثهم عن أصل الدين خاطئة ومضللة، ومخالفة لحقائق القرآن الكريم.
وعلماء الاجتماع يسوون بين نوعين من الموضوعات والنظريات والحقائق في البحث، مع اختلافهما الواضح، ومن المهم جداً التفريق بينهما:
1- الحوادث الاجتماعية التي هي تحت سمعنا وبصرنا، مما يمكن مشاهدته، وجمعه، ودراسته، ووصفه، وتصنيفه.
2- الأمور التي لا يمكن إخضاعها لطرائق البحث العلمي الدقيق، وذلك كالبحث في نشأة الأديان، وأصول اللغات، وما إلى ذلك (80).
فالأمر الثاني تحدثنا عنه فيما سبق، وعرفنا كيف تخبط علما الاجتماع في دراسته. وقد كثرت فيه النظريات واختلفت، وجميعها لا تمتُ إلى العلم بصلة. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن موضوعاً كالظواهر الدينية بالنسبة لكل دين عند المؤمنين به، وذلك كالفرق الإسلامية مثلاً، لا تعتبر من هذا الصنف، بل تكون مندرجة تحت الصنف الأول، وكذلك تطور اللغات وأصواتها ومعاني مفرداتها وتراكيب جملها، فإنها من الأمور المشاهدة التي يمكن جمعها والنظر فيها، ومقارنة بعضها ببعض.
وأما بالنسبة للصنف الأول، فإنه يمكن دراسته، والوصول فيه إلى نتائج صادقة وصحيحة، إلا أنها لا تبلغ ما تبلغه نتائج البحوث الطبيعية من صدق وصحة. علماً بأن المنهج المتبع حالياً لا يخلو من ملاحظات.
ويمكننا أن نلخص ما سبق في: أن مصدر المعرفة بالواقع الاجتماعي، لا يقتصر على المنهج العلمي المتمثل في التجريب والتحليل وحده، بل هناك مصادر أخرى لاكتساب المعرفة، أهمها الوحي، إضافة إلى الإلهام والحسد، كما أن الواقع الاجتماعي نفسه، ليس مقصوراً على الشاهد المحسوس فقط، بل إنه يشتمل على المعنويات والروحانيات التي لا تحس ولا تقاس. وإذا قصرنا الواقع على ما يلاحظ ويحس، فإننا بذلك نستبعد القيم الأخلاقية والدينية، التي تعتمد على معايير محددة سلفاً.
2- الحياد حيال القيم:
إن المنهج العلمي يؤكد الحياد حيال القيم من قبل الباحث، حتى لا تغطي عقيدته الموجهة، وأمانيه ورغباته على حقيقة الواقع الاجتماعي، تحقيقاً للموضوعية الكاملة. وليس معنى هذا أن عالم الاجتماع شخص بلا قيم، ولكنه يعني - كما يرى علماء الاجتماع - أن يبذل الباحث جهداً لكي يعلق قيمه كما يعلق معطفه، فما دام خاضعاً لاعتبارات الخطأ والصواب، فإن تصوراته ومقاييسه الخاصة عن الحقيقة، سوف تتسلل إلى بحوثه وتحليلاته الاجتماعية. وقد خصص عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، جزءاً كبيراً من اهتمامه لمعالجة هذا الموضوع، وقد شدد على الابتعاد عن خطر الأحكام الأخلاقية، التي تعتبر من مشوهات نتائج الدراسة، وذهب إلى أكثر من هذا حين دعا إلى الإقلاع عن كل فكرة إصلاح، أو تقويم، فعالم الاجتماع في رأيه ليس مصلحاً اجتماعياً ولا نبياً. وأكثر ما يجب عليه هو أبحاث تفيد المعرفة كمعرفة (81).
فليس من حق الباحث في علم الاجتماع، أن يصدر أحكاماً تقويمية، فيقول: بأن هذا السلوك أو هذه الظاهرة صحيحة أو معتلة، ويجب تقويمها أو المحافظة عليها.
وبذلك تكون مهمة عالم الاجتماع: الملاحظة، والوصف، والتحليل، والتفسير فقط، ولا يجوز له أن يعدوها إلى إيرها، كأن يقف موقفاً نقدياً، أو أن يبدي وجهة نظر معينة، أو يصدر حكماً تقويمياً.
ومع أن هذه الدعوة مستحيلة التحقق، نظراً لأن مواضيع علم الاجتماع تتعلق، بالنسبة لأي باحث، بميوله، ورغباته، وعقيدته، وحبه، وبغضه، إلا أنها تشكل مبدأ هاماً من البحث في علم الاجتماع، وعلى حد تعبير جولدتر فقد اتخذت هذه الدعوة شكل وصية تقول: "لا تصدر حكماً تقويميا ً"، وهي وصية تمتلئ بها الآن كل الكتب المدرسية (82).
ونظراً لأن علم الاجتماع يأمر الباحث بإخفاء عواطفه وميوله ومعتقداته، في سبيل الوصول إلى الحقيقة، "التي يظن أنها خارج الذوات والرغبات والمعتقدات، وأنها لا علاقة لها بما يشعر به الإنسان، أو يدركه، أو يحياه، بل هي في عالم منفصل عن الإنسان، وتدرك عن طريق التجربة والملاحظة "، فإن علم الاجتماع، في نظر علمائه، يؤدي خدمة جليلة، وذلك بتوعيتنا بنسبية القيم والأخلاق، وأساليب السلوك الشائعة في عالمنا الإنساني. وإدراك هذه الحقيقة هو بداية الطريق نحو إكسابنا القدرة على فهم القيم، وأساليب السلوك الشائعة، عند أبناء مجتمعات وثقافات غريبة عن مجتمعنا وثقافاتنا، وتمكيننا من الإحساس بحقيقة مشاعر غيرنا من البشر. ويعني هذا: التخلي عن الشعوبية، ومشاعر التمركز حول السلالة (83).
ويعني هذا أيضاً في النهاية: تلك العبارات التي ذكرها عالم الاجتماع الأمريكي "ويليام سمنر (84)، ومؤداها، أن الأعراف تصنع الصواب"، وكان يقصد بذلك أن مفاهيم الصواب والخطأ والخير والشر تعتبر نسبية، وأن الذي يضفي عليها النسبية، هي المعايير والعادات الشعبية السائدة في نظام اجتماعي معين. فالزنا يعتبر سلوكاً انحرافياً يوجب العقوبة التي تصل إلى حد القتل في مجتمعنا، ولكنه لا يعتبر كذلك في مجتمعات أخرى، فمصر القديمة مثلاً كانت تنظر إلى الاتصال الجنسي بين أبناء الصفوة، بوصفه سلوكاً لا يخضع للتحريم (85).
وعندما يعلق عالم الاجتماع قيمه، كما يعلق معطفه، فإنه يتحاشى البت في مثل عادة بعض قبائل الأسكيمو "الذين يعلقون الرجل المسن الذي يعجز عن الصيد، على حائط، أو يلقون به في البحر ليموت "، من ناحية الصواب والخطأ، ويكتفي بالقول: إن مستويات الصواب والخطأ، والحسن والرديء، تنسب إلى الثقافة التي تظهر فيها، فما يكون صواباً في مجتمع ما، قد يكون خطأ في مجتمع آخر. فقتل الأطفال الذي توافق عليه بعض الجماعات تحت ظروف خاصة، يعتبر إجراماً في جماعات أخرى، والعفة قبل الزواج مطلوبة في أحد المجتمعات، وغير مستحبة في الآخر. و بناءً على ذلك، فإن الصواب والخطأ يعتمدان على ما يتقبله الناس على أنه كذلك، ويصبح بإمكان الثقافة أن تجعل أي شيء صواب أو خطأ، بالنسبة لأعضاء مجتمع معين، ويصبح معنى الأخلاق: "ما هو أخلاقي بالنسبة لنا " (86).
إن الاختلاف بين المجتمعات في معتقداتها وعاداتها ونظمها، واقع يُشاهد ويُوصف. ولكن عالم الاجتماع المسلم لا يختلف عنده الحكم عليها عن وصفها وصفاً حقيقياً مطابقاً للواقع، وذلك لأنه يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يملك الحقيقة المطلقة، وهي الإسلام، الذي ارتضاه الله للناس كافة، فليس الواقع الاجتماعي شيئاً، إذا لم يكن خروجاً على قيم الإسلام، أو دخولاً في قيمه (87) ومن ثم فهو لا يغفل ما ينبغي أن يكون عليه الواقع المدروس: ((كُنتم خير أمّةٍ أخرجتْ للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عنِ المُنكر وتؤمِنون بالله ))
[آل عمران:110].
فالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، من أبجديات إسلام المرء، ولا يعفيه من هذه المسؤولية كونه عالم اجتماع، أو اقتصاد، أو طب، أو هندسة، بل الجميع يتحملون مسؤولية جعل كلمة الله هي العليا. وإن المسؤولية لتتضاعف إذا علمنا أن "العلماء ورثة الأنبياء "، وقد بعث الله الأنبياء والرسل لا لمجرد التبليغ والإعلام فقط، بل لطاعتهم فيما جاءوا به، ((وما أرسلنا مِن رّسولٍ إلاّ لِيُطاع بإذنِ الله )) [النساء:64].
فمهمتهم هداية الناس لمنهج الله، وكذلك العلماء يتحملون هذه المهمة بعد أن ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي.
وما كان الأنبياء يكتفون بوصف ومعرفة أحوال المجتمعات، بل كان كل منهم رافضاً لكل انحراف، وداعياً إلى ما يحمله من خير:
((وَلقد أرسلنا نوحاً إلى قومِه إنّ لكم نذيرٌ مبينٌ، ألاّ تعبدوا إلا الله )) [هود:25-26].
((وإلى عادٍ أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مِّن إلهٍ غيره )) [هود:50].
((وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ))[هود:61].
((وإلى مدْين أخاهم شُعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المِكْيال والميزان )) [هود:84].
إن عالم الاجتماع المسلم له أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فهو مشغول دائماً بقضية الإسلام، سواء بدعوة غير المسلمين إليه، أو رصد حركة المجتمع المسلم السلبية والإيجابية، فيقوّم السلبي، ويعزز الإيجابي. فهو لا يقف عند فهم وتحليل الوضع الاجتماعي فحسب، بل يتعداه إلى تغييره وتحويله إلى وضع يقوم على هدي الإسلام الحنيف. فهو ناقد، ومقوم في الوقت نفسه، إضافة إلى أنه علمي في منهجه، لا يكف عن البحث عن الحقيقة.
3- عدم الواقعية في هذا المعيار:
في ملاحظاتنا السابقة على المنهج العلمي في علم الاجتماع، لاحظنا الحرارة الزائدة عند الحديث عن قيم الباحث وحياده حياله، وفي هذه الملاحظة نتساءل: هل طبق علماء الاجتماع الغربيون هذا المبدأ؟
لقد كشف علم اجتماع المعرفة، عن تداخل مجموعة كبيرة من العوامل المرئية وغير المرئية في تشكيل فكر الباحث. فالباحث لا يستطيع الانفلات من معتقداته وقيمه،والظروف المحيطة به، بل إنها تؤثر تأثيراً كبيراً لا على رؤيته للحقيقة الاجتماعية فحسب، بل حتى على انتقائه لموضوعات دراسته. وإذا عرفنا أن عالم الاجتماع يبحث المواضيع المتصلة بالقيم والدين والمعتقدات، وكذلك مواضيع أنظمة الحكم، والأسرة، والاقتصاد، والاجتماع، عرفنا إلى أي درجة يلتصق عالم الاجتماع بموضوعات بحثه. وإنه لا يمكن إلا أن يكون إنساناً عادياً تجاهها. فكما أن الإنسان العادي يتأثر بأوضاعه الدينية والاقتصادية والأسرية، فكذلك عالم الاجتماع لا يمكن أن يتحرر من كل ذلك.
لقد أكد "جون ديوي (88) أن الإدراك، وهو أول ثمرة للملاحظة الحسية، لا يمكن أن يكون محايداً، وإنما يتأثر دائماً بخلفيات الملاحظ السابقة، وحظه من المعرفة، وبذكائه "(89).
ومن هنا، فإن أحكام الباحثين تتأثر بنظرياتهم، وفروضهم، وخلفيتهم المعرفية، وهذا هو السبب الذي دعا روبرت مرتون (91) لأن يعترف بأن في الولايات المتحدة خمسة آلاف عالم، لكل واحد منهم علم الاجتماع الذي يخصه (90) وحده، وذلك نتيجة تعدد العقائد الخاصة بكل عالم، رغم انتماء غالبيتهم إلى عقيدة المجتمع الرأسمالي.
ورغم اعتراف ميرتون السابق، واعتراف غيره بتعدد علوم الاجتماع، فإنه يذهب مع غيره من العلماء مثل لا زارس فيلد، وتالكوت بارسونز (92) إلى أنهم يعتبرون أنفسهم علماء اجتماع علميين، يقومون بدراسات نظرية وأمبريقية بحتة، لا علاقة لها بعقيدة سياسية أو غيرها. ومع هذا فإن الواقع يكشف عن أن الدراسات التي قام بها عالم غربي في مجتمع غربي، هي بالضرورة غربية، لا تنطبق على مجتمعات المسلمين.
ومن ناحية أخرى، فإن علماء الاجتماع، لم يكونوا منعزلين، رغم ادعاءاتهم السابقة، عن عقائد الغرب السياسية والفكرية، بل كانوا مخلصين في خدمتها. يكشف هذا بجلاء ، علم الاجتماع في عهد الاستعمار، فقد كان ذا نزعة استعمارية.
فالدراسة المقارنة للإدارات الاستعمارية، والثقة الكبيرة في التحليلات الاجتماعية، والدراسة المنهجية للمجتمع، والدين، والمؤسسات، واقتصاد المنطقة، التي يراد استعمارها، كل ذلك جعل من الممكن إقامة الاستعمار على أساس علمي، يخفف كثيراً من الخسائر التي تلحق بالدول الاستعمارية فيما لو سلكت سبيل الهجوم والطعنات الخاطفة. فبواسطة علم الاجتماع الاستعماري، يمكن تسجيل نقط ضعف المجتمع واستغلالها، وتسجيل نقط القوة وإضعافها، أو تحييدها. ويمكن أن نمثل على ذلك بالجهود التي بذلت في أواخر القرن الماضبي، وأوائل هذا القرن في دراسة المغرب العربي من قبل الاستعمار الفرنسي.
المعيار الثاني
الارتباط الوثيق بالفلسفات والعقائد المختلفة
يشكل ارتباط علم الاجتماع بالعقائد والفلسفات المختلفة، عائقاً كبيراً أمام الاستفادة الكاملة من علم الاجتماع. وقد اتضح بجلاء أن علماء الاجتماع يقدمون أبحاثاً تخدم المعرفة، بل أنهم يخدمون أوضاعهم وعقائدهم (93).
والدليل الأكبر على ذلك انقسام علم الاجتماع إلى قسمين هما علم الاجتماع الماركسي، وعلم الاجتماع الغربي الليبرالي. وطبيعة هذا الانقسام تعود بالدرجة الأولى إلى التصورات العقدية والأطر الفكرية للباحثين حول الإنسان، والمجتمع،والتاريخ، ولقد أكد جولدتر وغيره "أن أغلب النظريات في علم الاجتماع المعلنة ذات طابع فلسفي. بمعنى أنها ليست سوى تبريرات عقلية، لبعض الفروض الخلقية التي يقتنع بها الباحث "(94).
كما أكد "أ.ك أوتاواي " في كتابه "التربية والمجتمع ": أنه من المستحيل الكتابة في علم الاجتماع، دون التعرض للأسئلة المتعلقة بطبيعة الإنسان ومعنى الحضارة، ولا يمكننا أن نتجنب بعض مسئوليتنا في تحديد الاتجاه الذي نعتقد أنه يجب على المجتمع أن يتطور فيه (95).
وعلى هذا، فإن لكل من الفلسفة الماركسية والفلسفة الوضعية، مذهب في علم الاجتماع، يتناسب مع مقولاتها، ويبني على آرائها، ويقوم أولاً وأخيراً على الوقائع المحسوسة، وإنكار الغيب، وما وراء الطبيعة.
علاقة علم الاجتماع بالوضعية واللادينية:
لقد تركت التطورات الفكرية والفلسفية في المجتمع الغربي نقاشاً حاداً بين المفكرين والمصلحين حول طبيعة النظام الذي يجب أن يسود، وانقسم الناس تبعاً لذلك إلى فريقين: فريق يطالب بالتغييرات الجذرية، التي تقضي على القديم، وفريق يطالب بالحفاظ على القديم وعدم الإضرار به(96).
وعلى هذا فقد كان النظام الأمثل، مسرحاً لعراك فكري بين أنصار فلسفة التنوير، وبين الرومانسية المحافظة، وبمعنى آخر كان العراك قائماً بين دعاة التقدم، وبين دعاة النظام، "فدعاة النظام يذهبون إلى أن المشكلة ترجع إلى تحطيم النظام القديم، بينما يذهب دعاة التقدم، وهم الثوريون، إلى أن الأزمة ناتجة عن أن النظام القديم، لم يحطم تحطيماً كاملاً "(97).
وفي هذه الأجواء ظهرت الفلسفة الوضعية، مرتدية ثوب العلم وحده، وكما يقول "جولدتر ": ظهر جيل جديد لم يناصر الأيديولوجية الثورية، ولكنه لم يناهضها، وتأثر هذا الجيل بتطور العلم السريع. وقد اتصف هذا الجيل بصفتين: القدرة على الانفصال عن الأطر الفكرية السائدة من ناحية، والاستعداد للتأثر بنسق فكري جديد من ناحية أخرى.
لقد أحس هذا الجيل بالحاجة إلى أيديولوجية تضفي على العلم صورة رومانسية، وتتفق في نفس الوقت مع النظرة العلمية الجديدة. فكانت الفلسفة الوضعية هي ما قدمه ذلك الجيل. وقد ظهر من خلالها علم الاجتماع وهو الذي تقبلها ونشرها(98).
وانطلاقاً من هذه الفلسفة، صاغ "كونت " مصطلح "علم الاجتماع " وأدرجه ضمن تصنيفه للعلوم، الذي يبتدأ بالرياضيات، وينتهي بعلم الاجتماع، الذي أضفى عليه أهمية فائقة، فقد كتب يقول: "لدينا الآن فيزياء سماوية، وفيزياء أرضية ميكانيكية أو كيميائية، وفيزياء نباتية وفيزياء حيوانية. وما زلنا بحاجة إلى نوع آخر وأخير من الفيزياء وهي الفيزياء الاجتماعية، حتى يكتمل نسقنا المعروف عن الطبيعة، وأعني بالفيزياء الاجتماعية، ذلك العلم الذي يتخذ من الظواهر الاجتماعية موضوعاً لدراسته، باعتبار هذه الظواهر من نفس روح الظواهر الفلكية، والطبيعية، والكيميائية، والفسيولوجية، من حيث كونها موضوعاً للقوانين الطبيعية الثابتة "(99).
لقد آمنت الوضعية بمنهاج العلم التجريبي، ورفضت أي قضية لا تثبت بهذا المنهج، وذلك محاولة منها لغرس العقلية التي لا تفكّر إلا باصطلاحات علمية، وترفض قضايا الدين التقليدي، والغيبيات بكل بساطة على أساس أنها غير علمية.
ومن ناحية أخرى، فقد أثرت الوضعية على الاتجاهات النظرية التي سادت فيما بعد، فعلم الاجتماع الذي دعا إليه كونت، هو الذي أصبح علم الاجتماع السائد في الجامعات في أوروبا الغربية، والذي وصل إلى قمة تطوره التنظيمي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد كان الاتجاه البنائي الوظيفي هو الوليد الأكبر للوضعية. فهو لا يعدو أن يكون صياغات جديدة لأفكار ومسلّمات تنتمي إلى المؤسسين لعلم الاجتماع الوضعيين العضويين. لذلك فهو يعتمد على فكرة النسق العضوي، التي اعتمدت عليها النظريات العضوية.
ومع أن من أهم مظاهر علم الاجتماع الحديث تعدد الاتجاهات النظرية، إلاّ أنها تتغذى على المذاهب الفلسفية، التي من أهمها الوضعية والتطورية، وكذلك البرجماتية.
وقد اختلطت الوضعية والتطورية في دراسات علماء الاجتماع التي تتبع مسيرة الإنسان الفكرية والاجتماعية، حيث ساروا على خطى "كونت " الذي أعلن أن هدف علم الاجتماع عنده هو : "اكتشاف سلسلة التحولات الثابتة المتتابعة للعنصر الإنساني، الذي بدأ من مستوى لا يرقى عن مجتمعات القردة العليا، وتحوّل تدريجياً إلى حيث يجد الأوروبيون المتحضرون أنفسهم اليوم "(100).
وكما يتضح من هذه العبارة، فإن علم الاجتماع يضع المجتمع الغربي في القمة، ويسعى جاهداً إلى أن تحذو المجتمعات الأخرى حذوه. وهذا بالفعل ما أكدته النظريات والقوانين، التي توصّل إليها علماء الاجتماع "قديمهم وحديثهم "، حيث ركزت على مسيرة الإنسانية، خلال عمرها المديد، مؤكدين سيرها نحو الأحسن الذي يتمثل في حياة الإنسان الأوربي المعاصر.
وقد كان لفكرة التطور، التي انتشرت في أوروبا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر، إضافة إلى فلسفة التاريخ، والإيمان المتزايد بقيمة العلم ومنهجه، الأثر الكبير في أن يتتبع علماء الاجتماع مسيرة الحياة الاجتماعية والفكرية، ويقدموها في شكل نظريات وقوانين.. من هذا القبيل، دراسة كونت الشهيرة عن قانون التقدم البشري، والذي عرف بقانون الحالات الثلاث.
لقد صرح "كونت" بأن الدين قد استنفد موضوعه، ولم يعد هناك ما يبرر وجوده، وقد أفسح المجال الآن للعلم الوضعي الذي حلّ محله، بل إنه رأى أن سبب الفوضى وعدم النظام يعودان بدرجة كبيرة إلى أن الفكر الديني والميتافيزيقي، لا يزالان يعيشان جنباً إلى جنب مع الفكر الوضعي، في حين أنه من المفروض أن يفسحا المجال له.
ويلاحظ على هذه النظرية ما يلي:
1- الإيمان بفكرة التطور الخطي حيث يحل الجديد محل القديم.
2- اعتبار الدين مرحلة أولى، يناسب العقلية البدائية، ولا يصلح للعقلية المعاصرة.
3- تعميم هذه النظرية وجعلها قانوناً عاماً، مع أنها تاريخ مشوه لمسيرة الإنسان الغربي الفكرية. فالمرحلة اللاهوتية تخص المسيحية الكاثوليكية، والمرحلة الميتافيزيقية تنطبق على فلسفة التنوير، والمرحلة الوضعية هي المرحلة الصناعية الحديثة.
ومن النظريات الحديثة التي سارت على خطى نظرية "كونت "، ما قدمه "سوركين" على أنه نظرية التواتر المتحول، والتي عرضها في مؤلفه الشهير "الديناميات الاجتماعية والثقافية "، حيث رأى أن كل مجتمع من المجتمعات البشرية، يمر بثلاث مراحل، يحكم كل منها نسق معين من الثقافة، ولكل ثقافة عدة مراحل يمر المجتمع بكل منها في خط مستقيم، ثم يتحول إلى الثقافة التي تليها، وهكذا حتى ينتهي من مراحل الثقافة الثلاث، وحينئذ يتحول المجتمع إلى الثقافة الأولى، وهكذا تدون الدورة.
وبغض النظر عن صدق أو عدم صدق هذه المراحل، فإن الملاحظ في هذه النظريات هو النظرة العدائية للدين، حيث تربطه دائماً بالمجتمعات المتخلفة، كما أن كل مجتمع متقدم، يكون قد تخلّص من الدين وثقافته وروابطه.
ويؤكد هذا أيضاً تالكوت بارسونز في نظريته التطورية، التي حاول خلالها أن يوسع نطاقها، بحيث تشمل التاريخ الإنساني بأكمله. وقد حدد ثلاثة مستويات تطورية تتيح كل منها وجود مجتمعات متنوعة ومختلفة:
المرحلة الأولى: وهي "البداية " ، وتنقسم إلى مرحلتين فرعيتين.
فيتميز المجتمع البدائي أولاً، بأن الدين وروابط القرابة يلعبان فيه دوراً بالغ الأهمية. وثانياً يشير النموذج المتقدم من هذه المرحلة، إلى المجتمعات التي تشهد نسقاً للتدرج الاجتماعي، وتنظيماً سياسياً، يقوم على وجود حدود إقليمية آمنة مستقرة نسبياً.
المرحلة الثانية: وهي "الوسيطة "، وتضم أيضاً نمطين فرعيين من المجتمعات:
(أ) المجتمعات القديمة التي تتميز بوجود "تعليم حرفي "، أي تعليم محدود وخاضع لتنظيم وسيطرة الجماعات الدينية في المجتمع.
(ب) النموذج المتقدم من المجتمعات القديمة، كمجتمع الصين والهند والإمبراطورية الرومانية، والدولة الإسلامية، حيث ينتشر ما سمي بالدين التاريخي.
المرحلة الثالثة والخيرة: "المتقدمة "، وتشير إلى المجتمعات الصناعية الحديثة(101).
وتلعب التطورات الحاسمة التي تطرأ على عناصر النسق القيمي، دوراً بارزاً في الانتقال من مرحلة إلى مرحلة.
إن هذه النظريات وغيرها من النظريات التي يعج بها علم الاجتماع، تهدف إلى إقامة فكرة التطور المطلق، وإنكار فطرة الدين والأسرة والزواج (102). وفي هذا نفي لقداسة الدين والأخلاق والأسرة، والتشكيك في قيمها، كما أنها تحمل دعوة لتحطيم الدين باعتباره عاتقاً عن التطور، ومرحلة مضت وانقضت من تاريخ البشرية.
وهي تحمل من ناحية أخرى، إلغاء مفهوم الإسلام القائم على إطار من الثوابت، في داخله حركة وتغيير.
والحق أن علماء الاجتماع يظهرون عداء للدين وأحكامه، الأمر الذي يظهر جلياً في نظرياتهم وأحكامهم. حيث اعتبروا أنفسهم ممثلين للعلم الذي يعتبر مضاداً للدين. وقد كانت المشكلة التي عالجها رواد علم الاجتماع واعتبرها جوهرية، كما قرر ذلك "ريموند أرون "، هي التناقض بين الاعتقاد الديني وبين العلم. "فدوركايم " مثلاً علماني، باعتباره أستاذاً للفلسفة، وقد وجد أن الدين التقليدي، لم يعد قادراً على مواجهة ما أطلق عليه الروح العلمية، كما أن أزمة المجتمع الحديث، هي في أنه لم يستطيع أن يستبدل الأخلاقيات التقليدية القائمة على الدين، بأخلاقيات قائمة على العلم، وكان يرى أن علم الاجتماع يستطيع أن يعاون في إقامة هذه الأخلاقيات (103).
و "باريتو " الإيطالي، كان مصراً طوال حياته على أنه عالم فقط، ولذلك اعتبر القضايا العلمية، هي ما يمكن التوصل إليها عن طريق المنهج التجريبي فقط. وأما غيرها من القضايا، وخاصة الأخلاقية، والميتافيزيقية، والدينية، فليس لها أي قيمة علمية، ومع أنه يؤمن بتأثير الدين في تصرفات الناس، إلا إنه يقول: "المرء لا يستطيع أن يفسر عن طريق المنهج المنطقي التجريبي الوضع القائم للنظام الاجتماعي، دون أن يدمر أساسه.
فالمجتمع يقوم عن طريق المشاعر، التي لا حقيقة فيها، إلا أنها ذات تأثير عظيم. إن عالم الاجتماع إذا كشف للناس ما يجري خلف أنظارهم، فإنه بذلك يخاطر بتدمير أوهام، لا يمكن الاستغناء عنها ". فهو يعتبر الدين أوهاماً لا يمكن الاستغناء عنها (104).
وهذا "ماكس فيبر" الألماني ينظر إلى التنظيم البيروقراطي والعقلاني على أنه قدر المجتمعات الحديثة. وكان يرى التناقض قائماً بين مجتمع يقوم على العقلانية، وبين الحاجة إلى الإيمان. وقد رأى أن الطبيعة كما يفسرها العلم وكما تعالجها التكنولوجيا، ليس فيها متسع لسحر الدين، وأساطيره القديمة. إن الإيمان يجب أن ينسحب ليعيش في عزلة مع الضمير.
ولقد رأى أن أهم ميزة للحضارة الغربية، هي غياب العقلية الغيبية القديمة، وسيادة الروح العقلية الرشيدة، لجميع جوانب الثقافة الغربية(105).
وهذا "ليفي بريل " (106) الفرنسي يسير على خطى الوضعية، فيرفض القول بمعيارية الأخلاق، لأنه رأى أن العلم لا يكون إلا وصفاً للأحداث الخلقية دون أن يتجاوز الوصف إلى تصوير ما ينبغي أن يكون. وقد أنكر عمومية المثل العليا، مستنداً إلى أن التجربة تشهد بأنها تختلف باختلاف الشعوب وعصورها. وزاد على ذلك حين رأى أن الأخلاق التقليدية تقوم على مصادرتين هما:
1- أن الطبيعة الإنسانية واحدة في كل زمان ومكان، ومن هنا أمكن وضع مبادئ عامة للسلوك الإنساني، في حين أن التجربة تشهد بأن طبائع الناس تختلف باختلاف زمانهم ومكانهم.
2- القول بالفطرة المطلقة، في حين أنه يرى أن الضمير وليد التجربة من ناحية، ونسبي متغير من ناحية أخرى.
ولذلك فقد رأى أن الظواهر الخلقية يجب أن تدرس دراسة موضوعية مستخدمة المنهج التجريبي، الذي تعالج به الظواهر الطبيعية المادية، وذلك لمعرفة قوانين الحقائق الاجتماعية، للسيطرة عليها ما أمكن ذلك(107). وهذا الرأي الذي يعتنقه "بريل" هو نفس الرأي الذي اعتنقه من قبله "دوركايم "، حيث حاول إقامة علم للأخلاق على أساس وضعي، فقد نظر إليها نظرة نفعية، وتصورها روابط تشيع التماسك في المجتمع وفي ذلك يقول: "لقد استقر عزمنا على أن تكون التربية الخلقية التي نلقنها لأبنائنا في المدارس، ذات صيغة دنيوية محضة. ونعني بذلك التربية التي لا تستند إلى المبادئ التي تقوم عليها الديانات المنزلة، وإنما ترتكز فقط على أفكار ومبادئ يبررها العقل وحده، أي أنها في كلمة واحدة: تربية عقلية خالصة "(108).
كل ما سبق ذكره يصب في قالب واحد يسمى: "العلمانية "، فقد تغلغلت العلمانية في علم الاجتماع عن طريق منهجه، وتكوين رواده الغربيين العقدي. يقول المستشرق "أربري " عن العلمانية: "إن المادية العلمية والإنسانية، والمذهب الطبيعي، والموضوعية، كلها أشكال للادينية، واللادينية صفة مميزة لأوروبا وأمريكا ".
وفي المعجم الدولي الثالث الجديد، مادة ""Secularism :
"هي نظام اجتماعي في الأخلاق، مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على اعتبارات الحياة المعاصرة، والتضامن الاجتماعي، دون النظر إلى الدين "(109).
والعلمانية تعني صراحة، كلفظ في اللغات الأوروبية: "اللادينية " أو "الدنيوية "، وهي تعني ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد(110).
لقد درس علماء الاجتماع الدين على أنه واحد من النظم الاجتماعية الكثيرة الموجودة في المجتمع، مهمته توفير الوحدة الجماعية، كما يقول "دوركايم"، وهذه نظرة تتفق مع الفلسفة الرأسمالية الحديثة، بمعنى أن الدين والدولة شيئان منفصلان تربطهما علاقة تعاون(111).
فمثلاً يذهب أودييه في كتابه المعنون "علم اجتماع الدين "، إلى أن الدين، أحد البناءات النظامية الهامة في أي مجتمع، وأن الدين يختلف عن الحكومة التي تهتم بالسلطة والقوة، ويختلف أيضاً عن النظام الاقتصادي الذي يهتم بالعمل والإنتاج والتسويق، ويختلف عن نظام الأسرة المسؤول عن تنظيم العلاقات بين الجنسين، وبين الأجيال.. كما يرى أيضاً أن الاهتمام الرئيس بالدين يبدو وكأنه اهتمام بشيء غامض، ليس من اليسير إدراك حقيقته الواقعية. أي أن الدين - في نظره - يهتم أصلاً باتجاهات الإنسان نحو ما هو فوقي، والتنظيمات العملية لما هو فوق الحياة البشرية. فلقد حدد الدين على أنه المجسد لكل الإلهامات الرفيعة، كذلك فهو حصن الأخلاق، ومصدر النظام العام، وسلام الفرد الداخلي (112).
والحق، فإن اعتبار الإسلام أحد النظم العديدة في المجتمعات الإسلامية، ليس خطأ فحسب ولكنه تحريف لمعنى الدين الإسلامي. فهو بهذا المعنى لا يتعدى كونه ظاهرة اجتماعية، نشأت من المعيشة في جماعة، ويعادل في أهميته الظواهر الاجتماعية الأخرى التي يعرفها المجتمع.
بينما الحقيقة، أن الدين الإسلامي، بناء شامل يضم جميع الأبنية الفرعية كالاقتصاد، والأسرة، والسياسة، وغيرها من الأنظمة. كما يشمل في الوقت ذاته الإطار التصوري العقدي، ويشمل أيضاً العبادات ومختلف الطاعات.
المصدر : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

نور الدين- عضو نشيط
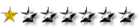
-

تاريخ التسجيل : 14/01/2010
 مواضيع مماثلة
مواضيع مماثلة» المبحث الثاني : اتجاهات الباحثين في علم الاجتماع في العالم الإسلامي
» كتب في علم الاجتماع
» علم الاجتماع
» كيفية الاستفادة من رسائل المسلك
» نشأة علم الاجتماع و تطوره
» كتب في علم الاجتماع
» علم الاجتماع
» كيفية الاستفادة من رسائل المسلك
» نشأة علم الاجتماع و تطوره
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى


